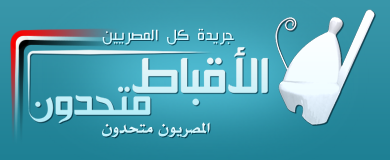نحو قواعد عامة للسلوك الإنساني
بقلم: راندا الحمامصي
لقد بلغنا الآن مرحلة تُؤهِّلُنا في تحديد قواعد سلوكية قائمة على قدراتنا في المعرفة والمحبة والإرادة، وجميعها كما ذكرنا تقع ضمن طاقات النفس البشرية. وعندما تنمو هذه القدرات وتترعرع في حاضنة المبادئ الروحانية والعلمية فإن ثمارها لا شك ستكون الحقيقة والوحدة والخدمة.
الحقيقة
دأب الفلاسفة في محاولات عدة على إيجاد تعريف للحقيقة. ولا أريد هنا أن ننشغل في كشف فلسفي عن الحقيقة، بل غايتي أن أُلقي نظرة واقعية على دور الحقيقة في حياتنا اليومية.
إن السعي المنزّه المستقلّ في البحث عن الحقيقة إنما هو جزء من طبيعتنا البشرية. فدائماً نريد أن نعرف، ونبذل جهدنا وطاقتنا لأن نتعرّف على كل شيء ونفهمه. ولا شك أن أسمى الحقائق وأهمها ما يتعلّق بأنفسنا وذاتنا:
•مَن أنا؟
•ما حقيقة كيان وجودي؟
•هل أنا جسد أم روح أم كلاهما معاً؟
•أي نوع من الأشخاص أنا؟ هل أنا شجاع، صادق، مخلص، أمين، ونزيه؟
•ما هدف حياتي؟
كل هذه الأسئلة وما يدور في فَلَكها جديرة بأن تؤخذ على محمَل الجِدّ. فنحن معشر البشر في حاجة أن نعرف الكثير عن هذه الحقائق، ومع ذلك فإن إدراكنا لها يظل محدوداً ونسبياً. لن نحيط بأسرارها كاملة لأن البحث عن الحقيقة مجهود لا ينتهي ويستنفذ منا ساعات العمر كله. فالناس في كل الأحوال والظروف، بوعْيٍ منهم أم بلا وعي وبدرجات متفاوتة، دائبون على البحث عن إجابات لتساؤلات تتعلق بطبيعة وجودهم وعِلّة خَلْقهم.
إن أعظم مَنْقَبة نحتاجها في تقاربٍ مثمر وناجح نحو تلك الأسئلة هي صدقنا مع أنفسنا. قد نكذب على الآخرين ولكن ليس على أنفسنا. يمكن أن نخدع أنفسنا بتصديق أمر موهوم أو زائف، ونعلم حقّ اليقين بأن جميع محاولاتنا بشكل أو بآخر ما هي إلا إخفاء للحقيقة. فالموقف الصادق مثَلُه مِثْلُ الضوء نستطيع بأشعته أن نكشف حقيقة أنفسنا. ولهذا السبب نَرْهَب الصدق ونُجانبه، وفي الوقت نفسه نريد الحقيقة لأننا في أمسّ الحاجة إليها.
إن الصدق مع النفس يفتح الطريق ويمهّدها لعلاقات صادقة مع الآخرين، ذلك لأن جذور المصاعب في إقامة مثل تلك العلاقات تكمن في جهلنا بالآخرين، وهناك يكون الفهم الخاطئ عنهم، ذلك الجهل الذي يولّد جميع التعصبات على كل الصُّعُد الإجتماعية. فعلى المستوى الفردي يؤدي إلى تعقيد العلاقات الإنسانية والتسبب في جرح المشاعر وعدم قبول الآخر وارتفاع موجات الغضب العارم. ولهذا السبب فإنه لزام علينا، ليس فهم أنفسنا فقط، بل وفهم كل منا الطرفَ الآخر. يلزمنا أن نلمس الصدق في كل منا، وأن نتواصل بكل مصداقية وأمانة. علينا أن نفي بوعودنا حتى لا نفقد الثقة فنطبع أنفسنا بانطباع خاطئ.
وكما يمكن ملاحظته، فإن موضوع الحقيقة أبعد ما يكون عن كونه موضوعاً فلسفياً بحتاً. ففي كل يوم من حياتهما على الزوجيْن أن يكونا صادقيْن مع بعضهما البعض إذا أُريد لعلاقتهما الزوجية أن تتقوّى وتستمر. فالأولاد بحاجة إلى الثقة بوالديهم بمثل ما يحتاجه الوالدان أن يكونا صادقيْن مع أطفالهما. فالرؤساء والمرؤوسون والمدرّسون والطلاب وعامّة الشعب والحكومة وكل دولة مع الأخرى يلزمهم جميعاً الصدق في التعامل إذا ما أرادوا إنشاء علاقة قائمة على الثقة والشعور بالإطمئنان. فالصدق عنصر هامّ لا غِنى عنه في جميع العلاقات الفردية والدولية، وبدونه ستُعاني العلاقات الإنسانية كبيرَ الأزمات والمصاعب. تلك هي حال عالمنا اليوم؛ فأزمة الثقة قائمة بين الأزواج والزوجات، وبين الوالديْن وأطفالهما، وبين الحكومات وشعوبها، وبين الأمم على اختلافها. لقد غار الصدق بالكلية، وهبّت على السطح تيارات الأزمات المتلاحقة، وأصبح الكل صرعى أمواج المعاناة. إننا في حاجة إلى الصدق ليس مبدأً أخلاقياً فحسب، بل هو ملح الحياة فإذا فسد فَسُد كل شيء في المجتمع الإنساني.
الوحدة
ما هو قريب الصلة بالحقيقة هو الوحدة، فهي تشير إلى الواحدية والأُحادية وهي سِمة الحقيقة. فالحقيقة واحدة والواحدية هي الحقيقة.
والوَحدة أيضاً قريبة الصلة بالمحبة. من المحال أن نتمتّع بالوحدة دون المحبة، أو أن نحب دون أن ندرك وَحدة جذورنا. ففي علاقاتنا الشخصية تدخل مسألة الوحدة في صلب نسيج المحبة. فالمحبّون يتوقون البقاء معاً وأن يظلوا متحدين، ويشعرون بالحزن عندما يفترقون، وكثيراً ما يعانون من اجتماعهم معاً أيضاً. كل هذا يحدث لأننا لم نتعلّم كيف نتّحد، ذلك لأن الحب وحده لا يضمن لنا علاقة جيدة سارة. وعليه، غالباً ما تكون العلاقات في واقع الأمر مؤلمة وغير مُسِرّة. ومع ذلك إذا ما اتّحد الحبيبان ستغدو علاقتهما أكثر سروراً وأقلّ ألماً. وحتى نحقّق هذه الوحدة علينا أن ندرك، حتى لو كنا مفترقين كمخلوقات إنسانية، فإننا متّحدون. إننا نعيش في مجتمع فردي (يركز على الفرد) إلى حدّ كبير، وعليه نرى أن التباعد والتفرُّد بين الناس أمر مرغوب فيه وممدوحٌ بل ويُشجَّع عليه. فالمنافسة بنظرهم تعدّ ضرورية وأساسية للفرد في تطوّره وبلوغ أهدافه، وأية محاولات تهدف إلى تأسيس وحدة واتحاد يُنظَر إليها نظرة شكٍ وريبة.
إن مفهوم الوحدة في عصرنا الحاضر نراه مفهوماً غريباً. فبعض الناس يرون في الوحدة على أنها التماثل، ولذلك لا يستسيغون طعمها، والبعض الآخر يراها عملية تقود في النهاية إلى هيمنة فرد أو مجموعة واستئثارهم بالآخرين. إنها أنماط من الوحدة لا شك أنها كريهة غير مقبولة جملةً وتفصيلاً. فعندما أتكلم عن الوحدة أعني مفهوماً له وجهه المختلف تماماً.
فالوحدة التي أعنيها تخبرنا أن المخلوقات البشرية في جوهر وجودهم هم في الحقيقة واحد، وهم مع بعضهم البعض يشكّلون إنسانية متكاملة. وبمعنى أكثر تحديداً، فإن عناصر مكوِّنات البشر واحدة، وكلّهم يمتلكون القدرات الثلاث: المعرفة والمحبة والإرادة. كل الناس يمرّون بمراحل الحياة ذاتها من حمل وولادة ونموّ ثم وفاة، وكلنا واحد فيما يتعلق بالمسائل الهامة الخاصة بالحياة والموت. إلا أننا أيضاً متفرِّدون كأفراد؛ لكل منا شكله المختلف وأفكاره ومشاعره وأفعاله المتباينة، ويعيش حياة متفرّدة.
إن التحدّيات الماثلة أمام الوحدة والتوحّد تكمن في أسلوب محافظتنا على ثراء تنوّع أفراد العائلة الإنسانية وصيانته. ولا يمكن للعين أن تخطئ تلك الوحدة الأساسية التي تجمع بين الناس، وما هم عليه من اعتماد على بعضهم البعض وتفاعلهم مع عالم الطبيعة. فكل شيء في هذا الكون متعلق بالآخر، فيؤثر ويتأثر، وأي تغيير في أحدها يؤثر على الكل. وعليه، فإن الوحدة تدعونا أن نرى "الأرض وطناً واحداً والناس سكانه". وتدفعنا إلى الإهتمام بمصالح الناس بغض النظر عن القومية والجنس والعقيدة والطبقة أو الخصائص الفريدة. فالوحدة تتطلب منا خلق وعْي عالمي، وتدعونا إلى أعمال عالمية في نطاقها شاملة في مداها وعادلة في تطبيقها. نعود إلى الوحدة ثانية لنراها إذن وندرك بأنها أسمى من اعتبارها وجهاً من أشكال توجُّهاتنا يمكن الإستغناء عنه بإرادتنا، إذ من الواضح أن حياة البشرية وحضارتها لن يُكتَب لها الديمومة ما لم تتحقق الوحدة. لقد ولّى عهد الإنفصال والتباعد، وغدت الوحدة والإتحاد لزوماً لا مفرّ منه لعالم متحضّر.
الخدمة
الخدمة هي العنصر الثالث في القواعد العامة للسلوك الإنساني، وتأتي نتيجة تطوّر البشرية ونضوجها. وحيث إننا على أعتاب عصر النضج الجماعي، فإننا ندرك أن معايير السلوك التي كانت مقبولة في عهد طفولة البشرية ومراهقتها لم تعد صالحة لها الآن.
ففي المجتمع الناضج، على روح المنافسة أن تذهب إلى غير رجعة لتحلّ محلها روح الإكتساب والتعاون، ثم الإهتمام بالآخرين ومحبتهم بدل الدوران حول محور الذات، والعلاقات القائمة على النفوذ والقوة يجب نبذها بالكلية لصالح التعاضد والمساواة. يجب التخلّص من جميع مظاهر السلوك السلطوي والدكتاتوري الحاكم ليحل محله نظام ديمقراطي يشارك فيه المواطنون بكل حرية مشاركة فاعلة. فتغييرات كهذه وغيرها، التي يحتاجها النموّ الجماعي للإنسانية، لا يمكن لها أن تتحقق إلا بحدوث التغيير المنشود لدى الفرد والمجتمع على السواء.
فالمطلوب على المستوى الفردي تقديم الخدمات، ليس لأننا ننشد الظهور بمظهر "الأناس الطيبين"، بل لأنه يتعذّر على الفرد التقدم والتطور في حياته دون قيامه بالخدمة. إننا كمخلوقات بشرية نُعتبر جزءاً من حياة هذا الكون المتوازنة، ونشكِّل وَعْيَه الذي يلفّ المعمورة، ونحن أيضاً ضمير هذا الكون. وكما نعلم، فإننا المخلوقات الوحيدة في العالم المحيط بنا الذين نملك القدرة على اتخاذ القرار والتمييز بين الخير والشر، كما نستطيع أن ندمّر ونعمّر، أن نكون مانعين أو معطائين أو أنانيين أو نختار الخدمة طريقاً لنا. إننا نملك مصير عالمنا بأيدينا مجتمعين. يمكن لنا أن نتنافس فندمر بعضنا بعضاً، أو نتعاون فنخدم بعضنا بعضاً. فالخدمة عنصر لا بدّ منه في الحياة الإنسانية لأنها الطبيعة البشرية في أنضج حالاتها وأسمى صُوَرها.
إن عالمنا المعاصر في مرحلة مراهقته يضع مع الأسف مفهوم الخدمة في دائرة الشك. وحتى نقف على حقيقة مفهومها علينا أن نفصلها تماماً عن العمل الخيري، ذلك لأن الخدمة عمل أساسه تبادل العطاء والمساعدة بين شخص وآخر على قدم المساواة، بينما الأعمال الخيرية هي العطاء من واهب إلى محتاج. ففي نمط من الحياة يأخذ طريقه نحو التكامل تحلّ فيه الخدمة محل الأعمال الخيرية، وفيه تتطور علاقة تبادلية كلُّ فردٍ فيها يعطي ويأخذ مثلما يكون التعليم والتعلُّم في آن معاً. ففي قيامنا بالخدمة نجد أنفسنا نتغلب على أنانيتنا ونرفع أركان العدالة مع الآخرين ونتّحد اتحاداً يندمج فيه تفرّدنا.
في الجزء التالي سأعرض باختصار لتركيبة المخ البشري وعمله ودوره في نموّ الوعي الإنساني وتطوّره. إن دراسة أمور كهذه مهمة وضرورية. فإذا ما اعتقدنا بأن وعْيَنا هو نتاج عمل المخ، وأن هذا المخ مبرمَجٌ لإتّباع توجيهات غرائزنا، عندها ستبوء بالفشل كل محاولاتنا في خلق نمط روحاني لحياتنا. فإذا ظللنا قابعين في مستنقع البُعد عن الحقيقة وفي أجواء التفردية والإنهماك في مصالحنا الشخصية، فإن جميع جهودنا في أن نعيش حياة الحقيقة والوحدة والخدمة لا شك ستؤول إلى الفشل. وحينئذٍ سنقنع بحياتنا كما هي، ويستمر كفاحُنا قائماً من أجل البقاء، وسنبقى ضحايا عُصابيّين لحضارة مادية جائرة. أما إذا عدنا إلى طبيعتنا الروحانية فإن مساعينا ستنجح في تطبيق المبادئ الروحانية في حياتنا العملية، وعندها يغدو بمقدورنا تأسيس حضارة عالمية يسودها السلام والوحدة والعدالة، وستنجح محاولاتنا في تخفيف حِدّة الصراعات والإضطرابات والمآسي التي تغرس مخالبها عميقاً في حياتنا، وأقل هذه المحاولات في النهاية دخولنا عصر نضجنا- عصر الحضارة الروحانية.
لا يمكن للمراقب الجادّ الذي يرى المشهد الإنساني أن يُنكر حاجة البشرية الماسّة إلى تطبيق مبادئ الحقيقة (الصدق) والوحدة والسعي الجادّ في خدمة عالم اليوم. فعالمنا تمزّقه أنياب الإرتباك وتعصف به تيارات الأفكار المتضاربة والتوجُّهات المتباينة والأفعال الفتّاكة التي ستقوده في النهاية إلى هاوية الدمار والهلاك ما لم يُتِح المجال أمام عامة الناس أن يبحثوا عن الحقيقة بأنفسهم بكل حرية وانفتاح ويتحرّوها من أجل أنفسهم متحدين يداً واحدة في مسيرتهم نحو تحقيق الأهداف العامة وخلق عالم تسوده العدالة والإنصاف والتعاون المتبادَل والخدمة المكرّسة.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :