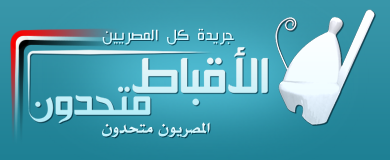- حزب الأخوان يحرم الأقباط الترشح للرئاسة.. وعبد الفتاح: الإخوان لم يستوعبوا ما حققته الثورة!
- مايكل منير: المصريون بالخارج في غاية السخط من لجنة التعديلات الدستورية
- كامل يشكو استبعاد التكتلات القبطية من ائتلاف شباب الثورة
- انفلات أمني بـ"سوهاج"وتغيير رؤساء المحليات
- د. "أحمد جويلي": أخذت قرار الترشُّح للرئاسة والتيارات الليبرالية ستساندني
البعد الروحاني للوحدة
بقلم: راندا الحمامصي
تحدثنا حتى الآن عن نظرية الوحدة ومفهومها من منظور بيولوجي وسيكولوجي، وأمامنا الآن دراسة مفهوم الوحدة من منظور روحاني.
البعد الروحاني للوحدة
لا شك أن محور هذا الموضوع يدور حول كون الإنسان مخلوقاً روحانياً في طبيعته، مما يعني أن هناك قوى تعلو فوق الغرائز والإنفعالات والأفكار، ذلك لأن في الإنسان طاقة كامنة أفضل وصف لها هي استعداده للعروج إلى أعلى المستويات وقدرته على التحوّل والغيير. فتفرُّد حياة الإنسان وتميّزها ليس في قدرته على البقاء ولا في الإحساس وإبداء المشاعر ولا حتى في القابلية على اكتساب المعرفة، وحتى لو كان الجنس البشري يفوق سائر الكائنات في كل هذه الأمور، فإن هذه المواهب والقدرات لوحدها لا تعبِّر عن إنسانيتنا تعبيراً تاماً. إن ما يجعل منّا كائنات إنسانية قدرتنا، إن أردنا، على اختراق حدود كفاحنا من أجل البقاء إلى آفاق من الوعي وإدراك العالم من حولنا. بكلمات أخرى بإمكاننا أن نأتي بمرحلة جديدة منيرة في مسيرة تطور الحياة وتأسيس الحضارة الإنسانية. وحتى نسير في هذا الرّكب يلزمنا وعي جديد – سماوي في مصدره، عالمي في تطبيقه، عصري حديث في تعاليمه ومفاهيمه، يستجيب لحاجات العالم الحالي ومتطلباته وعلمي في تقارباته.
من بين الأبعاد الرئيسة في هذا الوعي الجديد نرى ثلاثةً تُعتَبر المبادئَ الأخلاقية العامة للسلوك هي: الحقيقة (الصدق)، الوحدة، والخدمة. فعملية الترقي والتحوّل تلك تستدعي تبنّي هذه المجموعة من المبادئ إطاراً للعمل نُصيغ فيه نمط حياتنا ونعيد تشكيل علاقاتنا الزوجية والعائلية وتشكيل بُنْية مجتمعنا ونعمل على تأسيس نظام عالمي جديد يحل محل نظام قائم يتهاوى أثبت إفلاسه روحياً وفكرياً وخلقياً واجتماعياً.
وجانب آخر من ذلك التحوّل والترقي إدراكنا بأن إعادة تشكيل الأنظمة، سياسيةً كانت أم اقتصادية أم اجتماعية في طبيعتها، بغض النظر عن مدى صبغتها العلمية، سوف تفشل ما لم نُعِدْ وصل نفوسنا بالله سبحانه وتعالى؛ ليس بالإله الغاضب شديد البطش والعقاب الذي لا هدف له ولا همّ، وهو السلطة التي لا تتجاوب، والذي همّه أن يُدخل "المختارين" و"الصالحين" من المؤمنين إلى "الجنة" ثم يسدّ بابها دون الآخرين من عباده، ولا هو بالإله الذي لا حول له ولا قوة، الضعيف، غير الرؤوف وغير القادر، ولا يريد إصلاح أمور العالم المزرية.
بل إننا نتحدث هنا عن الخالق العليم الرحمن الرحيم الفيّاض الكريم، الله الذي خلقنا على صورته ومثاله فمنحنا المقدرة على المعرفة والعرفان والقدرة على المحبة وهدانا إلى الصراط القويم في وضع محبتنا في خدمة الإنسانية جمعاء، وهو الذي يؤيّدنا ويأخذ بيدنا نحو تأسيس مدنية دائمة التقدم مزدانة بالروعة والجمال، تحتضن أفراد الجنس البشري قاطبة داخل الحصن الحصين للوحدة والعدالة والمساواة.
فالبشرية في القرن التاسع عشر والعشرين، وهي تودّع مرحلة مراهقتها الجماعية، نراها قد قطعت علاقتها بالله عن وعي منها وبكل فخر بكل أسف، إنه اضطراب فكري ونفسي يقود إلى هاوية منذرة بسوء العواقب وأوخمها. فعندما نبتعد عن الله ونتجاهل تعاليمه فإننا بذلك نسارع إلى خلق آلهة جديدة لنا لملء ما أصبحنا فيه من فراغ روحاني. ولذلك فإن الإنسانية عندما رفضت حقيقة طبيعتها الروحانية وقطعت أوصال علاقاتها بالله ونبذت ما عنده لتأخذ بناصية نفسها، رأينا أن أربعة تطورات بارزة على الأقل قد طفت على السطح لتتظافر بالتساوي في تدمير النفس البشرية. وتلك هي:
1.ظهور الشيوعية الماركسية فكراً شائعاً في العالم وشكلاً من أشكال الحكم.
2.قيام المادية وجعلها إطاراً للبحث العلمي ومقياساً لإنجازات الإنسان.
3.تمجيد الوطنية والعنصرية على أنها الإنجاز الأنبل والأسمى في تحقيق التضامن والتكافل الإنساني.
4.وأخيراً ظاهرة التطرّف الديني على أنه السبيل الأوحد والأمثل للخلاص، والذي سيعيد وصل الفرد بخالقه ولا يقبل التحوير والتبديل.
إن ما أحدثته الشيوعية من دمار وخراب ماثل أمامنا لهو حقيقة تاريخية. ففي الإتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا ووسطها نرى ضحايا هذا النظام من أرتال الناس المخدوعين المجروحين المرعوبين الغاضبين؛ فقدوا ثقتهم بأنفسهم وبغيرهم أو بحكوماتهم. فالتكافل المصطنع الذي فُرض على مجموعات إثنية ودينية متنوعة في تلك البقعة الممتدة من العالم قد هوى وتلاشى في لحظة، والخلافات القديمة والتعصبات والأحقاد المدفونة تحت سياط القمع والقهر بقصد الإخضاع والإذعان قد طفت على السطح من جديد، كما أن آثار الدمار الذي نشاهده والأنظمة الإقتصادية المنهارة والحكومات الجائرة في جزء آخر من العالم لهي أمثلة أخرى على ما أحدثته من دمار تلك الأنظمة الإجتماعية المادية وما نتج عن تطبيقها. ومع ذلك، بالرغم من الدمار الهائل الذي أصاب تلك الأقطار فإنه من المثير حقاً، في هذه التجارب البشرية، أن تخرج الروح الإنسانية منتصرة في النهاية في وجه كل الجهود الرامية إلى إنكار وجودها وطمس مواهبها في التطور. ففي كل مكان؛ في البادية والحضر، في المجتمعات المتقدمة علمياً أو تلك العاملة بالزراعة، بين أعلى المثقفين أو الكتل البشرية المحرومة من العلم والثقافة، يمكن للمرء أن يشاهد الطاقة والقدرة الإنسانية على بعث الحياة والمغزى لمن لا حياة لهم ولا معنى عندهم لوجودهم. وعليه، ليس من المستغرب بمجرد أن وجد القادة المتنفّذون لتلك الإنظمة أنفسهم أمام تحدي ظهور مستوى جديد من الوعي عند أولئك الذين يرزحزن تحت نير حكمهم، انهار النظام بالكلية. بيد أنه لم تمضِ إلا فترة قصيرة من الإنتعاش الموهوم حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها من المعاناة، وكأن تلك الشعوب قد وُضعت في حالة تجمد، وحالما بدأ الطقس في التحوّل سرعان ما برزت كل القضايا السابقة وأخذ الناس يطالبون بحلول جديدة.
تكمن المأساة في كل ذلك أنه خلال هذه الحقبة المؤلمة من التاريخ فإن ملايين البشر قد ضُحِّيَ بهم على مذبح تلك المفاهيم الإجتماعية المختلفة (الإيديولوجيات)، وضاعت أعمار عدد لا يحصى من الناس تحت نير القمع والإضطهاد والإستبداد. إلى جانب هذا وذاك، ورغم تلك الحقائق عن النظام الشيوعي الذي مورس في الإتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا وغيرها، سنغدو مُغْبِطين حق الإنسانية إذا لم نُشِرْ إلى أكثر المذاهب الفكرية تدميراً وإلى ممارساتها اللاإنسانية المتصلة بالدكتاتورية الفاشية والنازية التي اتخذت مكانها الفريد غير اللائق في صفحات تاريخ البشرية لتقدم لنا صوراً غاية في البشاعة عن بربرية الإنسان وما أحدثه من دمار وهلاك.
أما الرأسمالية المادية فقد غرزت مخالبها السامة في جسد البشرية فشاركت في هذا الخراب بآثارها السّاحقة. فالمادية بكل ما تعنيه ما هي إلا وصفة ضد الحياة. فهي التي تضع البُعد المادي للوجود موضِع الصدارة، مما دفع العالم إلى البحث عن الحلول لجميع مشاكله ضمن الإطار المادي مركِّزاً على الخواص المادية للحياة، وأن قيمة الفرد بنظر المجتمع تُحَدّد بما يحققه من منجزات مادية، وبالتالي فإن مدى تقدم المجتمع وتطوره يُقاس بما تعلو سماء مدنه من أبنية شاهقة وما فيها من سيارات فارهة وثلاجات حديثة وما تملكه العائلات من أجهزة التلفزيون ثم مقدار الناتج القومي لتلك الأمة. أما نوعية الحياة التي نعيشها فتحظى منا بالقليل من الإهتمام، وبالكاد نفكر بالمآسي والأخطار التي تتهدد مجتمعنا؛ بالعدد المتنامي من المشردين، وناقوس الخطر من ارتفاع وتيرة العنف والإجرام، وانتشار ظاهرة الإدمان، وشيوع الأمراض التناسلية المعدية التي لا نراها فقط في الأزقة المُعدَمة والأحياء الفقيرة والثكنات البالية في مُدُننا وقُرانا، بل وفي بيوت الأثرياء وأحياء الطبقة الراقية والوسطى على السواء.
فالمادية تعطي اهتماماً لما يمتلكه الناس وما ينتجونه أكبر من اهتمامها بنوعية الحياة. فمقياس تقدم المجتمع المادي ليس في تلك المعايير التي تُحدِّد مدى نجاح الأزواج والزوجات في تطوير المساواة بينهما، ومدى نجاح الوالديْن في تنشئة أطفالهما على المحبة والوحدة والأمانة والصدق ومختلف الفضائل الإنسانية، أو مدى نجاحنا في الحدّ ثم القضاء تماماً في النهاية على الأعمال البربرية المتمثلة في جرائم الإغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال من أسرنا.
كما أن هناك وجوه أخرى تنزِع إلى تجاهلها المجتمعات المادية من ضمنها تفشّي التمييز العنصري، وإشاعة الظلم، والغنى الفاحش، والفقر المدقع، والإنفاق على التسلّح، وتجارة بيع السلاح للأفراد والجماعات والدول المختلفة. والقائمة في ذلك تطول وتطول.
إنها تبِعات أفرزتها المجتمعات المادية، فلا غرابة إذن أن تلك المجتمعات، رغم ما هي عليه من علم ومعرفة وثراء واعتنقت مذهب الرأسمالية المادية، تجد نفسها ضحية ذلك الداء العضال الذي أخذ يفتك بكل أنحاء جسمها. فنجد أن أمريكا الشمالية وغرب القارة الأوروبية واليابان والدول الأخرى، التي تتبنّى التوجهات والمفاهيم نفسها، إما أنها تمرّ بتلك الحالات المزرية إلى حدّ كبير أو أن بعضها في طريقه إلى ذلك المستنقع البغيض.
فالمادية في تعريفها الشامل أمر مناف للروحانية (ضد الطبيعة الإنسانية) ولا يمكن أن يتعايشا معاً. ومع ذلك فإن الدين في المجتمع المادي قد يزدهر إذا ما حُوِّرت مقاصده واستُعمل سلعة من السلع، وهذا ما حدث بالضبط في كثير من هذه المجتمعات. فإذا جعلنا من الدين سلعة فلن يصبح إلاّ كأساً طافحةًً بالتعصب ومرتعاً للفرقة والنزاع وفضاءً للخرافات والترّهات خالياً من أي روح مُحْيِية.
وظاهرة ثالثة ظهرت ونمت وتطورت نتيجة البُعد عن الحق وأقواله، وما ترتّب عليها من اضطراب ونزاع داخل النفس البشرية. تلك هي تصاعد غليان العنصرية والوطنية إلى درجة التطرف. فالنفس البشرية بطبيعتها بحاجة إلى من تعبده وتتوجه إليه، فإذا لم يكن الله وحده سيكون هناك "آلهة أخرى": إله الوطنية وإله العنصرية وإله المجون... إلخ. فتلك الآلهة تعتبر مواليد خيال الإنسان، وقائمة على حب الذات وتمجيد الذات وإرضاء الأهواء النفسية التي خلقت تلك الآلهة. فبالتوجه إليها تتغذّى في محرابها كل مخاوفهم اللاعقلانية وعقائدهم غير المنطقية وتعصباتهم العمياء. فحالما تبدأ الإنسانية تعي وحدتها الجوهرية وتلمس مدى ثراء تنوعها كمصدر حيوي لها ولحياتها وتقدُّمها، ستكون عندها قادرة على أن تتخلى عن آلهة العنصرية والوطنية الجامحة، وفي النهاية سيدرك كل فرد فيها أن "الأرض ما هي إلا وطن واحد والناس سكانه".
وكما مرّ ذكره فإننا الآن في المرحلة الأخيرة من فترة مراهقتنا الجماعية، لذلك لا غرابة في أن نشاهد تصاعداً كبيراً في تمجيد الوطنية لدرجة التطرف المدمِّر والتعصب العرقي المهلك لأن هذه كلها إنما هي تشنجات الرمق الأخير لمجهودات فئات المجتمع الإنساني المختلفة في سعيها نحو تأكيد هويتها. إن ذلك، من منظور السيكولوجية، يُعدّ وجهاً ضرورياً لتطوير المجتمعات الإنسانية (كما هو الحال مع الأفراد أيضاً). فكل مجموعة وطنية وإثنية وكل أجناس العالم يلزمها بعد ذلك أن تشعر أنها متساوية في المحافل الدولية، وأن كلا منها عضو له قيمته في العائلة الإنسانية، وأن الخواص الفريدة التي تتمتع بها كل مجموعة ضرورية لتأسيس حضارة إنسانية دائمة التطور تتوازن فيها الأمور الروحانية والمادية.
وحالما تتحرر مختلف الشعوب والأجناس من قبضة المجموعات الأخرى في نفوذها وحكمها، وتأخذ مكانتها في عالم الإنسانية، عندها نكون جميعاً جاهزين لتأسيس مستوى أعلى من الوحدة فيما بيننا، وحدة عالمية تحافظ وتقدّر ذلك الثراء في التنوع والتعدد في مكوّناته وتشجعه وتعمل على تعزيزه. وعندها يرتقي هيكل الإنسانية في النهاية إلى مستواه في تجميع أعضائه لتعمل معاً بغاية التناسق والإنسجام ضمن مقاييس نظام عالمي جديد يحصل فيه الفرد وكل مجموعة وكل أمة على كامل حقوقها وفي تحمُّل مسؤولياتها بالعدل والمساواة.
أما الظاهرة الرابعة والأخيرة التي كانت مدمِّرة فتلك التي ذُكرت وتتلخص بظهور الأصولية الدينية. فبالإضافة إلى الجوانب الضارة المؤذية لتطورها الذي ناقشناه سابقاً يجدر بنا لفْتُ الإنتباه إلى الحاجات التالية التي يجب أن تؤخذ بعين الإغتبار: إن الأصولية الدينية التي تُمارس اليوم في بلاد الغرب تركِّز على ضعف الشعوب وتخوّفاتهم، وعلى شعورهم باليأس والقنوط فتعدهم بالشفاء دون ألم، وبالخلاص دون جهد، وبالتنوير دون معرفة، وبالنصر دون تضحية. لا شك أنه تعبير ساذج عن الدين والتديُّن يتلقّونه في مجتمع مادي بحت. فهو الذي يجعل من الدين سلعة للتسويق، ومن العبادة شكلاً من أشكال الإتّجار والمبادلة.
وللأصولية الدينية شكل آخر من التعبير عنها يُشاهَد بوضوحٍ أكثر في تلك البقاع من العالم حيث لا تزال الحروب الدينية مشتعلة بضراوة يغذّيها ذلك الإعتقاد بأنهم "المختارون" و"الآخِرون" و"الوحيدون" و"الصفوة". وعقائد كهذه إنما تقسّم الناس وتفرّقهم وتبرر كل أشكال العنف ودرجاته وتبيح الهدم والتخريب باسم الله. فهدف زعماء هذه الجماعات الأصولية في الشرق والغرب يرمي إلى إبقاء الناس في جهل وفزع.
إن تقاربات نحو الدين بهذا الأسلوب لهو مساس صارخ بحقيقته. فهي لم تتسبب في اضطراب نفسي عميق لدى جميع الناس الذين ساروا في ركابه ونبذوا الدين الحقيقي فحسب، بل وبشعورهم العميق بخسارتهم الفادحة وحرمانهم الروحاني. إن نفورهم من الدين راجع إلى التزمت الديني الذي عاشوه وتقاربهم غير المنطقي وغير السليم نحو مسائل روحانية وأخلاقية ودينية.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :