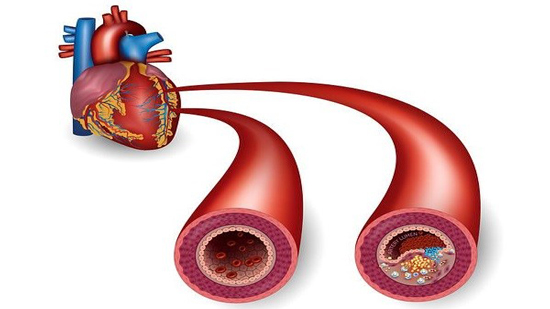الفَلْسَفَةُ الحَقَّةُ
القمص. أثناسيوس فهمي جورج
الأحد ٢ يوليو ٢٠١٧
Yesterday with some professors of philosophy in many renowned universities from both Ireland and the UK___27 /6 /2015
( لقاء حول الفلسفة المسيحية وورش نقاش ، جمعت اكادميين في الفلسفة واللاهوت)
القمص أثناسيوس فهمي جورج
الفلسفة الإلهية الحقة لها صفة الديمومة؛ و تتسم بالمعاصرة الدائمة كخلاصة روحية تُعاش إلى المجيء الثاني. تداوﻱ الحياة الجذرية للإنسان؛ وتتجه به ناحية مصيره الأبدﻱ (الاسخاتولوچي) Εσχατολογία وفقًا للوصايا الإنجيلية ومغزى تدبير الخلاص (السوتيرلوچي) Σωτηρολογία ومقاصد الله؛ فتكون هي الينابيع التي ترسم الوظيفة المنهجية للفلسفة الحقة؛ كأساس لمعرفة الإنسان (الأنثروبولوچي))Ανθρωπολογι ووعيه ونشاطه وأهدافه وتطوراتها ودوره في بنيان الملكوت، حسب تفسير الخلاص والبشارة والإرسالية لتغيير العالم بالكرازة (الكيريجما) Κηρυγμα للخليقة كلها.
لذلك الفلسفة الحقة هي فلسفة اليوم والغد وبعد الغد؛ حاضرة عبر الأزمنة ؛ لأن المسيح مخلصنا هو محورها ووثيقتها وبؤرة قيامها؛ أمس واليوم وإلى الأبد. ملكوته لا يتزعزع ولا ينقرض؛ وسِنُوهُ لن تبلىَ؛ الكائن والدائم إلى الأبد.. لكن حقيقة الديمومة هذه ليست مضادة للتجديد والتطوير؛ الذﻱ يُعتبر إعادة اكتشاف وقراءة تأسيس للمعنى والتأمل؛ لعلنا بها ندرك ما أدركنا المسيح لأجله.
كذلك تتميز الفلسفة الحقة عن الفلسفات الزمنية المعتبرة بانها ضد الزمان (لا وقتية) وضد الراهن (اللا راهنة) إذ يُنظر إليها بأنها غير ملائمة ولا مناسبة أو موافقة للزمن. فما خمَّنه الفلاسفة؛ فهمه تلاميذ المسيح وأعلنوه؛ وتأهلوا بالنعمة لمهارة صيد النفوس من قبل الحكمة الأزلية المضيئة بنور معرفة الحق (وملأهم من كل فهم وكل معرفة روحية كوعده الصادق)؛ واقتنوا الإيمان المتعَقْلِن. مؤكدين على أن المعرفة لا تضاد الإيمان؛ وعلى أن الإيمان ليس ضد العقل والعلم؛ لأن المسيح هو نهاية وتحقيق كل فلسفة ونبوة؛ حتى صار الرجاء المسيحي إكليلاً وتكميلاً لتاريخ الفلسفة. بعد أن وُضعت العقائد المسيحية تحت مجهر الفحص من جبابرة العقول والأذهان ؛ طلبًا للشبع العقلي والجدال؛ قبل أن تكون بقصد طلب إشباع الإيمان.(أثيناغوراس + أوريجين + اكلمنضس + يوستين + ترتليان + اغسطين + توما الأكويني).
لكننا لا نستطيع أن ندخل إلى الفلسفة الحقة ما لم نستنِر بعمل الروح القدس؛ الذﻱ يعطينا قوة ويحرك أفكارنا لكنوز المخابئ ؛ ويتقدم أقوالنا ويبارك أفهامنا ويرتقي بعقولنا؛ لأن الحقيقة الإلهية تتطابق مع الواقع الإلهي المعطىَ للإنسان بطريقة كشفية استعلانية ، وبالتحولات الحياتية كرجاء تكميلي للإعلان الإلهي الذﻱ لم ينتهِ استعلانه بعد... لكنه لا زال يُكتشف لبلوغ جميع الحق –(وملء الحقيقة الإلهية)- الذﻱ يظل ولا يزال غير مستنفد؛ بالدخول إلى الفهم الإضافي الأعمق.
فليس لدينا حقيقة جديدة؛ بل دخول أعمق وتوضيح وتفسير لتلك الحقيقة التي هي موجودة بالفعل؛ والتي لن تُستعلن بطريقة طبيعية؛ لكن استيضاحية أكثر عمقًا وأكثر اتساعًا لكل مَن يُظهر غَيْرةً واجتهادًا ويركض حاملاً ثمر الإرادة.
والفلسفة الإلهية كحقيقة هي شيء حق وأصيل ولا يقبل إعادة النظر أو التطوير؛ لأنه خبرة روحية ومعرفة للحقيقة تُضاف إلى خبرات المراحل كظاهرة نمو؛ ليس نموًا للحقيقة؛ ولكن نموًا في العمق وفي الخبرة. إذ الحقيقة الإلهية لا تقبل زيادة أو نقصانًا؛ لأنها تتطابق والوقع الإلهي.
لذلك تحدّث الآباء عن ضرورة الدخول إلى ما هو ”مخفي“ أو إلى ذلك ”البهاء المتوارﻱ“ وهو عمل لا يمكن أن نحلله بالتخمين والحَدْس أو بمعطيات المنطق البشرﻱ؛ لكن بنعمة التفكير المشترك مع الروح القدس؛ لأنه اختبار شخصي وخبرة معرفة عميقة؛ تكشف فلسفة الاندماج والشركة مع الله؛ بكونها عملاً روحيًا؛ واقتناءًا للروح القدس؛ وتأملاً وتذوقًا لأسرار الله.
أما الفلسفة العقيمة فهي ليست بفلسفة؛ لأنها تذهب وتختفي من دون أن تغيِّر معها حياة الإنسان في شيء؛ وهي لا تعدُو أن تكون مجرد تكديس أفكار للتسلية العقلية؛ لأن الفلسفة لا بُد أن تُثمر أعمالاً وتؤدﻱ إلى تغيير في الحياة، بعيدًا عن التجريدات الاعتباطية.
لهذا تضع الفلسفة الحقة خطوطًا حقيقية تضيء وتروﻱ وتقود بوصفها ضمانات للحقيقة الأعظم الأصلية الحاملة للروح، روح الحكمة والعقل والمعرفة والمشورة، وهي ذات نفع أبدﻱ، تعمل في الداخل بطريقة خفية (سرية) ثم تظهر وتنكشف على ملامح الجسد؛ بريشة المسيح الفنان الصالح؛ الذﻱ يرسم صورة الإنسان السماوﻱ هنا ومنذ الآن (يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي)؛ وعمومًا؛ يمثل الوعي بالوجود أهمية فلسفية قصوى.
لذلك المسألة الأساسية للفلسفة تتجه ناحية موقف الإنسان من العالم المحيط؛ وعلاقة الوعي والفكر بالواقع المحيط؛ كأولوية لفهم جوهر الفلسفة؛ ولتمييز المعرفة الصحيحة الحقيقية من المعرفة الخاظئة الكاذبة.
لذلك وظّف الآباء الفلسفة كخادمة للاهوت؛ معتبرين أن الإنسان الحكيم حقًا هو المتأمل؛ حامل الروح ورائي الأسرار؛ على اعتبار أن النفس البشرية هي عرش للخالق بما لها من جوهر عقلي؛ ومن مكانةٍ تعلو على كل المخلوقات المنظورة.
لذلك تجسد المسيح من أجلها... وكل من يقدر أن يعرف حق نفسه؛ يكون قادرًا على أن يعرف القوة وسر اللاهوت (اعرف نفسك / اعرف خالقك) وكيف أن حرية النفس هي سمة شبيهة بالسمات الإلهية؛ لأن خارج الحرية لا توجد مشابهة لله؛ لكنها تتحقق في الشركة الحية معه؛ وفيها تكمن صورة الله في الإنسان (الصور السماوية).
فالمخلوق الأول كان مزوَّدًا بالكلمة وبالروح؛ واللوغوس الكلمة هو ميراثه ولباسه ومجده. كذلك كان الروح ساكنًا فيه؛ علّمه وألهمه؛ لكنه بالسقوط فَقَدَ خصائصه المنيرة الطاهرة؛ وتجرد من خاتم الملك؛ وفَقَدَ كرامته وقيمته وصورته؛ وصار كعُملةٍ سُحبت من التداول؛ بدون صورة الملك، وأظلمت بالشر وبقتامة المكر؛ وتخمَّرت بخمير الشهوات والتعدّﻱ.
لذلك نجد الفلسفة الإلهية الحقة ليست مجرد إغناء للفكر؛ لكنها رافدٌ للحياة التي تنبض بعمل الله؛ وترى وجه يسوع المسيح في كل إنسان. وتُدرك أنه أيقونته التي تستحق إكرامنا وإجلالنا مهما كان لونه أو عِرقه أو جنسه.
إن الفلسفة الحقة أرقى وأعظم من كل فلسفة؛ والتعليم الإلهي يعلو على كل نظرية وعلى كل مقولات وجدليات ورؤىً فكرية؛ لأنه أولاً وأخيرًا رؤية إلهية حياتية؛ ولولا الهرطقات والدفاعيات وتقنين العقائد؛ لَمَا انسكبت حياة الآباء في قوالب كلامية فكرية؛ اتسمت بالبساطة مع العمق. وإنْ كانت لا تخلو أيضًا من الحجة الفلسفية النافذة للعقل كوزنة إلهية، تصف الطريق المؤدي إلى الحياة؛ وكيف أنه طريق ضيق مليء بالغوايات المرة. إذ أنه طريق الإنسان الحر؛ الذﻱ يمتلك في طبيعته إرادة مستقلة حرة؛ تجعل مشاركته في العطايا الإلهية حائزة للفضيلة؛ فهو كائن حر مستقل؛ صورة للطبيعة الإلهية الحرة... حريته هي قلب كينونته ؛ حريته تنبع من وجوده كإنسان؛ إذا فقدها فقد إنسانيته؛ وكلما حقق كمال الإنسان فيه؛ حقق ملء حريته، بإنسانيته الحقة نبع حريته؛ لأن إنسانيته مختومة بطابع الصورة الإلهية (الاختيار – القرار – المصير).
هذه الإرادة الحرة هي عتبة الدخول وصعود النمو؛ عندما تنكشف الإرادة وتتجاوب سينيرچيًا
مع عمل النعمة؛ لتتفق الحرية مع الروح ؛ وتصير وعاءً لاستقبال النعمة؛ ويكون أرقى ناموس روحي لها هو المحبة؛ التي تجعل النعمة نارًا إلهية مشتعلة نحو الله والقريب؛ بحيث تتوهج النفس وتستنير وتنكشف لها أسرار محبة الله بوضوح ويقين، فتصير النفس كلها عينًا ونورًا ووجهًا ومجدًا وصلاحًا ؛ تعبُر الأبواب وتصير قادرة على التمييز بين الخير والشر؛ بحسب عهد الله المغروس في النفس؛ الذﻱ يسترجع لها معرفتها الأصلية؛ ويقيم عقلها في شركة محبة العقل؛ التي تُمسك بالزمام وتقود قوىَ النفس؛ وهذا هو جوهر كل الحياة المسيحية : إعادة توافق كيان الإنسان تحت إرشاد الروح القدس؛ باعتباره مركز الكون (كَوْنٌ مصغَّر مُحاط بكل أنواع الحياة داخل نفسه).
وبذلك يتمتع الإنسان بالحضور الإلهي؛ وينتبه إلى حاله؛ ويترك انتكاسة الشهوات والتعدي ويصير آنية جديدة؛ فيتخذ قرارته المصيرية في ضوء روح الحكمة والإفراز وقلب المعرفة، تتغير حياته جذريًا؛ بحيث يكون العقل هو رُبّان السفينة؛ الذﻱ يقود حياته في الاتجاه الصحيح.
فإنْ كانت فلسفة وأفكار هذا العالم باطلة ومحسوبة جهالة عند الرب. لذا يتعين أن نكون حذرين لئلا يسبينا بها أحد بغرور باطل حسب تقليد الناس.
أما حكمة المسيح الكاملة فهي مؤسسة على توطيد الإيمان والأعمال الفاضلة والتقوى الصحيحة من أجل إصلاح النفس وخلاصها بقوة سرية تجدد الأذهان والأشكال والحياة؛ وترتقي للكمال حسب صورة المسيح الحية؛ التي تنطبع فينا في الكنيسة أمنا (أم الأولاد الفرحة) وأساس الكون الجديد؛ الذﻱ فيه نُولَد ونتغذى ونتقوى؛ كي نؤهَّل للمواطنة السماوية ؛ وننال غايتنا المُشتهاة.
Yesterday with some professors of philosophy in many renowned universities from both Ireland and the UK