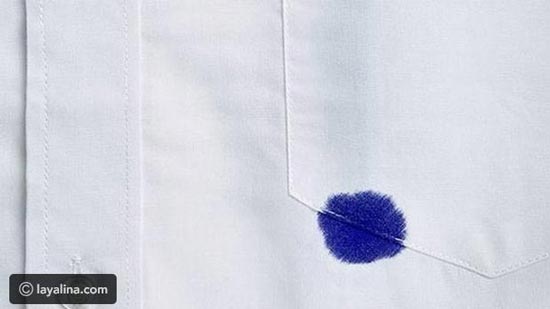البقاء في المكان نفسه يُعدّ رجوعاً إلى الوراء... اِجعلوا التغيير يبدأ الآن
منوعات | raseef22
٥٧:
٠٣
م +02:00 EET
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠١٧
"أريد تغيير مكان عملي، لأني لست سعيداً. أرغب في الانفصال عن شريكتي واختيار شخص يناسبني أكثر. أرغب في إنقاص وزني والحفاظ على صحة جيدة"... تريدون التغيير وتنادون به كل يوم لكن أحلامكم ورغباتكم تبقى في خانة الأفكار ولا تتحوّل واقعاً ملموساً؟
تشكون من ماضيكم، من ظروف خارجة عن إرادتكم أوصلتكم إلى ما أنتم عليه اليوم، منعتكم من التقدّم وتحقيق آمالكم. فتجدون أنفسكم في سجنٍ، سرتم نحوه بقرار منكم، حتى أصبحتم ضحايا الحاضر، عالقين وكأن الخروج منه متعذر.
لمَ الخوف من التغيير؟ هل تخشون الفشل، وهو يمنعكم من المحاولة؟ هل وجع التغيير الذي يسبق السعادة هو ما يخيفكم أو السعادة نفسها؟ ما سرّ تلك المماطلة في الأفعال والرغبات؟
لماذا نخاف التغيير؟
تعبّرون دوماً عن رغبتكم في أن تنجزوا شيئاً لطالما حلمتم به، على صعيد العمل أو العلاقات أو الذات؟
تفكرون في الأسباب التي تمنعكم من التقدم، فتبررون امتناعكم، من خلال أحداثٍ حصلت في الماضي أثرت فيكم سلبياً وتركت لديكم حالة من الخوف أو التردد. تربية الأهل ربما. ضغط المجتمع. قلة الفرص. أسباب خارجة عنكم أتت سواء من الأهل أو الشريك أو أحد الأصدقاء. تواسون نفسكم من خلالها وتستمرون في وضع يسرق منكم سعادتكم.
هل من مبرر للخوف من التغيير؟ وإن كان يوجد مبرر، فما هو؟ الشفقة على حالكم مثلاً؟
هذا ما اعتبرته المحللة النفسية والكاتبة فاليري بلانكو في كتابها "كلام الكرسي"، أنه من خلال فهم ذاتنا نستطيع تفكيك وتبسيط هذا البرنامج الموجود في داخلنا، والذي يتحكم في سلوكنا لا شعورياً.
نستطيع أن نعرف الأسباب التي تجعلنا غير مسيطرين على هذا السلوك أو ذاك، والذي يجعلنا مكبلين غير قادرين على الخروج من وضع معين يزعجنا.
لكن فهم الماضي والأسباب ليس كافياً لتغيير الحاضر، بل يشكّل أحياناً ذريعةً لكسلنا وللمماطلة في أخذ القرارات، لأننا نظن أن لا دور لنا في ما حصل، وأننا مجرد دمى، حرّكها الأهل أو المجتمع أو المعتقدات الدينية.
ننسى أننا شركاء في ما يحصل لنا، وأن الـ"أنا المقررة"، هي التي يجب أن تلعب الدور الأساسي في قبول الحاضر أو تغييره مهما كانت الظروف المحيطة، خصوصاً أن حججنا باتت واهية بفعل العمر وبلوغ سنّ الرشد والقدرة على أخذ القرارات.
الهدف إذاً هو أن تتقدموا برغم الضغوط أو العوائق الخارجية والنفسية الداخلية، التي قد تمنعنا من سؤال أنفسنا: أين حصّتي في ما يحدث لي؟ أين دوري...
أين أخطأت؟ ما هي الاحتمالات المتاحة أمامي؟
كل تلك أسئلة مفيدة وضرورية، إذ علينا أن نراجع أنفسنا من خلالها عوضاً عن البحث عن المسؤولية في مكان آخر.
لكن الأسئلة تلك مخيفة في بعض الأحيان. فللتغيير ثمن باهظ. أن تتركوا عملكم. أهلكم. شريككم. إنه أمر لا يمكن أن يحدث من دون ألم أو حسرة.
التغيير يعني الانتقال من وضع اعتدناه لسنوات حتى لو كان مدمّراً لنا، إلى وضع آخر مجهول. ليس ذلك فقط! بل هو ليس من صنع الأهل ولا صيغ في الماضي. وضع لن نستطيع لوم أحد على اختياره لأننا نحن أبطال القصة هنا.
ماذا لو فشلنا؟ ماذا لو لم نستطع السير وحيدين، ولم نتحمّل النقد الذي يمكن أن نُواجه به إذا غرّدنا خارج السرب؟ والأهم، ماذا عن شعور الذنب الذي قد يستيقظ فينا ويذكرنا بمقولة "رضا الله ورضا الوالدين"؟ ماذا إذا كان التغيير مزعجاً لهم؟ هل نتجرّأ على كسر الجدار النمطي ونبحث عن سعادتنا من دون خوف؟
البديل هو الهرب. أو إبقاء الحال على ما هو عليه، واللجوء إلى التذمّر الذي يولّد فينا وفي من حولنا طاقة سلبية تصيب بصرنا وبصيرتنا بغشاوة، فتصبح كل الاحتمالات غائبة وكأننا في سجن أو مجبرون على السير في اتجاه واحد لا غير.
كيف نتغلب على خوفنا من الفشل؟
التغيير صعب ومؤلم. دعكم من المجازفة... ماذا لو خسرتم؟ ماذا لو أصبحتم وحيدين؟ أسئلة تدور في بالنا حين نفكر في طي الصفحة والبحث عن جديد سواء في حياتنا المهنية أو العاطفية أو حتى الذاتية.
تساؤلات سمعناها وورثناها عن طباع الشخص والقدر والمصير، وغيرها من الأفكار والمعتقدات، التي تسلب المرء حرية الخيار، وتجعله مكبّلاً وضحية ظروفه، غير قادر على التحليق والتميّز، فيختار السير بجانب الحائط ولا يجرؤ على المضي قدماً.
لكننا ننسى أنه إلى جانب تلك الأفكار النمطية، أقوال وتجارب مثبتة عن أشخاص تغيّروا فغيّروا في مسار هذا العالم وأسهموا في تقدم البشرية وتطورها. فالبقاء في المكان نفسه رجوع إلى الوراء، لأن كل ما يحيط بنا في حال من الحركة والتطور الدائم. وعوضاً عن أن نحصي خساراتنا، لمَ لا نفكر في الأرباح... أو في الأبواب التي ستفتح أمامنا حين نضع ذاتنا أولوية؟
ومن قال إن التغيير يجب أن يشيع عداء مع الآخرين؟
تعتبر باتريسيا غرودالون، المعالجة في التنويم الإيحائي، أن بعض الثوابت التي نتربى عليها متجذرة في شخصيتنا، وتبقى لتثبت أكثر مع نمو الطفل الذي في داخلنا.
واحدة من تلك الثوابت، هي القائلة إن أي سلوك مخالف لمشيئة الأهل أو لخياراتهم هو خرق لمبادئ السلوك الحسن ونتيجته العقاب وبعث الشعور بالذنب. نكبر وتتبدل الأقنعة في تصرفاتنا لكن الجوهر يبقى ثابتاً، فنجد أنفسنا في صراع بين ما نريد وما يراه الآخرون مناسباً.
لكن الحقيقة هي أن الصراع انتهى وأصبح من الماضي شأنه شأن الطفل الذي فينا. وأصبحنا قادة لحياتنا ولنا الحق في ارتكاب الأخطاء وتحمل المسؤولية والأوجاع، والأضرار الناجمة عن خياراتنا، ومعها السعادة التي سنشعر بها حين نجد أنفسنا وقد أنجزنا شيئاً مختلفاً، شيئاً حلمناً به طويلاً.
لن يدرك الآخرون مدى المتعة التي سنشعر بها. وهذا ليس مهماً. يكفي أن نصفق لأنفسنا وندرك أن لا نجاح يأتي من دون بعض المحاولات الفاشلة.
على العكس، فإن تلك المحاولات تساهم في جعل صورة المستقبل الذي نحلم به أكثر وضوحاً وصلابةً إذا استطعنا اتخاذ الدروس. السرّ إذاً في التصالح مع الطفل الذي في داخلنا ووضعه في المكان المناسب: في الماضي. لننتقل لاحقاً إلى الحياة التي نريد بعيداً عن الخوف المعرقل والشعور بالذنب.