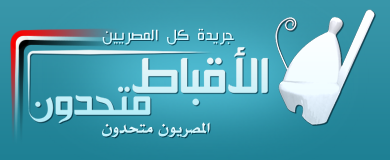البراغماتيّة بين العقل و الدّين
بقلم: سهيل أحمد بهجت
إن العلمانية هي حصيلة حضارات متعددة، بل إن للإسلام نفسه كدين مساهمة في نضوجها، و نحن هنا لا نعني الإسلامات الرسمية التقليدية التي كانت تتبناها أنظمة، و إنما نعني جملة الجدل الفكري الفلسفي الإسلامي و التي أوحت للغربيين بطي صفحة التقليد و بدء وضع علامات الاستفهام هنا و هناك، و لأن الظاهرة الدينية في الغالب مطاطة و يسهل استغلالها سياسيا و لتبرير النفوذ فإن العلمانية تأتي كضرورة تاريخية ـ لا كعلاج غريب ـ لأن الدين الذي يصبح تابعا للسياسة، و السياسة التي تصبح تابعا للدين، كلا الحالتين تقومان بتشويه الدين المطلق لاختلاطه بالنسبي الناقص، فالتحديث هنا هو نزع التبرير الديني لحالة الجهل و التخلف و ربط الإنسان بالأسباب الواقعية الموضوعية لهذا العالم، و التحديث هنا يخرج الإنسان من نظريات التقسيم الإلهي (الطبقية المبررة دينيا) و النصيب و خرافة أن ما كتب على الجبين لازم تشوفه العين!! مع أن لا شيء مكتوب على جبين الإنسان، و ما يعتبره جلال أمين (التحديث في الإطار الغربي المادي) ليس له منافس ـ تحديث من نمط آخر ـ و لم نسمع أو نرى تحديثا من نمط الروحانيات، فالتحديث بالأساس يهدف إلى تحرير الإنسان من الطبيعة ـ لا من الإيمان الديني ـ لأن كل الأديان مرت بفترة من فترات الظلام في تاريخها حيث تم دمج الدين بالأسباب الدنيوية التي حولت الدين إلى آلة بيد البعض أكثر من كونه "فكرة" أو "إيمان" للنجاة أو لتجاوز العالم المادي المحسوس، و كان من الطبيعي أن نجد الدول الغربية التي تساوي بين مواطنيها في الحقوق و تطبيق القانون أقوى من الامبراطورية العثمانية.
يقول عبد الوهاب المسيري:
"لكل هذا جعل جلال أمين همه كشف المنطلقات الميتافيزيقية المسبقة للعلمانية، و جوهر المنظومة العلمانية في تصوره (دون استخدام المصطلح بالضرورة) هو الإيمان بأسبقية المادة على الفكر (و التي يمكن ترجمتها بأنها أسبقية المادة على الإنسان). و هذا هو حجر الزاوية في الرؤية العلمانية، و هي التي تنبثق عنها كل مقولاتها الأخرى، و لأن المادة تسبق الفكر، نجد أن العنصر المادي (في أشكال مختلفة) يصبح أهم المكونات، فعلى سبيل المثال، يتم إخضاع كل شيء لمبدأ المنفعة، التي تعرّف تعريفا ماديا (تعظيم الناتج في عدد محدود من الموارد)، و الطبيعة من هذا المنظور ليست سوى مادة، وسيلة لإنتاج السلع، و الإنسان هو الآخر يعرَّف في الإطار المادّي: إحتياجاته مادّية ـ أحلامه مادية...إلخ" ـ المصدر السابق ص 110
إن ما يطلبه المسيري و جلال أمين من العلمانية من تقديم إجابات على أسئلة ليست من اختصاصها، هو من الاجحاف و تجاوز لواقع اختصاص مجال كل نظرية أو علم، فالعلمانية معنية بمجالات تختلف عن تلك المجالات المختصة بالدين مثلا، و نحن هنا لا ندري ـ إذ يسكت كلا الناقدين عن التوضيح ـ ما هي المجالات التي يُفترض التحديث فيها بعيدا عن المادة و الطبيعة!! و ما هي المجالات "الروحية" التي يمكن للدولة و الشركات الاستثمار فيها!! بمعنى آخر و لكي يحصل الإنسان على الخلود و الخلاص "المنتظر من الدين تقديمه" ـ و هو بسيط و متوفر في عقل و قلب كل إنسان ـ المطلوب هنا "مسيريا" أن نحول الدولة إلى نظام نفاقي ريائي يتقن بناء المساجد و تتدخل في حياة الناس الخاصة و الشخصية ليتم فرض نمط واحد من الأخلاق و المواقف و الأجوبة التي تطرح مقابل الأسئلة الكبرى، كما أن اتهام العلمانية بأنها تقول بمبدأ "أسبقية المادة على الفكر" هو اتهام لا حقيقة له، فالعلمانية تتمركز حول الإنسان و مصلحته الأساسية المركزية في أن يكون حرا و مسؤولا عن قراره، و العالم المحيط بنا موجود فعليا قبل الإنسان، و هو ما أجمعت عليه الديانات و العقول، و لكن هذا الوجود لا قيمة له بدون هذا الإنسان الذي يحكم بالوكالة عن الله ـ بالمصطلح الديني ـ أو عن العقل الخلاق الذي انبثقت منه الحياة ـ بالمصطلح الفلسفي ـ فبدون الإنسان لا معنى لكل الكلمات و لا مكان للفلسفات أو المصطلحات، و بالتالي فإن المنفعة ـ و هي جميلة طالما أنها ليست ضررا لبشر آخرين ـ هي أساس وجود الإنسان و مصلحته حتى في المفهوم الدّيني { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} الرعد ـ 16 { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} النحل ـ 6 و عن الحج { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} الحج 28 و المنفعة هنا و حتى بالتعبير القرآني تتجاوز الإسلام أو أي دين آخر و بالتالي فلها مفهوم بشري عام لا يختص بتعريف فئة دون أخرى، و الحكم المسبق على الإنسان الغربي بأن "حتى أحلامه" مادية، حكم ظالم يتجاوز الحقيقة، فالكتب التي تؤلف في الغرب و البحوث المتعلقة بالجوانب الروحية للإنسان تفوق منتجنا الحضاري بشكل غير قابل للتصور، فالإنسان يبقى إنسانا ذا مزايا محددة سواءٌ عاش في بيئة متخلفة أو متطورة، غير أننا إذا عرفنا الإنسان الروحاني بذلك الذي يتقبل كل التأويلات الأسطورية و الخرافات فإن تحليلنا سيكون بائسا بالتأكيد.
يقول المسيري:
"و يلاحظ جلال أمين أننا إذا قبلنا المقدمات الميتافيزيقية (المادّية) لعلم الاقتصاد الغربي، فإن ذلك سيفضي إلى قبول مقولاته الاقتصادية و السياسية، فالإنسان هو أساسا إنسان اقتصادي، يستجيب بطبعه لمشرات الأسعار و النفقات و حافز تعظيم الدخل، و هو يهاجر بطبعه إلى حيث يجد أكبر دخل ممكن، و يرى أن من الطبيعي أن يستقل الابن أو البنت عن الأسرة من أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل. في هذا الإطار يتم تعريف الاقتصاد تعريفا فنيا تكنوقراطيا ضيقا، فالجوانب الاقتصادية في الوجود الإنساني هي تلك الجوانب القابلة للقياس، و ما يمكن تقديره بالأرقام [أي الإنسان تم تحويله إلى ظاهرة رياضية تنحل إلى أرقام، شيء بين الأشياء]، و من ثم استبعد من عالم الاقتصاد حاجة الإنسان إلى حد أدنى من الشعور بالأمن و الاستقرار، و من العلاقات الاجتماعية، و من الاتصال بالطبيعة و من الثبات في القيم الأخلاقية و الاجتماعية السائدة [فهي جميعا غير قابلة للقياس]. (إن أردنا استخدام مصطلحنا ـ و الكلام هنا للمسيري ـ قلنا: إن الحيز الإنساني ينكمش و يضمر و يذوب حتى يختفي تماما لصالح الطبيعي/المادي." ـ العلمانية تحت المجهر ص 110 ـ 111
فلننظر إلى كلّ هذا الكلام و في إطار يطرح؟ إنه طرح التساؤلات التي لا تمتلك أجوبة، فكلا الكاتبين المسيري و أمين يستشكلان فقط "تنظيريا" على العلمانية و مقوماتها و أطروحاتها الإقتصادية و الاجتماعية دون امتلاك نماذج واقعية "مثالية" أو أكثر إيجابية من العلمانية ـ التي يستشكل عليها ها هنا على أنها غربية!! ـ فنجدهم صامتين كليا عن أي إشارة إلى النموذج النقيض، و إن كنا سنرى المسيري فيما بعد يتحسر على الدولة العثمانية (المعروفة بكونا فوضوية نفاقية) و ماضي الأمة العربية (ممجدا بالأمة القومية التي ذمها حينما كان يتحدث عن النظم القومية الغربية)، و هذا الصمت ناشيء عن عدمية النقيض، فكل الدول الدكتاتورية و الاستبدادية هي نقيض العلمانية الصحيحة طالما أنها تتبنى وجهة نظر عقائدية تفرضها على الشعب أو جزء منه فلا تعريف للحرية يصون الحرية و يكون ضد "النمط الغربي" للحرية و الديمقراطية، لكن الكاتبين يصران على وضع العلمانية في خانة الإلحاد ـ حالها حال الشيوعية ـ متجاهلين حياديتها في كل الجوانب باستثناء حدية العلمانية في توفير الحرية الفكرية لكل إنسان، و إلى جانب الحرية يجد الفرد أنه قد أصبح متاحا له بالفعل أن يفكر في مشاكله أو في البحث عما يشاء.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :