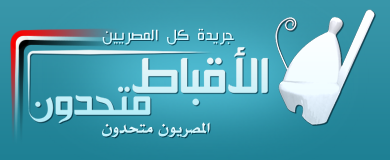الثورة والتطور السلمي التدريجي 2
بقلم: عبدالخالق حسين
الثورة والتطور السلمي التدريجي
وإنصافاً للتاريخ يجب أن يذكر أن العهد الملكي لم يكن شراً كله، كما يدعي بعض أنصار الثورة، كما ولم يكن خيراً كله وازدهاراً عميماً كما يدعي أنصار الملكية، بل كانت هناك جوانب إيجابية تبشر بالخير لو سارت الأمور كما كان مخططاً لها من قبل المخلصين من أمثال الملك فيصل الأول. أقول لا يمكن لأي منصف أن ينكر دور الملك والسياسيين الأوائل من أتباعه فيما بذلوا من جهود مضنية في تأسيس الدولة العراقية الحديثة وبمساعدة الإنكليز بعد تحرير العراق من الاستعمار التركي العثماني المظلم وما أعقب ذلك من تململ الشعب العراقي في ثورة العشرين. إذ كان العراق يسير بقيادة فيصل الأول بخطى ثابتة ومتزنة على طريق التطور السلمي التدريجي لبناء دولة عصرية دستورية وديمقراطية وفي أشد الظروف تخلفاً وصعوبةً. ولا يمكن أن نقلل مطلقاً من الصعوبات التي واجهها الرواد الأوائل في بناء الدولة العراقية.
ولكن هذا التطور السلمي التدريجي توقف بوفاة الملك فيصل الأول، ولم يكن ابنه الملك غازي مهتماً بالشأن العام، وبعد مصرعه عام 1939، تسلط الثنائي نوري السعيد وعبد الإله على مقادير السلطة. ويؤكد هذه الفرضية الباحث الدكتور كمال مظهر أحمد فيقول: "وفي الواقع إن أكبر خطأ قاتل ارتكبه النظام (الملكي) في العراق يكمن في موقفه من الديمقراطية، فعلى العكس من منطق الأشياء، سار الخط البياني لتطور الديمقراطية في العهد الملكي من الأعلى إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى، ويتحمل الجميع وزر ذلك، ولكن بدراجات متفاوتة".[2]
لذا فإني اعتقد جازماً أن نهاية النظام الملكي قد بدأت عملياً برحيل أحد مؤسسيه وهو الملك فيصل الأول، ولم يحصل أي نوع من الاستقرار السياسي في العراق منذ وفاته عام 1933 حيث فقدت الحكومة العراقية هيبتها، وصار نوري السعيد هو الحاكم المستبد في العراق، ولعب دوراً كبيراً في إيقاف عجلة التطور السلمي التدريجي وتجميد أو تهميش الدستور وبدأت مرحلة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وكانت الأحكام العرفية هي القاعدة وليست استثناءً، حيث أُعلِنَتْ 16 مرة بين 1932 و1958.
لقد كان فيصل الأول سياسياَ محنكاَ بالفطرة والتجربة وذو ثقافة سياسية واجتماعية جيدة نسبياً وفق معايير وظروف ذلك الزمان، فكان يلتقي باستمرار بقوى المعارضة والشخصيات الوطنية ورجال الدين ورؤساء العشائر، ويستمع إلى آرائهم وطلباتهم، ويشرح لهم الصعوبات التي تواجه الدولة في تلك المرحلة، وكان يطمئنهم على تحقيق مطالبهم على شرط أن لا يحاولوا فرضها على السلطة بالقوة، وأن هذه الطلبات ستتحقق مع الزمن وأن خيراً عميماً سينتظرهم إذا ما تجنبوا العنف. لذاك سارت الأمور في عهد فيصل بهدوء وكان التطور يجري بسلام.
ولكن بعد وفاة فيصل تغيّرت الأمور رأساً على عقب وامتنعت السلطة عن أي حوار أو تفاهم مع المعارضة الوطنية. فكان نوري السعيد غير ملمٍّ بفن التواصل والتفاهم مع الآخرين، إذ لم يكن خطيباً ولا كاتباً ولم يهتم بالدعاية والإعلام من أجل شرح سياساته وإقناع الجماهير والمعارضين له بجدواها، وكان ينظر إلى الجماهير نظرة استخفاف، مستهيناً بالمعارضة، معتمداً كلياً على الجيش في حمايته، وشيوخ الإقطاع في إدارة الحكم واستمراره في السلطة وفق مقولته المعروفة (دار السيد مأمونة).
ونعود للسؤال الذي يطرح نفسه دائماً وهو: أما كان الأجدر بالقوى السياسية والعسكرية الانتظار ومحاولة تغيير الوضع بالطرق السلمية وهل كانت هناك حاجة لثورة مسلحة كثورة 14 تموز 1958؟
والجواب هو إن التطور سنة الحياة، ويشمل كل شيء في الوجود، في المجال البايولوجي والبيئي وحتى في شكل القارات ومواقعها، وكذلك فيما يخص التطور الحضاري والاجتماعي والسياسي. فهذا الوضع الحضاري المتقدم الذي يعيشه العالم اليوم في الغرب لم يحصل بين يوم وليلة بل حصل من خلال هزات وكوارث تاريخية واجتماعية وحروب وثورات وزلازل وبراكين سياسية على مر العصور، وهذه مسألة طبيعية جداً في حركة التاريخ ومساره. فالتطور حتمي ويشمل جميع الأشياء ومجالات الحياة، فإما أن يحصل بصورة سلمية إذا لم تقف الحكومات عائقاً أمامه، أو على شكل ثورة عارمة تجرف أمامها كل عائق إذا ما وقفت الحكومات عائقاً للتطور السلمي التدريجي. وهذا هو منطق الحياة في كل زمان ومكان.
وهناك مقولة ماركسية تفيد بأن التراكمات الكمية تؤدي إلى تحولات كيفية (نوعية). ويوضح ذلك الراحل حسين مروة فيقول: "يرشدنا المنهج العلمي إلى حقيقة مهمة في تاريخ تطور المجتمعات البشرية والحضارات، هي أن التراكمات الكمية ضمن مجرى هذا التاريخ يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة في تحولها الكيفي. يمكن مثلاً، أن تتحول إلى كيفية سياسية، أو اجتماعية، أو فكرية نظرية، أو إلى نوع من العنف الثوري. لقد تابع انجلس أشكال المعارضة الثورية للإقطاع في القرون الوسطى كلها، فوجد أن الظروف الزمنية، كانت تظهر هذه المعارضة حيناً في شكل تصوف، وحيناً في شكل هرطقات سافرة، وحيناً في شكل انتفاضات مسلحة. إن شكل التحول الكيفي في هذا المجتمع أو ذاك، وفي هذا الزمن أو ذاك، إنما تحدده طبيعة الظروف الملموسة، وربما كانت الظروف هذه مؤهلة وناضجة أحياناً لحدوث تحولات كيفية مختلفة الأشكال في وقت واحد، أي قد تجتمع في ظروف معينة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية معاً، قد ترافقها انتفاضات مسلحة، وقد تأتي هذه التحولات تمهيداً لانتفاضات مسلحة، وقد يستغني بها التطور عن أشكال العنف الثوري كلياً."[3]
إذن هناك حاجة ملحة للتطور السياسي ليتناسب مع حاجة الشعب من الناحية الاجتماعية والمعيشية، أي الوضع المادي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.. الخ. فإذا كانت السلطة واعية لهذه القوانين وتسمح بالتقدم والتطور حسب ما تقتضيه المرحلة، يحصل هذا التقدم تدريجياً بدون هزة ثورية ودون الحاجة إلى عنف وسفك دماء. أما إذا كان الحكام لا يؤمنون بالتطور وأنانيين ولا يعترفون بالحاجة إلى التغيير لمواكبة التطور والاستجابة لحاجة الشعب إلى التغيير، فتكون هذه السلطة رجعية ومحافظة تعمل على إبقاء ما كان على ما كان، كما يقال، وتقمع أية محاولة لمواكبة التطور. ومع مرور الزمن تزداد الحاجة إلى التغيير ويحتدم الصراع بين قوى التجديد والقوى المحافظة (السلطة) فتضطر السلطة الرجعية ومن أجل بقائها في الحكم، إلى استخدام العنف والإرهاب والقوة لقمع القوى المطالبة بالتغيير، إلى أن تتراكم الحاجة إلى التغيير مع الزمن أكثر فأكثر وتصل حداً تصبح الحياة غير ممكنة مع الوضع القديم، عندئذٍ ينهار الجدار العائق أمام السيل العارم، ويحصل الطوفان، الانفجار الثوري والذي يحرق الأخضر واليابس، فتأتي سلطة تستجيب لحاجات التطور الاجتماعي ورغبات الشعب. إن القانون الفيزيائي المعروف: الضغط يولد الانفجار، ينطبق على جميع مجالات الحياة، الاجتماعية والسياسية وغيرها.
لذلك فالتطور يفرض نفسه، إما بصورة سلمية كما يحصل في الأنظمة الديمقراطية أو بالثورة المسلحة الدموية كما في الأنظمة المستبدة. ففي النظام الديمقراطي، توجد حكومة منتخبة من قبل الأغلبية من الشعب تحاول قدر المستطاع أن تستجيب لرغبات الناخبين. لنفرض أن جاء حزب محافظ إلى السلطة ديمقراطياً. فهذه السلطة تحاول الحفاظ على ما هو موجود من قوانين محافظة لأوضاع اجتماعية معينة وفي مرحلة تاريخية معينة. وتكون هناك أحزاب معارضة تراقب السلطة وتحاسبها على كل شيء وتوجه لها النقد ضد الأخطاء. وبمرور الزمن تفرض الحياة أموراً جديدة تتطلب التغيير، لكن سلطة الحزب المحافظ ترفض التغيير، إلى أن يؤمن الأغلبية من الناخبين أن مصالحهم أصبحت مهددة بوجود سلطة المحافظين، وهناك ضرورة ملحة للتغيير بسبب التراكم الكمي، ففي الانتخابات القادمة يأتي الناخبون بالحزب الذي يضع في بيانه الانتخابي برنامجاً يستجيب لحاجة الناس إلى التغيير.
وهكذا تأتي السلطة الجديدة التقدمية بالمعنى العصري فتأتي بالقوانين الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة وتبقى في الحكم وتستمر بخلق قوانين جديدة إلى أن تذهب بعيداً أكثر مما يتحمله الشعب، عندئذٍ يأتي دور المحافظين لإيقاف التغيير وإعطاء الشعب وقتاً كافياً لهضم واستيعاب ما هو موجود إلى أن يصبح الجديد قديماً في المستقبل ويتعداه الزمن، وتستجد أمور أخرى وتشتد الحاجة للتغير مرة أخرى فتعود الدورة من جديد ويأتي الحزب الذي مع التجديد إلى السلطة. وهكذا يتم تداول السلطة بين الأحزاب المحافظة والمجددة بالتناوب بصورة سلمية حسب الحاجة للتغيير أو البقاء على الموجود، بدون سفك دماء عملاً بالقول: Ballet instead of bullet. أي تغيير السلطة بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص. فالمجتمع في الأنظمة الديمقراطية يسير على رجلين، رجل تتحرك إلى الأمام ورجل ثابتة على الأرض للاستراحة!
وأفضل وصف لظاهرة الثورات جاء في كتاب (عصر القطيعة مع الماضي) للمفكر الأمريكي
(Peter F. Drucker) فقال: "أن الثورة لا تقع ولا تصاغ ولكنها (تحدث) عندما تطرأ تغييرات جذرية في الأسس الاجتماعية تستدعي (إحداث) تغييرات في البنية الاجتماعية الفوقية تتماشى مع (التغييرات) التي حدثت في أسس البنية المجتمعية، فإن لم يُستَبقْ إلى هذه الأحداث تنخلق حالة من التناقض بين القواعد التي تتغير وبين البنية الفوقية التي جمدت على حالة اللاتغيير. هذا التناقض هو الذي يؤدي إلى الفوضى الاجتماعية التي تقود بدورها إلى حدوث الثورة التي لا ضمانة على أنها ستكون عملاً عقلانياً ستثمر أوضاعاً إنسانية إيجابية".
وبناءاً على ما تقدم، فاللجوء إلى الثورة المسلحة في العراق، كان أمراً محتوماً وذلك لعدم سماح الحكم الملكي- السعيدي بإجراء التغييرات المطلوبة بالوسائل الديمقراطية السلمية. ومن هنا نعرف أيضاً إن ثورة 14 تموز كانت ثورة حتمية ومن غير الممكن تجنبها في ظل الأوضاع السائدة آنذاك. والذي يقول إن الثورة قامت بها مجموعة من الضباط المغامرين بدوافع ذاتية بحتة، فإنما يدل على عدم إطلاعه على قوانين التطور وجهله بتاريخ العراق. وهذا لا ينكر وجود بعض الضباط المغامرين ضمن تنظيمات الضباط الأحرار بدوافع ذاتية في الحكم، ولكن نؤكد مرة أخرى أن هؤلاء لا يمكنهم تفجير ثورة ما لم تكن الظروف الموضعية مهيأة للثورة.
الدستور (القانون الأساسي)
نعم كان في العراق في العهد الملكي دستور مدوَّنْ يصلح لأرقى المجتمعات المتحضرة والدول العريقة في الديمقراطية. ولعل أروع ما كان فيه هو مادته السادسة التي نصت على ما يلي: "لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة…". وتنص المادة السابعة: "الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل، ولا يجوز القبض على أحدهم أو توقيفه أو معاقبته، أو إجباره على تبديل مسكنه أو تعرضه لقيود أو إجباره على الخدمة في القوات المسلحة إلا بمقتضى القانون. أما التعذيب ونفي العراقي إلى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتاً".
ولكن هذا الدستور من الناحية العملية كان مجمداً، وقد وضع على الرفوف العالية. فمن المعروف أن النخبة الحاكمة كانت تحكم البلاد بدستورين. دستور ديمقراطي مدون غير معمول به، ودستور مجحف غير مدون وهو القانون الفعلي الذي كانت تسير عليه السلطة في حكم البلاد والعباد. وهذا الدستور غير المدون، فيه تمييز عرقي وطائفي وإلغاء المعارضة الديمقراطية وسحق حقوق الإنسان. وقد قامت السلطة الملكية عام 1943 بتعديل الدستور الذي عزز من سلطات الملك خلافاً لقاعدة (مصون وغير مسؤول) التي كانت أساس الدستور الأول.
الإنتخابات البرلمانية
نعم كان النظام الملكي برلمانياً، ولكن بالاسم فقط، كوسيلة لإخفاء الدكتاتورية في الواقع. وغالباً ما كان يفتضح أمره عندما يصل الوطنيون المعارضون إلى البرلمان عن طريق الانتخابات، فتبادر السلطة الملكية لحل البرلمان وإغلاق الصحف وفرض الأحكام العرفية ويتم تزييف الانتخابات ليفوز أنصار السلطة بالتزكية. وقصة السيد عبد الكريم الأزري، النائب والوزير في الحكومة الملكية باتت معروفة كما ذكرها هو في مذكراته. خلاصتها انه استلم مكالمة تلفونية في يوم من أيام تشرين الأول سنة 1943 من أحد أقربائه وهو السيد حسن الرفيعي قائلاً له: " أهنئك من صميم القلب، فسألته على ماذا تهنئني؟ فأجابني على فوزك في الانتخابات النيابية!.. فقد ذكرت الإذاعة الصباحية اسمك بين الفائزين في الانتخابات النيابية عن لواء العمارة (محافظة ميسان حالياً) . قلت له: هل تمزح؟ قال لا والله لا أمزح. وقد تبين فيما بعد أن ما أنبأني به السيد الرفيعي كان صحيحاً وإنني قد انتخبت نائباً عن لواء العمارة وأنا لا أدري، فلم أراجع أحداً، لا من الناخبين ولا من المنتخبين الثانويين.. ولم أرشح نفسي... وهكذا نمت ليلتي وأصبحتُ في الصباح نائباً عن لواء العمارة".[4]
وهنا يقول الجواهري:
وبأن أروح ضحىً وزيراً مثلما أصبحتُ عن أمر بليل نائبا.
ويذكر عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي في كتابه (خوارق اللا شعور) قصة مشابهة لحالة السيد الأزري فيقول: "روى لي أحد الثقاة قصة تكاد لا تصدق لو رويت في بلد غير هذا البلد. يقول الراوي: إنه سمع ذات يوم، في موسم من مواسم الانتخابات الغابرة، بأن برقية هبطت على متصرف اللواء من بغداد تأمره بانتخاب شخص معين. وقد ذهب هو وجماعة معه لتهنئة الشخص المحظوظ، فقبل الشخص منهم التهنئة. هذا مع العلم أن يوم الانتخابات الرسمي لم يكن قد حان وقته، وأن الاستعداد للانتخابات كان قائماً على قدم وساق كما يقولون.". ويعلق الوردي على ذلك قائلاً: "إن نائباً يُعيًن في مجلس النواب على هذه الصورة لا يشعر طبعاً بأنه ممثل الشعب، والشعب كذلك لا يشعر بأن في الحكومة من ينطق باسمه ويدافع عنه حقاً.. على هذا المنوال تتسع الثغرة بين الشعب والحكومة وينشق الضمير والأمر لله الواحد القهار."[5]
البرلمان
أما البرلمان فكان عبارة عن مهزلة. ولم يكمل البرلمان دوراته القانونية إلا مرة واحدة. ويكفي أن نقول أن نوري السعيد كان قد حلَّ البرلمان عام 1954، الذي تسنى له عقد اجتماع واحد فقط وبعد افتتاحه بخطاب العرش، حيث دبر نوري السعيد انقلاب القصر على زميله أرشد العمري، رئيس الوزراء آنذاك، فصدرت الإرادة الملكية بتعطيل المجلس قبل أن يعقد أية جلسة أخرى، أو أن يتسع له المجال لتأليف اللجان الدائمة، فما كاد نوري السعيد يؤلف وزارته الثانية عشرة في 3 آب 1954 حتى استصدر إرادة ملكية بحل هذا المجلس بالذات، فانتهت بذلك الدورة الانتخابية الرابعة عشرة، وذلك بسبب فوز أحد عشر نائباً من المعارضة من مجموع مائة وخمسة وثلاثين نائباً[6]. أقول، ما هو تأثير أحد عشر نائباً معارضاً من مجموع 135 نائباً على قرارات السلطة الحاكمة؟ أليس هذا دليل على عدم تسامح السلطة الملكية مع المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت ضعيفة؟
نتائج الإستهانة بالجماهير والديمقراطية
إن سياسة استهتار واستهانة السلطات في العهد الملكي بالجماهير والديمقراطية والدستور وتزييف الانتخابات البرلمانية واضطهاد الأحزاب المعارضة وقمع المظاهرات وقتل السجناء السياسيين وبؤس قطاعات واسعة من الشعب، رغم ادعاء السلطة بالديمقراطية، هي التي جعلت الجماهير العراقية تفقد ثقتها بالدستور والبرلمان والديمقراطية ومؤسساتها، واليأس من الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية لانتفائها. وهذه السياسة هي التي فتحت الباب أمام العسكر لدخولهم السياسة من أوسع أبوابها، وجعلت قيادات الأحزاب الوطنية تفقد كل أمل في تحقيق الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية ولم يبقى أمامها أي خيار آخر سوى فرضه بالقوة. وقد اضطر العديد من السياسيين الوطنيين المخلصين الذين لا يمكن الشك في نزاهتهم وإخلاصهم للوطن مثل الزعيمين الوطنيين جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي وغيرهما إلى الاعتماد على العسكر واللجوء إلى القوة لفرض الإصلاح السياسي كما حصل في انقلاب بكر صدقي عام 1936، وتكررت المشكلة ذاتها عام 1941، ثم في الخمسينات عندما اضطهدت السلطة السعيدية القوى الوطنية وحلت البرلمان عام 1954 كما مر بنا.
إن المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التي تشكل القوة الدافعة وراء الثورات، خاصة عند انتفاء الوسائل السلمية الديمقراطية لإحداث التغيير المطلوب. ولكن ومع الأسف الشديد، يرفض البعض الأخذ بهذا التحليل العلمي للثورات والهزات الاجتماعية تاركين المجال لعواطفهم ومخيلتهم في تفسير الأحداث الكبرى كثورة 14 تموز العراقية تفسيراً عاطفياً.
ومن كل ما تقدم، نفهم أن النظام الملكي هو الذي توقف عن التطور السلمي التدريجي واستند دوره وصار عقبة أمام التطور، وبعمله ذاك قد بدأ يزرع بذور الثورة ضد نفسه، وأصبح تغييره بالعنف مبرراً وخاصة عند الاقتدار عليه. أما ما حصل فيما بعد، ومجيء نظام صدام حسين، فهذا ليس بالأمر الغريب في التاريخ. إذ كما يقول كارل ماركس: "الناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم، ولكن النتائج لن تكون كما يرغبون".
دور الدستور والبرلمان في العهد الملكي
كان في العهد الملكي دستور وانتخابات وبرلمان ومعارضة. ولكن العبرة ليست بوجود هذه المؤسسات فحسب، بل المهم هو دورها في الحكم وحياة الشعب. ويتفق أغلب الذين كتبوا في تاريخ العراق الحديث، أن الحكومة هي التي كانت تسيطر على البرلمان وتقرر مصيره وليس العكس. لقد كان الدستور حبراً على ورق، والبرلمان كان جسماً بلا روح. لذلك وصف الشاعر معروف الرصافي محذراً حكومات ذلك العهد بسوء العاقبة بقصيدة نقتطف منها:
عَلَمٌ ودستور ومجلس أمـــــــة كل عن المعنى الصحيح محرَّفُ
إن دام هذا في البــــــلاد فإنه بدوامـــــه لسيوفـنا مسترعـف
كم من نواصِ للعـدى سنجزهـا ولحىً بأيــد الثائرين ستنتفُ
لقد كتب العديد من المهتمين في تاريخ العراق الحديث عن تلك الفترة ومنهم حسين جميل والجواهري وعلي الوردي ومجيد خدوري وعبد الرزاق الحسني وآخرون، جميعهم يؤكدون على استهتار سلطات العهد الملكي وخاصة نوري السعيد وعبد الإله، بالديمقراطية وانتهاكهما للدستور والبرلمان وتزييف الانتخابات، واستخفافهما بالأحزاب السياسية والجماهير الشعبية. وبهذا الخصوص نعود إلى الدكتور علي الوردي فيقول: "إن جلاوزة العراق، ومن لف لفهم من المتزلفين وأنصاف المتعلمين ينظرون إلى الشعب الفقير نظرة ملؤها الاحتقار والاستصغار. ولعلهم لا يشعرون بهذا الاحتقار الذي يكنّونه لأبناء الشعب، إذ هو كامن أغوار نفوسهم، اللاشعور من أنفسهم، فهم ينساقون به وقد لا يعرفون مأتاه أحياناً."[7).
كما ويصف الجواهري وضع البرلمان آنذاك وكان نائباً فيه فيقول: لقد وقف نوري السعيد ذات يوم وقد ضاق صدره من هذا المعارض أو ذاك ليقول بالحرف الواحد: " هل بالإمكان أناشدكم الله، أن يخرج أحدنا مهما كانت منزلته في البلاد، ومهما كانت خدماته في الدولة، ما لم تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا أراهن كل شخص يدعي بمركزه ووطنيته، فليستقيل الآن ويخرج، ونعيد الانتخاب، ولا ندخله في قائمة الحكومة، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة الذي وراءه ما وراءه من المؤيدين يستطيع أن يخرج نائباً" .[8] . وأكد هذه الرواية كل من حسين جميل ومجيد خدوري في مؤلفاتهما. ويضيف الجواهري: "… هكذا كانت الأوضاع في العراق وهكذا كانت الديمقراطية. ولا شك إن أوضاعاً كهذه لا بد أن تخلق حالة من الكبت الجماهيري الذي يبحث عن مفجر"[9].
حرية المعارضة السياسية
لم تكن المعارضة السياسية حرة في العهد الملكي كما يدعي البعض في محاولة منهم لتأهيل العهد الملكي وتسويقه. ففي العهد الملكي كانت أحزاب المعارضة محظوراً عليها النشاط العلني وخاصة الحزب الشيوعي، الذي تم سجن وتعذيب أعضائه وإعدام عدد من قادته بسبب المعتقد السياسي. وقد سنت السلطة قانوناً يمنع به نشاط الحزب. واتخذت تهمة الشيوعية ذريعة وسيفاً مسلطاً على رقاب الأحزاب الديمقراطية وحتى القومية وضد كل من يتجرأ في إعلان معارضته للسلطة. ولم يسلم من السجن والاضطهاد في العهد الملكي حتى القوميون والديمقراطيون الليبراليون مثل كامل الجادرجي وآخرون. كما تم إسقاط الجنسية العراقية عن مناضلين عراقيين من جميع أحزاب المعارضة بمن فيهم القوميين بسبب معارضتهم للسلطة. ويقول مجيد خدوري في هذا الخصوص: "لقد تم القضاء على حرية التعبير، فأُسكِتَ السياسيون والكتاب والمواطنون الواعون بإجراءات تعسفية لم يسبق لها مثيل، وغصت السجون ومعسكرات الإعتقال بأناس مختلفي الإتجاهات .. من شيوعيين إلى ليبراليين إلى اشتراكيين إلى ناصريين إلى كرد قوميين إلى ساخطين على الوضع بصورة عامة ووضع جانب منهم تحت الرقابة بإبعادهم عن مسقط رأسهم وشمل القمع كل قطاع.. "[10]
القمع والعنف السياسي
لم تكن هناك حرية التظاهر أو الاحتجاج ضد السلطة. وقد قمعت مظاهرات سلمية قامت بها الجماهير احتجاًجاً على بعض إجراءات السلطة أو المعاهدات الجائرة المخلة بالسيادة الوطنية، حيث قمعت بشراسة وثبة كانون الثاني 1948، وانتفاضة 1952 وانتفاضة 1956 بالحديد والنار وإعلان الأحكام العرفية وزج الوطنيين بالسجون. كذلك أغرقت السلطة الملكية إضرابات عمال النفط في كركوك (مجزرة كاورباغي) 1946 وفي حديثة 1947، وفي البصرة 1953 بدماء العمال. وأقيمت المذابح للسجناء السياسيين العزل من السلاح في بغداد والكوت في حمامات دم فظيعة، كما حصل ذلك لانتفاضة فلاحي آل أزيرج ودزه ئي والديوانية وغيرها. وإعدام قيادة الحزب الشيوعي عام 1949.
ومن هنا نعرف أن العهد الملكي- السعيدي هو الذي بدأ باستخدام العنف السياسي ضد المعارضة، وضرب الجماهير واصبح العنف السياسي الدموي عرفاً وتقليداً في السياسة العراقية لدى الحكومات اللاحقة في العهد الجمهوري.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :