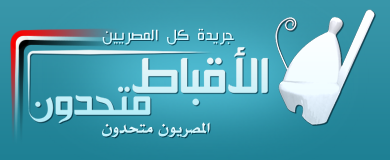مصر المنكوبة في رؤسائها
بقلم: القس أشرف شوق
تحت دعاوى دينيّة يخرج كثير من المسيحيين المصريين اليوم عن الخط العام للثورة المصريّة، وينظرون إلى الرئيس السابق (أو المخلوع حسب التوجه السياسي للمتكلم) على أنه رئيس مظلوم من شعبه, فبعد ثلاثين عام من "خدمة" الوطن، في أهم وأخطر المواقع كرئيس للبلاد، وبعد ستين عاما قضاها في العمل العام، يخرج "السيد الرئيس" اليوم من الحكم مخلوعًا وكمغضوب عليه, تلاصقه لعنات شعبه وتُرفع بسببه الدعوات الى الله العلي القدير أن يصلح ما سبق أن أفسده "الدهر".
لكن الحقيقة التي لا يشوبها شك هي أن كل مسؤول، مهما علا شأنه، هو بالأساس "موظف عام". وكل موظف عام لابد أن يحاسَب على أدائه خلال عمله, فالمحاسبيّة هي إحدى أهم الأسس التي يقوم عليها العمل العام. ولأن كل امتياز يقابلة مسئووليّة, ومادام الانسان قد قبل أن يعمل في العمل العام، فلابد من أن يخضع للمحاسبة طبقا لحجم اختصاصاته لكى تكون كل أمور الرعيّة فى شفافيّة أمام الرأى العام.
وبنظرة إلى الماضي يتأكد لنا أن المصريين لم يكونوا أبدًا محظوظين في رؤسائهم؛ فلقد نظر رؤساء مصر إلى الوطن نظرة تباينت بين رئيس ورئيس، ورغم اختلاف نظراتهم فقد كانت كلها نظرات خاطئة –في وجهة نظري. فاذا استثنينا الرئيس الأول محمد نجيب الذي حكم مصر لوقت قصير، ولفترة مؤقتة، فإن عبد الناصر (1956-1970) نظر إلى مصر على أنها زعيمة الأمة العربيّة (وهذه حقيقة كبرى) التي لابد لها أن تتوحد تحت رايتها الأمة العربية كلها (وتلك الكذبة الأكبر). إن مصر عبد الناصر هي الزعيمة والشقيقة الكبرى المسؤولة عن "أخواتها القُصَّر"، لذا فمصر متى مرضت بالانفلوانزا فإن الوطن العربي كله لابد أن يعطس. لقد كانت طموحات عبد الناصر كبيرة جدًا تجاوزت الحدود الجغرافيّة حتى وصلت إلى الخليج العربي والمحيط الأطلنطي، وما تجربة الوحدة المصريّة السوريّة عام 1958 إلا بروفة لما كان يحلم به عبد الناصر، الذى صدق أحلامه وحلا له التفكير في القوميّة العربيّة على أساس أنها لا بد أن تكون حلم كل عربي. فماذا كانت النتيجة؟ لقد انهارت هذه الأحلام عندما تحطمت سفينة العرب على صخرة حرب الأيام الست (1967)، وأفاق العرب على كابوس مزعج، ومرارة هزيمة نكراء عندما احتلت اسرائيل أرض الفيروز فى مصر وجزء من هضبة الجولان السوريّة.
أما الرئيس السادات, "بطل الحرب والسلام" الذي خاطر باتخاذ قرار الحرب ضد إسرائيل عام 1973 فحقَّق الانتصار العربي الوحيد عليها فى حرب "الساعات الست" فقد نظر إلى مصر على أنها "القريّة". لقد اختزل مصر العظيمة كلها في مجرد قريّة "ميت أبو الكوم". هكذا كانت مصر بالنسبة للرئيس. كان يحلو لأنور السادات أن ينظر إلى نفسه على أنه "كبير" العائلة المصريّة أو "العمدة" الذي يسعد بالاحتفال بعيد ميلاده مع أهله وذويه حول مائدة فلاحي من "البط والفراخ والعسل والقشدة". وهكذا اُختزلت مصر العظيمة، من دولة كبرى بالمنطقة العربيّة والشرق الأوسط كله إلى قريّة صغيرة، ومن "وطن" يتسع للجميع إلى مجرد "قعدة بلدي" لرئيس الجمهوريّة وأسرته وحاشيته. كان كل شىء ينتهي ب "ياء" المتكلم لدى السادات فكان يقول: "بلادى... جيشي.... أولادي.... إلخ" وهكذا يورد "محمد حسنين هيكل" في كتابه "خريف الغضب" عدة صفحات عن الآثار الفرعونيّة الأصليّة التي أهداها الرئيس السادات إلى قادة وزعماء العالم، تكرمًا من مصر على ضيوفها، الذين بدورهم أهدوا "رئيس مصر" ما لم يدخل –بالطبع- في خزانة الدولة، بل في جيبه الخاص! وهكذا حدث التحول الأول في النظرة إلى مصر؛ من نظرة تعتبرها أكبر من مجرد دولة عند عبد الناصر إلى مجرد قرية من وجهة نظر السادات.
ثم حدث تحولٌ آخر كبيرعندما جاء "مبارك" إلى الحكم. إن مبارك اختزل مصر غايّة الاختزال، فنظر إلى الوطن الكبير على أنه مجرد "عزبة", يوزَّع منها ما يشاء على الأبناء والأصدقاء والأقارب والحاشيّة والبطانة، بل حتى أعداء الوطن كان لهم نصيبهم من الكعكة، ولقد سمعنا ورأينا أن المفاوضات لمحاولة رفع أسعار الغاز المصدَّر إلى إسرائيل لا زالت مستمرة!
يؤسفني القول إن مصر العظيمة قد تدنت فى عهد هؤلاء "العسكر" إلى أسفل السافلين من الدرك الأسفل، فمقارنة بسيطة بين مصر وكوريا الجنوبيّة تكشف بفجاجة هذا التدهور الرهيب، ففي سنة 1953 انتهت الحرب الكوريّة التى أسفرت عن انقسام الكوريتيْن إلى شماليّة وجنوبيّة، وكانت كل من الدولتيْن قد تدهورت الى أبعد حد, بل لقد صارت كل منهما في عداد الأمم الميتة! فى ذلك الوقت كانت مصر قد خرجت لتوها من تحت نير الاحتلال الإنجليزي إلى الحكم الوطني، وكان اقتصاد مصر قويًا.. وكانت انجلترا مدينة لمصر بكم كبير من الديون! وكانت مصر تتمتع بدرجة عالية من الديمقراطيّة ومن الحياة النيابيّة المتأصلة في المجتمع منذ الحقبة الليبراليّة، وكان البنيان الاجتماعي متماسكًا. باختصار كانت مصر متماسكة على كل الأصعدة, سياسيًا, واقتصاديًا, واجتماعيًا. أين الكوريتان الآن على الخريطة الدوليّة وأين مصر منهما؟! ياللمأساة!
إن النظرة المسيحيّة التي تعتمد المحبة هدفًا والغفران وسيلة لإظهار هذه المحبة لا تصلح مطلقًا للتعامل مع تقييم عمل أي رئيس، أو مسؤول، أو حتى موظف عام، فالموظف العام لا ينطبق عليه هذا القانون الإلهي عند تقييم أدائه، بل يجب أن يبذل جهده حتى "يرضى من جنده" وإذا قصَّر في أداء مسؤولياته فلابد أن يحاسَب بالعدالة والقانون.
لقد كان مبارك –طبقًا لدستور 1971- هو رئيس الجمهوريّة الذي له صلاحيّة تعيين رئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ويملك أن يعفيهم جميعًا من مناصبهم .. ثم كان بذاته رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة الشرطة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحكم بين السلطات عند التنازع... فكان يملك إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب عند التنازع بينهما، وكان يملك أن يعيِّن عدد من أعضاء مجلس الشعب وأن يعيّن ثلث أعضاء مجلس الشورى ....الخ وأمام هذه الصلاحيات المطلقة أطلق البعض على الرئيس المصرى لقب "الفرعون" أو "ابن الاله". وبالحقيقة أمام هذه الصلاحيات المطلقة فإن الرئيس هو المسؤول الأول والحقيقي عن كل ما حدث لمصر من فساد سياسي، وتجريف اقتصادي، وفشل اجتماعي وخراب في مجالات التعليم والصحة وغيرها ...وعلى كل المستويات. وحتى في حالة تقصير أو إهمال أو استبداد أو فساد أي وزير أو مسؤول آخر فإن مبارك يعد شريكًا أساسيًا في هذا التقصير أو الإهمال أو الفساد استنادا إلى حقيقة أنه هو المسؤول عن تعيين أعوانه. وأي ادعاء بغير ذلك هو مجرد محاولة يائسة لذر للرماد في العيون، وخداع للبسطاء من الناس، وتسخير للدين لخدمة الساسة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا.
وبعد, فإن من يقيس السياسة وأمورها بالمقاييس الروحيّة المسيحيّة هو كمن يقيس المسافة بين الأرض والشمس بالسنتيمتر، وهو ما لا يمكن أن يصلح أو يستقيم... فارحمونا أيها المتدينون كثيرًا...واتركونا في أرضياتنا، نعقلها ونقدِّرها بعيدًا عن الدين والروحنة.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :