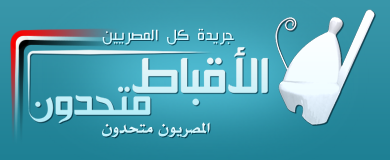29 يوليو والردة الحضارية
بقلم: ماجد سوس
الزمان، التاسع والعشرين من يوليو 2011. المكان، ميدان "التحرير" ملهم ومفجِّر بركان ثورة شباب "مصر"، ومصدر قوة وإردة شعب مستعبد أراد تكسير وتحطيم نير العبودية المريرة التي حاقت به على مدى عقود طويلة مظلمة. الحدث، مرعب ومخيف. محاولة لسرقة ثورة شعب وإحتلال بلده لإقامة دولة "مصرستان" على غرار "أفغانستان" و"باكستان". الأعلام التي ارتفعت، أعلام سوداء، وهي أعلام تنظيم القاعدة الإرهابية، تجاورها أعلام الدولة الوهابية "المملكة السعودية"، راعية الإخوان وجماعات التشدُّد والتطرُّف والصرف عليهم منذ عقود كثيرة حتى الآن. ملابس المحتلين، الزي الأفغاني من جلباب قصير وشبشب ولحية طويلة بلا شارب، مع وجه عابس مكفهر، وصراخ ممتليء بوعيد وتهديد.
الهدف، هو السعي لتحويل "مصر" إلى دولة دينية إسلامية. والدولة الدينية مشروع فاشل على مدى كل العصور، فلا اليهود نجحوا فيها ولا المسيحيون، أما المسلمون فقد كانت أسوأ العصور دموية هي عندما كانت الدولة فيها دينية، ولم يصلح من حال "مصر" سوى عندما أتى "محمد علي باشا" وحوَّل "مصر" إلى دولة مدنية عصرية، فشهد له التاريخ، والذي أثبت أنه كلما دخل الدين من باب السياسة هربت الحضارة من النافذة.
وحتى لا نضع رؤوسنا في التراب كالنعام؛ لذا فلنتكلم بكل صراحة. وأقول هذا لكل من يربط سماحة الأديان بالسياسة، فلم تعرف البشرية أية تسامح ديني عندما اختلط الدين بالسياسة، ولا تستقيم تلك الإقصوصات المتناثرة التي يرددها أصحاب الديانات للتدليل على سماحة الدين في المجال السياسي. فوقائع التاريخ ترد على هذا الزيف. وكما يقول قدس أبونا "أنطونيوس الأنطوني" في كتابه "وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر"– الجزء الثالث-: "..إن تاريخ الدول الدينية حافل بالتعصب الديني واضطهاد المخالفين في العقيدة، لا يستثنى من ذلك اليهود وموقفهم من المسيح معروف، ولا المسيحيون وموقفهم من المسلمين في الأندلس واضح، ولا المسلمون ومواقفهم من غير المسلمين".
والحقيقة عزيزي القاريء، إن التاريخ مليء بالأحداث الدامية التي اختلط فيها الدين بالسياسة، فأهدرت حقوق الأقلية وإن تفاوتت. فإن سلمنا بأن الأقباط كانوا أفضل حالًا في عهد "عمرو بن العاص" عندما أعاد لهم البابا "بنيامين"، فإن العصور التالية كانت مرارًا على الأقباط، سواء في عهد الأمويين أو العباسيين، والتي ازداد فيها اضطهاد الأقباط. فعلى سبيل المثال، في عهد المتوكل نجم الدولة العباسية، تحوَّل التعصب إلى إذلال مرير للأقباط، فقد بالغ في الجزية حتى أسلم الكثيرون خوفًا من القتل، وتم فرض زي مميز للأقباط، وإلباس نسائهم ملابس العاهرات، ونحت على أبوابهم صور القردة، ومنعهم من ركوب الخيل. حتى جاءت الدولة الفاطمية، وفيها ظهر "الحاكم بأمر الله" الذي أذاق الأقباط المرار أيضًا. ونفس الشيء حدث لهم في عهد "الظاهر بيبرس" في عهد المماليك، والسلطان "عبد الحميد الأول" في عهد العثمانيين، ثم الوالي "عباس الأول" من أسرة "محمد علي" الذي في عهده ذاق الأقباط الكثير والكثير من الظلم والتهميش.
وفي التاريخ المعاصر، لا نستطيع أن ننسى ما فعله "السادات" من زرع الجماعات الإسلامية المتشدِّدة داخل الجامعات والنقابات، وهو الأمر الذي نجني ثماره الآن. فما شباب 29 يوليو سوى صنيعة "السادات"، الوقود الذي أشعل به "مصر" كلها، على أنه أول من احترق بهذه النيران وقُتِل بيد صنيعه. أما "مبارك" فلم يهتم بوأد الفتنة الطائفية في مهدها، وراح يركِّز على قمع الإسلاميين حفاظًا على كرسيه فقط، وأطلق لهم العنان ليفعلوا كما يشاءون في الأقباط.
وأرجو أن يتقبل مني إخوتي الأحباء المسلمين هذه الرؤيا التي أطرحها بكل شفافية. فالإسلام دين وليس دولة، والدعوة لجعل "مصر" دولة دينية هي بالفعل ردة حضارية، فالولاء سيكون للدين حتى في الأمور السياسية والقانونية، وسيختفي الولاء للوطن والأرض والقومية، وستطفو على السطح كل مظاهر التعصب والتمييز الديني.
ودعونا نأخذ مثالًا مهمًا، وهو ولاية الذمي- غير المسلم- على المسلم، فهي غير جائزة شرعًا. فسيصير هذا ذريعة لجعل كل وظائف الدولة، ولا سيما الوظائف العليا أو القيادية أو الحكومية- وبالطبع القضاء، والجيش، والشرطة، والجامعات، وغيرها- كلها تخضع لنفس المبدأ المغلوط. وأقول مغلوط لأنه مبدأ يصلح في شئون الدين فقط، ولكن في شئون الدنيا تبقى الأفضلية للكفاءة العلمية، مع الخبرة في إطار العدالة بالطبع، دون النظر إلى جنس أو عقيدة أو لون.
هناك أيضًا شهادة الشهود، والتي ترفض فيها الشريعة الإسلامية شهادة غير المسلم، وهو أمر سيحدث معه إخلال بالعدالة والوقوع في هوة الانفلات الأمني. فيكفي أن يقتل شخص آخر ويشاهده قبطي والذي لا تؤخذ بشهادته.. والأمر المحزن حقًا، هو وجود المادة الثانية من الدستور المصري، التي تحدِّد الشريعة الإسلامية فقط كمصدر تشريعي وكمرجعية وحيدة، الأمر الذي تولد منه ظواهر مخيفة انتشرت بين القضاة – مع الأسف– في الوقت الحالي، فترفض شهادة القبطي حتى في المسائل المدنية، وبات من السهل عليك أن تجد مسيحيًا لا يستطيع أن يطرد مستأجرًا من ملكه بسبب عدم عثوره على شاهد مسلم، وهو واقع عايشته بنفسي كمحامي مصري.
هذا يا أحبائي بخلاف قطع يد السارق، ورجم الزاني، والجلد– على أتفه الأمور- وهي الأمور التي لا تتوافق مع الدولة العصرية أو حقوق الإنسان، بل ويرفضه كثير من علماء المسلمين المستنيرين، والذين أكَّدوا أن الحدود لم تطبَّق في معظم الدول الإسلامية منذ نشأة الإسلام.
إن ما حدث في ميدان "التحرير" يوم الجمعة 29 يوليو، يُعد بمثابة ردة حضارية وعودة بالمجتمع المدني إلى عصور الظلام، وصار الماضي القريب أفضل حالًا من هذا الزمان. فلنرجع بالذاكرة إلى ما قبل ثورة 1919، عندما تبوأ "بطرس باشا غالي" منصب رئيس وزراء "مصر"، وعندما قامت ثورة مؤكِّدة على وحدة "مصر" الوطنية، تثبت للجميع أن الوطنية هي الحل لهذا البلد، حتى أن الزعيم الخالد "سعد زغلول" كان يعهد برئاسة البرلمان إلى "ويصا واصف"، فكان الوفديون ينتخبونه دون النظر لديانته.
المشكلة الآن تكمن في استجابة جزئية من الرأي العام لتلك المطالب المُضلِلة الممزوجة بالشعارات الدينية الزائفة الرنانة، الأمر الذي يتطلَّب منا وقفة جادة- مسلمين ومسيحيين- لنعلي فكرة القومية والوطنية، ونفضح المخطط الوهابي الرجعي لتدمير "مصر" والعودة بها إلى الوراء لعهود الظلام والاستعباد والإستبداد. كفانا تخلُّف عن ركب الحضارة، فنحن نملك الآن الكثير من الأدوات الإعلامية التي لابد أن نطوِّعها لنشر الوعي السياسي وبث روح المواطنة وتفنيد الأفكار الظلامية ودحضها. وهنا، لابد أن أهيب بالقنوات الفضائية وأصحاب الجرائد والمواقع الإلكترونية إلى عدم السعي وراء أهداف أخرى تعمل على تفتيت وحدة الصف والسعي وراء المادة، تاركين الوزنة العظيمة التي أعطاها لكم الله من أجل مساعدة الوطن وحمايته من تلك الردة الحضارية التي تحيق به، والتي قد تحرق الجميع معها.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :