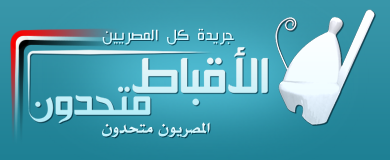كيف نمحو العار؟
مهما تكن الملابسات، وأيا كانت التبريرات، فإنه عار أن يتواصل ضرب جثة إنسان بعد دهسها تحت عجلات مدرعة عسكرية، وأن يستمر ذلك الضرب الذى حاولت منعه عن الجسد المدهوس بنت كان هذا المقتول خطيبها الحى منذ لحظة، وكان يقول لها وهو يمسك يدها قبل أن يضيع منها: «ما تسبينيش» ربما لاستشعاره بقرب موته، وعلى الأرجح لأنه كان يصر أن يحميها، ويخرج بها من ساحة الحرب والدهس الغريبة تلك!
البنت التى انكفأت على جثة خطيبها تكلمه لعله يجيبها ويقول لها إنه معها وأنه حى لا يزال، رفعت رأسها تكلم الجلادين الذين لم يتوقفوا عن توجيه الضربات المسعورة للقتيل، والتى كانت تتلقى منها الكثير وهى محنية عليه، رجتهم أن يتوقفوا وأن يبتعدوا عنه فهو لم يعد يتحرك ولا يتكلم، ولم تستطع أبدا أن تقول أو تصدق أنه مات، وجاءتها الإجابة شتيمة فاحشة وعصفا أقبح ما يكون: «اسكتى يا كافرة»!
حدث هذا فى ليلة ماسبيرو السوداء، البنت اسمها فيفيان مجدى، وخطيبها القتيل دهسا اسمه مايكل سعد، أحد شباب الثورة الذين سبقت إصابتهم برصاصة من أمن مبارك وحبيب العادلى فى جمعة الغضب، تلك الجمعة المجيدة التى رسمت ببسالة الشباب، مسلمين ومسيحيين، منعطفا باهرا انتهى بالإطاحة بحكم أحط عصابة حكمت مصر. أما المدرعة التى دهست مايكل فهى للجيش المصرى، والجلاد الذى كان يضرب قتيلا ويستبيح التنكيل بفتاة كانت تحاول حماية ما تبقى من خطيبها، ويسبها ويكفرها، فقد كان للأسف: جندى مصرى!
أنا مسلم أعتز بإسلامى وأحسبه عند الله حسنا لأنه إسلام قناعة عقلية وإشراقُ روحى وتسبيح تأمل لا ينقطع فى عظمة ملكوت الله وإعجاز خلقه وتدبير مخلوقاته. كما أننى مصرى مقتنع بالدور العظيم لجيش مصر الوطنى ومجلس قيادته الأعلى فى حماية ثورتنا الأخيرة النبيلة والحفاظ على كيان «الدولة» بإفشال سيناريو الفوضى الشاملة التى كانت مُدبَّرة بعد سقوط نظام عصابة الدناءة والخسة المنزاحة. ولهذا أشعر بأن ما جرى فى موقعة ماسبيرو، والذى تختزله عندى مأساة مايكل وفيفيان، إنما كان عارا ينتهك الفضيلة الدينية ويحط بالسمو الوطنى والحس الإنسانى لأى مصرى، ومن ثم يستوجب المحو حتما، وإلا كان علينا أن ننتظر الأحط والأسوأ.
العار، أى عار، ابتداء من العار الفردى والشخصى وصولا إلى العار القومى والعام، ليس مجرد لحظة الوقوع فى ارتكاب المحظور أو المدنس أو الحرام الذى منه قطعا «ضرب الميت»، بل هو كما سقوط أى شىء، له مسار فيه نقطة بدء ونقطة انتهاء بينهما مسافة وزمن وقوة دفع وتسارع، هكذا تعلمنا قوانين الميكانيكا وتخبرنا الحياة: استدراج وإغواء، فانحدار واستمرار فى الانحدار، ثم وقوع وارتطام فى نهاية المطاف. وهى حكاية الفتنة الطائفية التى تبدأ بإغواء التعصب الدينى، وتستمر بدفع وسوسة شياطين التطرف وتغذية بذور الاستعداد للجنوح، دعم مادى للمُستقطَبين ممن تسحقهم شئون دنيا ضيقتها عليهم أنظمة حكم فاسدة، ودعم معنوى للخروج من ذلة الانسحاق بالانضمام إلى قوة العُصبة، التى لا تخرج فى سيكولوجيتها عن سيكولوجية العصابة!
وكما أى عصابة، يعزز منتسبوها شعورهم بالنقص الفردى عندما يصيرون جمعا، وتعزز العصابة ثقة منتسبيها فى قوتها باختبار هذه القوة فى فعل الصدام مع عصابة أخرى، مُختلقة على الأغلب، ومُبالَغا فى تبشيعها، حتى تتمكن الكراهية من النفوس، فهى الدافع الجامح والجامع بين أفراد كل تكوين عصابى فى مواجهة ما يعتبره هذا التكوين خصما له.
هكذا تشيع الفتنة، تحت رعاية سرية من أنظمة فاسدة، وجهات مريبة، وبإشراف دعاة جانحى النفوس، نهمين للزعامة أو للفلوس أو كليهما معا. فتنة كالنار تحت الرماد، تكمن متحينة لحظة التأجج، فتنتشر ألسنتها لتلحس العقول وتحرق الضمائر، وتُسقِط حتى أكثر الناس براءة فى مصائد عار يتجاوز إنسانية الإنسان إلى وحشية ما دون الحيوان، ولا يتأتى ذلك إلا على قاعدة التكفير، فالكافر مستباح عند من يحسب نفسه أفضل إيمانا، بالرغم من كون هذا الحساب ليس شأنا بشريا بل تقدير إلهى لا مُنازعة فيه لمخلوق.
هذه الاستباحة على قاعدة التكفير تجيز ما لا يجوز فى العرف البشرى، بل حتى الحيوانى، فالحيوان، عدا القوارض وبعض السنوريات فى ظروف نادرة، لا يأكل لحم بنى جنسه إلا بتلف فى المخ يجعله لا يتعرف على أخيه فى النوع، فيحسبه مفترسا يقاتله، أو فريسة يأكلها. والجندى البائس الذى صرخ فى فيفيان المنحنية على جسد خطيبها المدهوس يكفرها، إنما كان يبوح بالقاعدة التى بررت له ذلك الإجرام الحرام.. ضرب الميت!
من الذى وسوس لهذا الجندى البسيط بهذه الوسيلة الشيطانية ليقع فى المحظور ويرتكب العار؟ أعتقد أنها أدخنة الاحتقان الطائفى المسكوت عنه، والمُتغاضَى عن عديد جرائمه ومجرميه، من حرق الكنائس وتهديمها إلى الاستيلاء على منابر المساجد بالقوة، فتنة مدسوسة الجمرات تحت تراب وطننا الذى لم يكن أهله إلا وسطيين دائما، ولا يزال غالبيتهم كذلك، سواء مسلمين كانوا أو مسيحيين. ولو لجأنا لوسيلة موضوعية لا تتخذ من غوغائية الحشد ولا علو الصوت أو عدوانية الاندفاع مقياسا، لثبت لنا أن كل أطياف التطرف لا تمثل إلا هامشا ضئيلا مقارنة بمتن الأغلبية الكاسحة من المصريين!
رحلة العار بدايتها بعيدة، من زمن لعب أنظمة الاستبداد والفساد على وتر الطائفية لإلهاء الأمة المنهوبة والمنكوبة فى معارك جانبية بين بنيها تصرف الأنظار عمن يقتلهم جميعا وإن ببطء وخبث ودناءة. لكن عار الموقعة الأخيرة فى ماسبيرو ينبغى اعتباره نقطة نهاية، يليها انقطاع حاسم عن كل ما سبق، وبدءُ جديد لمحو ما ارتُكب فى حقنا جميعا، ووضْع متاريس حاسمة وحاكمة لعدم تكراره، وتغليظ عقوبة مقارفته على أى نحو، ومن ذلك:
ينبغى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخرج رئيسه أو أحد رجاله ليعتذر عما ارتُكب فى ماسبيرو والذى لا يمكن تبريره بأى ضغوط واستفزازات نعرف أن بعضها حقيقى، وأن تتم إقالة محافظ أسوان الذى أجج نار الطائفية بتصريحه الغشوم عن أن الأقباط ارتكبوا خطأ وصححه المسلمون! لأنه بذلك استباح هيبة الدولة لصالح غوغائية طائفية بينما هو رجل يمثل الدولة، أو هكذا يُفترض، وهذه ليست أولى كبائره، فله موقعة قريبة مع النوبيين أخرجتهم عن معهود طباعهم التى هى من أرق وأجمل طباع المصريين برغم طول صبرهم على إهدار حقهم البديهى فى التعويض عما ضحوا به لننعم جميعا بكثير من الأمن المائى بعد بناء السد العالى. ولا أظن أن العثور على لواء أركان حرب آخر يشغل ذلك الموقع، الحساس من منظور الأمن القومى، بعسير على مؤسستنا العسكرية الوطنية العريقة.
أما وزارة شرف ووعوده المجانية وغياب رؤيته السياسية ورخاوة أدائه المنعكس على أركان الوزارة معظمها، فقد باتت عبئا على مصر كلها، وقد صرنا فى حاجة ماسة لحكومة إنقاذ يقودها صاحب رؤية وحسم وجداول عمل واضحة على رأسها قضية الأمن التى ينبغى أن تكون مشروع مصر القومى الآن، بمقترحات ثورية فى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على غرار تلك التى انتهجها الجيش فى أعقاب انكسار هزيمة يونيو. ولا بأس من إعطاء وزارة الإنقاذ هذه مدى زمنيا منطقيا لهكذا مهمة كبرى، حتى لو تأخرت «لعبة» الانتخابات العجيبة تلك وما يتبعها. وبمواكبة ذلك لابد من الشروع فى بناء دستور وطنى جامع لدولة مدنية ديمقراطية لا يتغول فيها أحد على أحد مهما كانت أغلبيته أو ادعاء الأغلبية. وصار من حتميات الإنقاذ صدور قانون يمنع التمييز بين المصريين على أسس دينية، ويُعاقب بأشد الجزاء من لا يحترم دين غيره أو يعتدى عليه ماديا أو معنويا.
إن العار الماثل فى حالة استمرار ضرب جسد أحد قتلى موقعة ماسبيرو، وجَلد وتكفير خطيبته التى انحنت عليه تمنع عنه المزيد من الأذى، لا يمكن أن يغسله إلا اعتذار شجاع، وعمل أشجع لإنقاذ مصر الدولة والأمة من فتنة مدبرة بليل وإن ارتدت ثيابا ناصعة البياض فى النهار، ومن هنا يتوجب على كل من لديه القدرة من كل ألوان الأطياف السياسية التى تتكالب على قصعة الانتخابات المعيبة الآن، أن يضحى النبلاء والشجعان فيها للمساهمة فى تكوين حكومة إنقاذ هى أهم الآن وغدا من كل انتخابات ومن أى برلمان، فما نعيشه لا يوحى بأدنى طمأنينة لما يمكن أن تسفر عنه أى انتخابات أو يتشكل بموجبه أى برلمان.
وتبقى القوات المسلحة، برغم كل الأسى مما وقع فى ماسبيرو، النواة الصلبة الوحيدة التى يتجمع حولها تماسك «الدولة» المؤسسى، التى لو انفرط عقده لانفرط الحاضر والمستقبل. كما تبقى فى قصة مايكل وفيفيان لمحة أليمة، فأم هذا الشهيد كما أخبرتنا التغطيات الإعلامية، سيدة مسنة ومريضة كان مايكل عائلها الوحيد، فليس أقل من أن تختصها القوات المسلحة برعاية اجتماعية وصحية تغسل أطراف عارٍ لم يكن فى حسبان ولا سياق ولا تاريخ جيش مصر الوطنى.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :