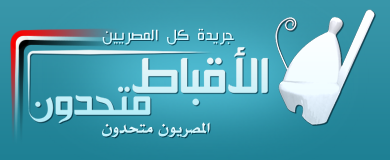- منسقو الثورة المصرية بالخارج لـ"وطن ف المهجر": دخلنا الكنائس والجوامع لحشد المصريين والأعداد تتزايد وسنعقد مؤتمرًا مع نشطاء الداخل لدعمنا
- من جيفارا الى مينا دانيال
- بالفيديو... عاجل حرق وتكسير منازل الأقباط بالرحمانية بنجع حمادى
- "الأقباط متحدون" تنشر تفاصيل اختطاف طالبة "منهري" القبطية وأنباء عن إيداعها دار تابع لائتلاف المسلمات الجدد
- ما بين النتيجة وبينى
مثاليات الديمقراطية والخلفيات السياسية والحضارية للمجتمع المصري
بقلم: مينا بباوي
كنت ممن استقبلوا بريبة شديدة تصريحات السيد/ عمر سليمان لقناة البي بي سي في الأيام الأولى لـ "الثورة" والتي قال فيها ما معناه أن الشعب المصري ليس مستعداً للديمقراطية. غير أن مدعاة ريبتي من هذا التصريح لم يكن اختلافاً مع مضمونه بقدر خشيتي من أن يكون ذلك تمهيداً لتنفيذ ما رأيت فيه وقتها (وربما مازلت أرى) إنقلاباً مبيتاً لجناح متشدد في السلطة على جناح الإصلاح والتجديد الذي تزعمه فريق جمال مبارك في الخمس سنوات الأخيرة. كنت أخشى ما قد يكون وراء هذه التصريحات من تمرير لدولة ناصرية انقلب من تربوا في مدرستها العتيقة على فريق نجح تدريجياً في إزاحتهم عن سدة المشهد السياسي وجاء بأفكار إصلاحية كان ولاشك أول من دفع ثمنها حين قامت احتجاجات ما يسمى بـ"الثورة".
وبصرف النظر عن صدق تحليلي من عدمه، إلا أن موقفي من قضية الديمقراطية في مصر لم يتغير كثيراً قبل أو بعد "الثورة". فأنا ولأسباب سوف أستعرض ما يحضرني منها في هذا المقال، ممن يروا أن الشعب المصري بالفعل ليس مستعداً للديمقراطية.
فالديمقراطية كلمة لا تنطوي على مفهوم واحد للحكم إذ أن ما تعرفه أغلب دول العالم الغربي منها هي ما يعرف بالديمقراطية النيابية أي تلك التي يقول فيها الشعب كلمته في الحكم من خلال نواب ينتخبهم فيما يعرف بالمجالس البرلمانية.
غير أن الديمقراطية النيابية المأخوذ بها في الغرب لا تعكس الديمقراطية في مفهومها الأصلي والتي كانت في منشأها أقرب لما يعرف اليوم في الأدبيات السياسية بالديمقراطية المباشرة، أي تلك التي يشارك فيها المواطنون في الحكم مباشرة دون وساطة نيابية. وهذا الشكل من أشكال الديمقراطية المباشرة مازال في حدود علمي معمولاً به في دولة واحدة على الأقل من الدول الاسكندنافية (السويد على ما أظن، مع الاعتذار لقارئي عن عدم التحقق ـ لضيق الوقت ـ من الدولة وشكل الديمقراطية المباشرة الذي تطبقه).
إذا كانت الديمقراطية النيابية هي التي انتصرت في نهاية المطاف في أغلب دول العالم التي أخذت بفكرة الديمقراطية، فليس ذلك في ظني وليد صدفة بقدر ما يعبر عما تحمله الديمقراطية في مفهومها من مخاطر وقصور لم يكن من الممكن معه أن تأخذ بها الدول العظمى دون أن تضع نفسها في مهب ترك أمور الحكم للعامة وغير المؤهلين سياسياً وثقافياً لقول كلمتهم في الشأن العام فيصبح القرار السياسي رهن أهواء وعصبيات وجهل بدقائق وشئون لا يجب أن يفتي فيها بالرأي والقرار إلا من يعلم. وبالتالي كان لابد للأخذ بالديمقراطية من صمامات أمان تحد من جموحها وتضمن أن تظل صناعة القرار في يد من يقدر خلفياته وتبعاته.
لجأت الشعوب التي أخذت بالديمقراطية إلى حيل ناجعة (حتى الآن على الأقل) لتقليم أظافر الديمقراطية المطلقة بحيث تؤدي في نهاية المطاف إلى حصر تدخل العامة في شئون الحكم في أضيق الحدود وبقيود مباشرة وغير مباشرة كثيرة.
فالديمقراطية النيابية في حد ذاتها تقر ضمنياً بأن صنع القرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يترك للعامة التي بات حقها يقتصر على انتخاب من يمثلها في مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة وهي المؤسسة التشريعية. وصيغت قواعد وآليات الانتخاب من شروط ترشح وحملات انتخابية، إلى آخره، لتضمن وصول عناصر مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة السياسية لقول كلمتها نيابة عن العامة في شئون الحكم. وهذا هو أول صمام أمان استحدثته الديمقراطية النيابية لتقليم أظافر الفكرة الديمقراطية على إطلاقها.
إلا أن هذه المؤسسة التشريعية ذات الطابع النيابي ليست مؤسسة الحكم الوحيدة أولاً ولا هي ثانياً صاحبة اليد الطولى في صناعة القرار. فدورها يقتصر على صياغة التشريعات في خطوطها العريضة بينما يترك التطبيق والتنفيذ للسلطة التنفيذية فيما يعرف بـ"اللوائح التنفيذية" للقوانين، والتي تضع التصورات والإجراءات العملية لتطبيق ما شرعته المجالس النيابية. كما أن التجربة أثبتت أن أغلب مشاريع القوانين التي تعرض عليها تصاغ أصلاً من قبل السلطة التنفيذية ويقتصر دور المجالس النيابية على مناقشتها واقتراح تعديلات (غالباً طفيفة) عليها، والتصويت عليها بالإقرار أو الرفض.
والسلطة التنفيذية وإن جاء القائمين عليها في الديمقراطيات النيابية ممثلين للكتلة البرلمانية صاحبة الأغلبية، إلا أنها في مؤسساتها وآليات الالتحاق بها والترقي في درجاتها الإدارية تعتمد على معايير أساسها الكفاءة والخبرة وتميز الأداء لا على الانتخاب. وبالتالي فالسلطة التنفيذية وإن تغيرت قياداتها بتغير الأغلبيات النيابية لا تتغير آلياتها وكوادرها بنفس الشكل وعادة ما تتسم بالثبات والنخبوية التي تجعل منها الفاعل الرئيسي في صناعة القرار وإن خضعت في أداءها لرقابة المجالس النيابية.
ثم أن الديمقراطيات الغربية إذ وجدت هذا الصمام ليس كافياً، استحدثت النظام البرلماني ذو المجلسين، وهو ما عرفته مصر في صورة مجلس الشعب ومجلس الشورى. الأول يعبر عن قطاع أعرض من الجماهير بشروط ترشح وانتخاب وتجديد دوري لأعضائه أقل تشدداً من شروط الترشح والانتخاب والتجديد الدوري للأخير، حيث لا يتم تجديد أعضاء مجلس الشورى دفعة واحدة في نهاية كل دورة برلمانية، وإنما تقتصر الانتخابات على نسبة محدودة (الثلث عادة) من أعضاءه. وقصد من مجلس الشورى هذا أن يمثل صوت العقل ليكبح قدر الإمكان ما قد يصدر عن مجلس الشعب من شطحات من خلال مراجعته للقوانين وتعديلاتها التي يصوت عليها مجلس الشعب.
ولم يكن كل ما سبق كافياً على ما يبدو لضمان استقرار مؤسسات الدولة وحصر صناعة القرار في يد من يعرف ومن يعقل ومن يمتلك الخبرة اللازمة، فسنت الديمقراطيات الغربية فكرة الدستور التي جعلت منها عقداً اجتماعياً تصوغه نخبة رفيعة المستوى ليكون بمثابة الأساس الذي لا يمكن لأي من مؤسسات الدولة أن تحيد عنه حتى ولو كانت تعبر عن إرادة الشعب من خلال المجالس النيابية حيث لا يسمح لقانون أو لنص في قانون أن يخرج أو يخالف مبدأ دستورياً.
وكان الصمام الأخير إضافة لكل ما سبق من صمامات الأمان هو حصر تداول السلطة في حزبين أو ثلاثة على الأكثر من الأحزاب القائمة. فمعظم إن لم يكن كل ديمقراطيات الغرب لا تتداول فيها السلطة إلا بين حزبين رئيسيين (الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، الحزب الاشتراكي وحزب الـ UMP في فرنسا، العمال والمحافظين في انجلترا .. الخ.).
فقد نجحت النخب السياسية في هذه الدول على مدى عقود من خلال سيطرتها على المؤسسات الإعلامية والفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في حصر البدائل السياسية بين حزبين لا يختلفا عادة اختلافات جذرية في تصوراتهما عن مفاهيم الحكم والخطوط العريضة لسياسات الدولة، بل والأكثر من ذلك لا تختلف كوادرها ورموزها كثيراً من حيث خلفياتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية بعضها عن البعض. فهي تنتمي في قطاعاتها العريضة لنفس الطبقة الاجتماعية وتتخرج من نفس المعاهد والمؤسسات التعليمية والثقافية قبل أن تتوزع على حزبي الأغلبية دون أن تختلف في توجهاتها وثوابتها إلا قليلاً. وما عدا ذلك من الأحزاب يظل هامشياً قلما يصل إلى الحكم منفرداً وأقصى ما يطمح إليه هو الضغط أو المشاركة في ائتلاف مع هذا الحزب أو ذاك. وإن حدث ومثل أي من هذه الأحزاب الهامشية تهديداً حقيقياً بالوصول للحكم قامت القيامة في هذه الدول واستشعرت في ذلك كارثة تتهدد بقاءها واستقرارها مثلما هو الحال في فرنسا الآن على خلفية حصول حزب الجبهة الوطنية (وهو حزب يوصف بالقومية المتطرفة) على عدد كبير من مقاعد المحليات في الانتخابات الأخيرة ما أثار المخاوف من حصوله على تمثيل كبير في الانتخابات البرلمانية القادمة والمنافسة الشرسة على الرئاسة (كان ذلك قد حدث منذ بضعة سنوات في انتخابات الرئاسة قبل الأخيرة حين نجح جون ماري لوبان في أن يأتي متقدماً على ليونال جوسبان في انتخابات الرئاسة ليخوض الجولة الأخيرة أمام شيراك الذي عبئت وسائل الإعلام والتشكيلات الحزبية والسياسية الأخرى الرأي العام وراءه فكان أن فاز ـ في سابقة في تاريخ انتخابات الرئاسية الفرنسية ـ بنسبة بلغت 77 في المائة على ما أذكر لا لشيء إلا رفضاً لتولي قومي متطرف رئاسة الجمهورية).
كانت هذه الخلفية عن الديمقراطية نشأتها وممارستها في الغرب، هامة جداً في تفنيد الرأي القائل بأن الشعب المصري مستعد للديمقراطية، وأن علينا أن نمنحه الفرصة ونقبل بما تأتي به على أمل أن تنضج تجربته الديمقراطية مع السنين وينضج معها وعي وفهم الشعب المصري نفسه.
فلا أظن محللاً سياسياً موضوعياً يختلف معي في أن أكثر الديمقراطيات رسخواً وضرباً في عمق التاريخ لم تجد بداً من إيجاد آليات وصمامات أمان تضمن حكم النخبة المتعلمة، الواعية، الوسطية، المؤهلة سياسياً وتكنوقراطياً. وأن تحجيم دور العامة والجهلاء في حكم الدول هو مطلب مشروع بل وحتمي لاستقرارها وازدهارها ورقيها.
وتأسيساً على هذه المبادئ والمعطيات التاريخية، فإن قناعتي هي أن الشعب المصري ليس مؤهلاً للديمقراطية وإن حلا للبعض بمثالية أفلاطونية تصور ذلك. فالديمقراطيات الغربية الحديثة قد نشأت على خلفية حركة نهضة ثقافية وعلمية وفكرية استغرقت قرون من الحرب المعلنة على هيمنة الدين على الفكر وعلى الإبداع وعلى الدولة. وهي حركة تنوير قادتها نخبة من المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين صاحبتها ثورة علمية بنت عليها بقدر ما أسستها، وسرعان ما استجابت لها الشعوب مستلهمة أسس حضارة ضاربة بجذورها في تاريخها البعيد منذ عصر اليونان القديمة والإمبراطورية الرومانية.
كما أن الشعوب الغربية في ذلك كله لم تستورد حراك نهضتها بقدر ما صنعته وأفرزته ذاتياً في مراجعة تلقائية لقرون من الأفكار الظلامية ذات المرجعيات الدينية غط فيها الغرب في ثبات العصور الوسطى. وهذه الحقيقة فارقة وجوهرية في تحليل وتقرير مدى ملائمة الديمقراطية للحالة المصرية.
فالديمقراطية ليست هي من صنعت نهضة الحضارة الغربية (كما يتصور بعض المتحمسين للتجربة الديمقراطية في مصر) وإنما كانت هي نتاج هذه النهضة وأداة من أدوات استمرارها وضمانة لحرياتها ومنجزاتها إذ أن ظهورها جاء متأخراً زمنياً في رحلة التنوير التي بدأت بعصر النهضة. ومع كل ذلك، فقد شهد التاريخ أن الديمقراطية على العكس قد تقضي على مكتسبات نهضة الشعوب مثلما أتت في ألمانيا وفي دول أوربية أخرى بفاشيات عنصرية ديكتاتورية قمعية، وأتت في إيران بعد الثورة بفاشية دينية مازالت صامدة في وجه التاريخ.
إن الحالة المصرية تختلف شكلاً وموضوعاً عن الحالة الغربية. فالشعوب العربية وعلى رأسها مصر لم تعرف بعد حركة تنويرية أو مراجعات فكرية ودينية وفلسفية وثقافية وسياسية مثل التي عرفتها أوربا في عصر النهضة، وأقصى ما عرفته شعوب هذه المنطقة هو استيراد قشري، قاصر، بل ومشوه (سمح به احتكاكها بالغرب من خلال صدمة الاحتلال وثورة المعلومات) لمنجزات عصر النهضة في الغرب. فالعالم العربي ومصر خاصة استورد من الغرب مبتكراته العلمية دون أن يستورد الأسس العلمية والثقافية والفكرية التي أدت إليها (والتي يتعارض بعضها مع مفاهيمه الدينية والثقافية وكان ولازال يسخر من بعضها الآخر على أنه ترهة وشطحات هوس أدى بأصحابه من علماء وفنانين ومفكرين إلى الجنون في الدنيا وبئس المصير في الآخرة). فالعالم العربي ومصر خصوصاً اطلع على فلسفات فلاسفة الغرب دون أن يستوعبها، تداول فنونه دون أن يتصالح معها أو يقبلها، درس علومه دون أن يهضمها ويبني عليها أو يساهم فيها، استورد مؤسساته السياسية دون البنية الاجتماعية والإنسانية التي تؤسس لها.
أضف إلى ذلك افتقار مصر إلى البنية السياسية والحزبية التي تسمح بتجربة ديمقراطية فيها من صمامات الأمان ما لم تجد أشد دول الغرب تعصباً للديمقراطية منه بداً للحيلولة دون سطوة العامة والجهلاء والمتعصبين على مقادير الشعوب، لتدرك عندها الكارثة التي لابد للديمقراطية أن تؤدي إليها في مصر، في مجتمع الدولة فيه مصابة بالوهن، غير قادرة على بسط سيطرتها على الأقاليم والتجمعات الريفية والقبلية المعزولة سياسياً واقتصادياً عنها (وما حدث مؤخراً في قنا خير دليل على ذلك)، تاركة الساحة للمؤسسات الدينية ومراكز القوى المحلية لتلعب دوراً فشلت الدولة في أن تضطلع به من رعاية صحية وخدمات تعليمية وإعانات اجتماعية.
إن الديمقراطية ليست مؤسسات حكم وتداول للسلطة. فالديمقراطية هي قبل كل شيء أسس وأرضية ثقافية واجتماعية وحضارية وسياسية تفتقدها مصر على الأخص والدول العربية عموماً ذلك أن عمادها مبادئ التعددية، واحترام الحريات بل وتقديسها، والحق في الاختلاف وقبول الآخر (وقد أشرت في مقالات سابقة إلى أن الشعب المصري يفتقر افتقاراً خطيراً لهذه المفاهيم التي لا تدخل في قاموسه أصلاً لاعتبارات دينية وثقافية كثيرة). وظني أنك لو نظرت إلى الحالة المصرية ككل بواقعية وموضوعية تاريخية وثقافية واجتماعية ودينية لأدركت أن الديمقراطية في مصر لا يمكنها إلا أن تأتي للحكم بمن لا يفقه ومن لا يرى من الدولة إلا بقرته وحمارته والمسجد أو الكنيسة التي يتردد عليها.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :