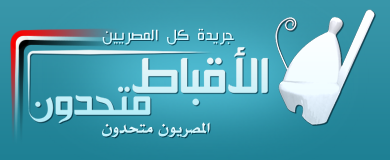الكاتب
جديد الموقع
المادة الثانية في الدستور
عندما يستعمل الدين وسيلة للظلم
بقلم : مهندس عزمي إبراهيم
إن أدخال الدين في الدستور أو في الحكم ظلم صارخ "رسمي" من الدولة ضد طوائف من مواطنيها. هو إستعمال صريح للدين كوسيلة للظلم. يبيح تسلط طائفة واحدة عن طريق الدين على باقي طوائف المجتمع، حتى من نفس الدين. فالدستور حينئذ ما هو إلا قانون متحيز لطائفة بعينها وظالم جائر لغيرها.
أود أن أقدم ترجمة إيضاحية لقولة الفيلسوف الفرنسي بوسيت( BOSSUET ) المشهورة عن المجتمع الذي لا يحكمه قانون: "حيث يملك الكل فعل ما يشاء، لا يملك أحدٌ فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد"
عندما يكون المجتمع بدائياً فطرياً بلا قيادة وبلا قانون وبلا نظام يحفظ الأمر وبلا أمر يحفظ النظام، فالفرد في هذا المجتمع يكون مطلق الحرية يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء ويتصرف كيفما شاء، لا رقيب على فعله، ولا رادع على أخطائه، ولا رياسة عليه من أي شخص أو سلطة. ويصير المجتمع كله مجتمع أسياد حيث الكل مطلق الحرية، وهذا يبرر الغلظة والتعسف والصلافة والتسلط والهمجية في المجتمعات البدوية والبربرية.
وحيث أن المجتمع قد صار مجتمعاً كله مطلقي الحرية أي أسياد أو متسيِّدين، فبالطبيعة لابد لكل متسَيِّد من عبيد يتسيَّد عليهم. وبما أن أفراد المجتمع كله أسياد أو متسيِّدين فيصير كل أفراد المجتمع عبيداً. ولا بد أن لمجتمعٍ كله أسياد وكله عبيد أن يكون مجتمعاً فوضوياً غوغائياً، وفي نفس الوقت مجتمعاً مشلولا، حيث لا يستطيع فرد أن يفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويتصرف كيفما شاء، حتى في ضروريات الحياة، لأنه رغم أن الفرد سيد فهو عبد. وبما أن الكل عبيد فحقيقة الأمر، ليس واحد منهم سيداً، حتى ولا واحد.
لذلك ظهرت الحاجة إلى القانون للحد من "مُطلقية" حريات الأفراد وتجنب ما تنتج من تضارب، وللتوفيق بين مصالحهم حتى لا تتعارض ولا تتداخل المصالح بينهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بالجماعة كلها إلى الفوضى. وهو ما لا يمكن تجنبه إلا عن طريق فرض سلوك معين تلتزم به الدولة والأفراد، مما يحقق النظام والعدالة والاستقرار في المعاملات. من ذلك نجد إن وجود "القانون وسلطة القانون" في المجتمع المحلي كمدينة أو محافظة أو دولة ضرورة لا بد منها. بل هما ضرورة أيضاً في المجتمع العالمي بين الدول وبعضها. ويرتبط علم القانون بعلم الاجتماع ارتباطاً وطيداً حيث لا يمكن فصلهما عن بعض. كما يرتبط علم القانون بعلم الحقوق، بل أن علم الحقوق جزء من علم القانون.
والهدف هو: ضمان وتنظيم حرية وأمن أفراد المجتمع للحياة معاً مع الالتزام بالقانون ومعاقبة مخالفيه. ويُكمِّل ذلك أن تلتزم الدولة نفسها بتطبيق القانون العادل الذي يساوي ويعدل بين جميع أفراد المجتمع بلا استثناء. ويُكمِّل عدالة القانون العادل أن يُطبَّق بحزم وشفافية وعدالة ومساواة بين الجميع.
فالقانون بتعريف مبسط هو مجموعة من القواعد تتبناها الدولة لكي تحدد واجبات وحقوق الأفراد والمؤسسات وتنظم سلوكهم داخل المجتمع وتلزمهم باحترامها، وترفق بها جزاءات توقع على مخالفيها. فالحاجة للقانون وسلطة القانون هي أهم أساسيات التعايش في المجتمع، أي مجتمع. ولكن أهم من ذلك أن يكون القانون (وهو الدستور وما تلحق به من بنود وإيضاحات وتشريعات) في حد ذاته قانوناً عادلا حيوياً مدنياً معاصراً لا يميز في نصوصه طائفة عن أخري، ولا يهضم طائفة حقاً مباحاً لأخري. ولا يكفي أن يكون القانون وحده عادلاً، إذ لابد أيضاً أن تقوم السلطة الحاكمة بفروعها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية من جانبها بتطبيقه بحزم، وبعدالة،.وبمساواة. هذه هي سلطة القانون.
وهناك فرق كبير بين (سلطة القانون) و (قانون السلطة). فسلطة القانون هي سلطة الدستور الحر المنزه العادل تجاه "جميــع المواطنيــن" بغض النظر عن الدين والعقيدة والعرق والجنس واللون والطبقية والاقليمية. أما قانون السلطة فهو: إما (قانون الحاكم) أو (قانون الطائفة الحاكمة). والحاكم كما هو الحال في معظم الحكومات الفردية دكتاتوراً مستبداً لا يؤمن بالعدالة وإن ادَّعاها، وقد تعود العالم والشرق خاصة على الكثيرين من هذا النوع من الحكام. أما الطائفة فإما هي دينية أو عرقية أو طبقية، فيكون قانونها غير ملتزم بالعدالة والمساواة بين المواطنين، فهو قانون متحيز بطبيعته لطائفة بعينها وظالم جائر لغيرها. كما في الحكومات الدينية والطائفية (الاسلامية في إيران والسعودية واليمن وأفغانستان والسودان...) أو في الحكومات العرقية (مثل النازية في ألمانيا) أو في الحكومات الطبقية (مثل الشيوعية في الاتحاد السوفيتي)
وهناك إصرار دائم في الدول الاسلامية بالشرق الأوسط (من دون دول العالم أجمع)، ومحاولات مستمرة من المسلمين بالدول الحرة بأوروبا وأمريكا واستراليا والصين والهند، نحو تغليب سلطة الدين على سلطة القانون، أو حكومة الدين على حكومة القانون. هذا هو الصراع الرجعي ضد القوانين المدنية الحضارية الديموقراطية التي تساوي بين كل مواطني الوطن الواحد. وهذا الصراع مدفوع برجال الدين ودعاة الدين ومدعي التدين والمتدينين البسطاء.. لمصلحة واحدة أو هدف واحد فقط وهو تسلط طائفة واحدة عن طريق الدين على باقي طوائف المجتمع حتى من نفس الدين (سني وشيعي وأحمدي وإباضي وخوارجي وكلابي ومرجئي ومعتزلي وموحدي، وما يتبعهم من تفريعات عديدة...)، وكلٌّ لها مقدساتها وفتاويها وروابطها ومفهومها في الدين وطريقة الحكم، ناهيك عن تابعي الأديان الأخرى. وهنا يمكن الجزم بضياع بل دهس مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.. بسبب الدين!!
والعجيب أن العدالة ليست فقط أساس القانون، وأساس وجوهر الإنسانية ذاتها. بل من المفروض أنها أيضاً من أهم أساسيات الدين، أي دين، أو أي ما يستحق أن يدعى دين، فالعدل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته. ولكن مما سبق لا يمكن أبـداً أبـداً أبـداً لحكومة دينية أن تلتزم بالعدالة. فالمسلم السني في إيران المسلمة وفي سوريا المسلمة مواطن من الدرجة الثانية، مهضوم ومضطهد. والمسلم الشيعي في السعودية المسلمة (لو وُجـِدَ) وفي مصر المسلمة مواطن من الدرجة الثانية، مهضوم ومضطهد. ناهيك عن باقي ملل وتفريعات الإسلام. وناهيك أكثر وأكثر عن غير المسلمين. فالأقباط في عقر بلادهم، تحت حكم دولة دينية اسلامية، مواطنون من الدرجة التاسعة عشر، مهضومون ومضطهدون، ولا ينكر ذلك إلا ظالم جاحد لا يؤمن بدينه ولا بالله، فالدين يفرض العدل والله لا يقبل الظلم.
نستنتج من ذلك أنه من الطبيعي أن لا عدالة لحكومة دينية أو سلطة دينية أو سلطة الحاكم أو سلطة الطائفة الحاكمة. فليس أعدل من سلطة القانون الحر العادل المطلق. وهنا تأتي مسئولية جهازين منفصلين (وليس سلطتين) للرقابة على ضمان مجتمع راقي غير ظالم:
(1) الجهاز الأول: سلطة القانون وهي السلطة الحكومية المؤسسة على قواعد قانونية مدنية عادلة حرة (لا دينية متحيزة لطائفة حاكمة) لإلزام المواطن على احترام التصرفات المدنية الموضوعة للجميع ومعاقبة من يخالفها. وهي السلطة الوحيدة التى تملك سلطان العقاب للمخلفين.
(2) الجهاز الثاني: المؤسسات الدينية (ولم أقل السلطات الدينية فهي مؤسسات لا سلطات) وظيفتها التوجيه والتوعية والوعظ والإرشاد (فقط) نحو تنمية الروحانيات والأخلاق الحسنة والتعامل بالحسنى بين الناس
الدين إيمان شخصي بين الإنسان وخالقه ولا دخل لإنسان آخر أو لسلطة ما التدخل فيه، ومكانه في القلوب، ويظهر في الأعمال، ويمارس في المعابد ويعلم الخلق الحسن وكيفية التعامل بين الناس كمواطنين وجيران وزملاء بغض النظر عن عقيدة الآخرين. لكن لا مكان له في دواوين الحكومات أو دساتيرها. فمن الطبيعي والبديهي والمتوقع أنه لو حكم الدين (أي دين) بشريعته لأنصف طائفة على غيرها حتى من نفس الدين. وبذلك لن يكون هناك عدالة بل ظلم صريح "رسمي" من الحكومة لمواطنيها. ولا يختلف في ذلك اثنان.
أما القانون فمثله مثل الدين ينص أيضاً على الأخلاق ويحمي جميع المواطنين من مخالفيه حيث للقانون (وحده) سلطة العقاب. وهذه واحدة من وظائف القانون المدني الإنساني المتحضر. والقانون لا يلغي الأديان، فهو يضمن حرية العبادة لكل مواطن كيفما شاءت له عقيدته.
مخطيء من يظن أن النداء بالدولة المدنية يعني إطـــــــــلاقاً إلغاء الأديان أو تصغير دورها في المجتمع. وما هذا إلا ادعاء خبيث يلعب به دعاة الدين المغرضين والمتسلطين والمتسلقين إلى السياسة والمناصب حيث يضللون به البسطاء والأميين.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :