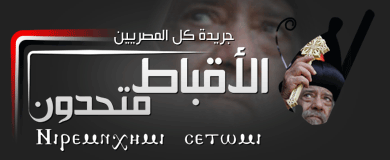- هل الاقتصاد الإسلامي هو الأكثر عدلاً والأكثر حفاظًا على رأس المال؟
- نشطاء أقباط :الأزهر أحرج التيارات الدينية بإنسحابة من تأسيسةالدستور الإسلامى.
- من فضائح وزارة العادلي وزمن مبارك اختفاء محامي مسيحي منذ 9 سنوات
- متظاهرو "السويس": الدستور للمصريين مش إخوان ولا سلفيين
- "شباب ماسبيرو" يصدر تقريرًا عن الأحداث الطائفية في "مصر" خلال عام 2011
الأقباط بعد شنودة: المأزق، هل انتهى الحوار وجاء زمن المواجهة؟
هل إنه المأزق؟
السؤال مطروح في مصر، كما في الأوساط القبطية المهاجرة بعد رحيل البابا شنودة الثالث، وهو رحيل يبعث على القلق في أعقاب التغيير الذي تشهده مصر. ذلك أن البابا الراحل، لم يكن فقط رجل حوار، بل قيادياً وطنياً وقومياً بكل معنى الكلمة، وسداً منيعاً في وجه الفتنة الطائفية، وصاحب كاريزما سياسية وصفات استثنائية، وليس من يتوقع أن يكون خليفته قادراً على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
كيف يمكن قراءة هذه التحديات؟
رحيل شنودة جاء في لحظة مصرية حرجة يصر فيها السلفيون على خطف كل الأضواء بصيحاتهم ومواقفهم المثيرة وآخرها تحريم التعزية بوفاته. ورغم أن نبي المسلمين هم بالوقوف أثناء مرور جنازة يهودية قبل نحو 14 قرناً من الزمن، احتراماً لقدسية الموت، فقد استقبل عدد من السلفيين والجماعات الاسلامية نبأ وفاة بابا الأقباط بزخ من الفتاوى التي تحرم الترحم عليه ورفضوا تقديم العزاء، كما رفض عدد من نواب حزب «النور» (السلفي) الوقوف دقيقة صمت حداداً على نفسه وهموا بمغادرة الجلسة احتجاجاً.
وفي سياق مواصلة بثّ مشاعر الكره تجاه الأقباط، تناقلت مواقع إسلامية متطرفة وغيرها فيديوات مسجلة لشخصيات دينية معروفة بتشدّدها في الهجوم على شخصية البابا. فاستقبل موقع «أنصار السنّة المحمدية» نبأ وفاة البابا بالتدليل على حرمة التعزية ببابا الأقباط، بحيث اعتبر الموقع التعزية أشد خطراً من تهنئة النصارى في أعيادهم أو شعائرهم الدينية، مستشهدين بالآية القرآنية «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم». الموقع نفسه لم يقف عند هذا الحد، بل طالب المسلمين بلعن البابا شنودة لأنه مات كافراً.
المواقع السلفيّة بدورها تبارت من أجل رفض مشاعر الحزن التي انتابت جموع المسلمين في مصر بفقدان البابا، ونشر موقع «قناة المخلص» السلفي مقالاً يعلّق على وفاة البابا تحت عنوان «أخيراً رحل رأس الفتنة»، وجاء فيه «رحل الأنبا شنودة عن الدنيا بعدما ترك إرثاً من الكراهية والعداء بين المسلمين والنصارى في مصر المحروسة. رحل رأس الفتنة بعدما كاد يُسقط البلاد في فخ الفتنة الطائفية لمرات عديدة على مرّ تاريخه الأسود الذي اعتلى فيه منصب البابوية».
على الدرب نفسه من التجرّؤ على الموت، نشر موقع «أنا المسلم» السلفي تصريحات للداعية الإسلامي وجدي غنيم، ينتقد تعزية القرضاوي بالبابا شنودة الثالث، ويوجه له رسالة سخرية تقول «عزّي في البابا مش هتعزي في الماما!!». قبل أن يزيد ويقول عن وفاة البابا «مصر قد استراحت من رأس الكفر والعبد الفاجر والهالك والمجرم الملعون وعدو الإسلام ينتقم منه رب العباد والذي ولع مصر، واننا نفرح لهلاكه لعنة الله عليه ولعنة الناس عليه، غار في ستين داهية». وبتحدّ اختتم الشريط المصوّر قائلاً «أنا وجدي غنيم وهذا الكلام صادر مني وبصوتي بتاريخ الأحد 18/3/2012».
هذا الهيجان السلفي يؤكد، مرة أخرى، حجم التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية الارثوذكسية في الزمن الاسلامي السلفي، وحجم الملفات الشائكة التي يواجهها البابا الخلف بعد انتخابه، لأن مؤسسات الحكم بعد سقوط النظام السابق لم تستقر حتى الآن على خيارات واضحة، ويصعب بالتالي التنبؤ بمستقبل العلاقة بين الاخوان والأقباط من جهة، والسلفيين والكنيسة القبطية من جهة أخرى، علماً أن المجلس العسكري الأعلى في مرحلة ما بعد مبارك، لم يعط الدليل على أنه راغب فعلاً في تركيز السلم الأهلي على أسس وثوابت واضحة.
من هنا يمثل رحيل شنودة غياب قيادة واعية في لحظة مصرية مربكة تعاني منها مختلف المؤسسات الدينية والسياسية معاً. وفي مواجهة هذا الارباك تطوع الأزهر لاصدار وثيقة تؤكد على التعايش المسيحي- الاسلامي، كما تؤكد على الوسطية في الاسلام، محاولاً وضع الأطر السليمة للخطاب الديني الذي يتردد على مدار الساعة، والاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر من جانب الجماعات الاسلامية المختلفة.
والمعركة التي يواجهها الأقباط في المرحلة المقبلة، لا تقتصر على التناقض العلني بين التوجهات الاسلامية وتوجهات الكنيسة، وانما تتجاوز هذه المواجهة الى داخل الكنيسة القبطية نفسها، بعدما تبلور اتجاه داخل الأقباط يرى أن من حقه أن يتصرف منفردا بمعزل عن توجيهات الكنيسة، بعد ارتخاء قبضة البطريرك الراحل نتيجة تقدمه في السن.
ويمكن القول ان البابا الراحل يترك كماً هائلاً من القضايا العالقة، يمكن حصرها في نقاط أساسية هي:
- مجتمع مسيحي يواجه تحدي التيارات الدينية الإسلامية المتطرفة.
- كنيسة تواجه تحدي تعدد الأصوات من حول كرسي البطريرك، الذي قد لا تكون له السطوة الأبوية نفسها التي كانت للبابا شنودة.
- كنيسة ليست لديها السيطرة الكاملة - على الأقل سياسيا - على كل مفردات مجتمعها المسيحي، خصوصا أجيال الشباب.
- جماعات مهجرية ضاغطة على الكنيسة المحلية قدر ضغطها على الدولة.
- أصوات علمانية مسيحية ترفض سطوة الكنيسة على الحياة المسيحية بكل تفاصيلها، وتريد أن يقتصر تأثيرها على البعد الروحي فقط على أن يدير الأقباط حياتهم العامة بعيدا عنها.
هذه التحديات تكتسب بعداً أكثر خطورة اذا ما عرفنا أن ملف الكنيسة في عهد مبارك، وطوال فترة تولي شنودة مهامه، كان مضبوطاً بالعلاقة القائمة مع أجهزة الدولة ومخابراتها، وهذه الأجهزة فقدت الكثير من أهميتها بعد التغيير. ثم ان البابا رحل في لحظة بالغة التعقيد يستعد فيها المصريون لصياغة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد، وسط مشاعر قلق تسود الكثيرين من أن يتضمن هذا الدستور توجهات تعزز الممارسات المتطرفة في حق الأقباط.
ومعروف أن البابا الراحل عانى في السنوات الأخيرة من «حزمة أمراض» دفعته الى تخفيف جهده، والسفر المتواصل للعلاج في الولايات المتحدة، ورغم تلك المعاناة لم يخرج أي فريق قبطي على توجيهاته المستندة الى مكانته الدينية والتاريخية، وسيكون من الصعوبة بمكان، بعد غيابه، أن يستطيع البابا الجديد فرض هيبته وقراراته من دون اعتراضات داخل الرعية.
وقد تمكن البابا شنودة وساعدته الظروف، من أن يحدث توسعا متعدد المستويات للكنيسة القبطية في المجتمع المصري وعابر الحدود، سواء في اتجاه التفاوض المستمر مع الدولة على بناء كنائس جديدة رغم قيود البناء التي تفرضها قواعد «الخط الهمايوني»، الذي ناضل الأقباط من أجل تغييره طوال عصري السادات ومبارك من دون أن يتغير، أو في اتجاه الاتساع المستمر لنشر الكنائس الأرثوذكسية في مجتمعات المهجر، حيث ملايين من الأقباط الذين أقاموا في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة واستراليا.
واستطاع شنودة أن يخضع تلك الكنائس المهجرية لقيادته الروحية، عبر تولي شؤونها من قيادات دينية يختارها هو من القاهرة، حيث مقر الكنيسة الأرثوذكسية، أو من خلال رحلاته الرعوية المتكررة سنويا في اتجاه كنائس الولايات المتحدة وغيرها.
هذا الجناح المهاجر وفر للكنيسة في مصر ظهيرا ماليا ساندها بتبرعاته المختلفة، ما عضد انتشارها في مصر، وفي الوقت نفسه، تحول إلى رديف سياسي لها، بحيث أصبح أعلى صوتا وأكثر تحررا من أقباط الداخل في المطالبة بما يرى أنه حقوق مهدورة للأقباط في الوطن. واستطاع البابا شنودة بحنكة شديدة أن يصنع من هذا التضاغط سياجا أحاط بالأقباط المصريين في مواجهة ثقافة متطرفة صاعدة، في الوقت الذي سيطر على جنوح كنائس المهجر، بما لم يمنع ظهور جماعات ضغط مسيحية مهجرية من حول كنائس الخارج ومن دون أن تكون من داخلها.
وإذا كان «مجتمع المهجر»، هو أحد أهم وأبرز المتغيرات في مسار الكنيسة الأرثوذكسية في ربع القرن الأخير من «عصر البابا شنودة»، فإن السنوات العشر الأخيرة تأثرت بتيارات المهجر، وتفاعلات المجتمع المصري عموما في الداخل، والنزوع الحديث إلى مواجهة الكنيسة سياسيا ومناقشتها علنا من قبل المسيحيين أنفسهم، تلك السنوات العشر أدت إلى ميلاد أجيال جديدة من الشباب التي تبلورت لديها اتجاهات جديدة عن أجيال آبائها في العلاقة مع الكنيسة. تلك الأجيال اعتراها ما اعترى أجيال مصر عموما من تغيير، ومنحت نفسها القدرة على التحرر من المواقف التي تتخذها الكنيسة، بل في كثير من الأحيان ممارسة الضغط عليها، وربما انتقاد البابا الراحل بصوت صريح يصل حد التهجم على أدائه، وعلى طريقة تعامله مع الدولة وإدارته للأمور القبطية معها. في غضون تلك السنوات اندفع هؤلاء الشباب إلى جعل الكنيسة ساحة لتظاهراتهم، وكانوا هم أول من رفع الصلبان في التجمعات الحاشدة، وإلى جانب ذلك توزع عدد كبير منهم على مجموعات من الحركات الاحتجاجية خصوصا «حركة 6 أبريل».
أي ملف؟
هل يملأ البابا القادم الفراغ السياسي الذي تركه البابا الراحل، وهل يكون قادراً على التوفيق بين دوره الديني ودوره السياسي؟
الاجابة عن السؤال بشقيه تبدو صعبة لأن الظروف التي رافقت مرحلة شنودة، أي ولايتي السادات ومبارك تبدلت، والظروف الجديدة أكثر تعقيداً خصوصاً في المرحلة الانتقالية، وعملية احتواء التشنجات القائمة بين الاسلاميين (السلفيين بصورة خاصة) والكنيسة القبطية لن تكون سهلة في المرحلة المقبلة، وكل شيء مرهون الى حد بعيد بشخصية البابا الجديد وطبيعة علاقته بالمؤسسات الدينية الاسلامية وأقباط الوطن والمهجر على السواء. والحقيقة التي لا يجادل فيها أحد هي أن «الملف القبطي» في مصر ملف مزمن، وهو حقيقي وليس وليد تآمر أجنبي أو تحريض اسلامي، ولا هو محض نتاج انعزالية تعتمدها المؤسسة الكنسية، ومعالجة هذا الملف شرط أساسي لمعالجة العوامل الأخرى السياسية وغير السياسية التي توظفه في إثارة النعرات الطائفية، ولا بد بالتالي من وضع القضايا المزمنةكافة، على طاولة النظام المصري الجديد.
والواقع أن الكنيسة، بقصد أو بغير قصد، تواطأت في الفترة الماضية، مع قوى أخرى في الدولة المصرية، كما مع تيارات اسلامية مصرية، لمنع نشوء وتطوير ثقافة وممارسة وطنية مصرية. وقد أثبتت الوقائع (مجريات ثورة 25 يناير بصورة خاصة) مدى ترابط طموحات المصريين مسلمين وأقباطاً بالثورة وتغيير النظام كوسيلة لتغيير أوضاعهم السياسية والاجتماعية، ما يعني أن الدولة الدينية في مصر لا تشكل طموحاً ثورياً.
انها حقيقة أولى، والحقيقة الثانية هي أن فقدان الديمقراطية في مصر الثورة، بعد عام 1952، هو الذي أدى الى فقدان المساواة بين المصريين، نتيجة انصراف جهاز الدولة الى ضمان مصالح نخبه الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتبعية لمصالح قوى خارجية، وقد تفاعل هذا كله مع قضية التوريث التي تتناقص مع مفهوم المواطنة، ما حرم الأقباط وشرائح اسلامية واسعة من المواطنة.
ومن خلال استقراء واقع الأقباط في مصر، يمكن القول ان عهد مبارك مارس انفتاحاً نسبياً عليهم من دون احداث قطيعة مع الممارسة الالغائية فيعهد السادات، اذ ظلت المشاركة السياسية تقتصر على بعض النواب المعينين او الوزراء في وزارات غير سيادية. على سبيل المثال، وليس الحصر، اقتصر تمثيل الوزراء من أصل قبطي في الحكومة الأخيرة قبل الثورة باثنين فقط هما بطرس غالي في وزارة المالية وماجد جورج في وزارة البيئة، وبعد تكليف أحمد شفيق بتشكيل الحكومة احتفظ وزير البيئة وحده بمنصبه.
في هذا السّياق تبرز حقيقة أنّ بعض الوظائف المهمة في الدولة ما زالت مغلقة أمام المواطنين المصريّين الأقباط، وأنّ نسبة تمثيلهم في حقول القضاء، والإعلام، والبعثات الدبلوماسية، والجيش والشرطة لا تتجاوز معدل 2%. وعلى سبيل المثال، هناك 17 جامعة حكومية في مصر، لكلّ واحدة منها مدير وثلاثة أو أربعة نوّاب بمجموع 71منصبا، ولا نجد في هذه المناصب قبطيا واحدًا، كما يوجد 274 عميداً في هذه الجامعات، وليس بينهم سوى قبطي واحد.
وماذا عن احتمالات ما بعد الثورة الأخيرة؟
الجواب هو أن «الملف القبطي» لا يزال مفتوحاً والتصدي له ضرورة مصرية وطنية قبل أن يخرج عن السيطرة، بسبب التدخلات الخارجية من جهة والتطرف الأصولي من جهة أخرى.
وحدوث حالة تحوّل تاريخي في مصر بعد الثورة، يمثّل فرصة تاريخية للإخوان وغيرهم للمراجعة والتنظير وتوضيح مبادئهم في المسائل المدنية، فقد انتفى وجود السلطة الدكتاتورية السابقة التي كانت تدفع وتضغط على الجميع في اتّجاهات صراع وتناحر. ويذكر عضو الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أنّ الإخوان المسلمين بعد الثورة يختلفون عن إخوان قبل الثورة، فهم الآن أصبحوا يعملون في العلن أمام الجميع وبكلّ شفافية ووضوح بعد ذهاب النظام السابق، كما يعلق قائلاً: «والآن ذهبت المحظورية ويجب أن تؤسّس الجماعة نفسها بشكل قانوني وشفّاف وتمارس عملها الدعوي والمالي والإداري بكلّ شفافية ووضوح». كما تنتشر اليوم قناعات واسعة بتحقّق دور قريب لهم مع التحوّل المدني الديمقراطي في مصر، وقد تناقلت وسائل الإعلام بعد الثورة المصرية تصريحات لقادة غربيّين مثل أوباما وساركوزي ألمحت إلى دور محتمل للإخوان في المشهد السياسي.
ويمثّل أمر التحول وإعادة التشكيل السياسي بعد الثورة فرصة للأقباط أيضاً لمراجعة موقفهم من الإخوان ومن تلك التحفظات التي تضعها الكنيسة في أمر المشاركة السياسية، فهي قد تنتفي كلها في إطار ديمقراطي مناسب. وعلى سبيل المثال، فقد تعرض الإسلاميون للقمع والملاحقة في مرحلة عبد الناصر ومع ذلك لم تتوافر للأقباط مشاركة سياسية معتبرة، وكما يعلّق طارق البشري فإن «ضرب التيار الإسلامي ليس مصدر أمن للأقلية الدينية غير المسلمة، إنما مصدر الأمن يتعلق بنظام الحكم، أي بالديمقراطية وبإقرار مبادئ المساواة والمشاركة».
لقد فُقدت المساواة مع فقدان الديمقراطية أيضاً، كما أشرنا، كما أن انشغال جهاز الدولة في مصر بضمان مصالح نخبه الاقتصادية والسياسية والتبعية لمصالح قوى خارجية؛ وتفاعل هذا كله مع قضية التوريث، قد تناقض مع أمر القيام بمسؤوليات الدولة تجاه تحقيق مفهوم المواطنة، كما تناقض مع أمر السعي لتحقيق إصلاحات حقيقية على مستوى الوطن، وهذا ما ولّد سخطاً شعبياً عاماً ومن جميع التيارات على الجهاز الحكومي المصري. ولم يقتصر فشل جهاز الدولة على المستويين السياسي والاجتماعي، فالمناخ الثقافي الذي شجّعه وأشاعه النظام هو أقرب إلى الفساد في كلّ أبعاده.
وينتشر في أوساط مصريّة غير طائفية، ومنها ديمقراطية ويساريّة وقومية وإسلامية، موقفٌ نقدي لا يكتفي بنقد المسؤولين على التّحريض الطائفي ضدّ الأقباط ولا يعفي الكنيسة من المسؤوليّة، إذ ينتقدها على تصاعد دورها السّياسي وعزلها للأقباط عن الشّأن المصري العام. ويرى بعض الكتّاب المؤيّدين لمساواة الأقباط أنه وقّع في الآونة الأخيرة اقتراناً بين مصلحة نخبة الكنيسة ونخبة الرئاسة في مصر، ما أدّى إلى وجود «حالة التباس مرتبكة. يكون الأقباط المسيحيّون ضحيّتها الأولى». كما ينتشر موقف نقدي تجاه استفزازات المتطرّفين، مثل «أقباط المهجر» الذين يتحدّثون عن الانفصال، ومثل بعض رجال الدين من أمثال الأنبا المتطرّف بيشوي الذي وصف المسلمين بأنهم ضيوف على مصر.
يتضح إذاً، وبصورة جلية، وجود ملفّ قبطي مفتوح في مصر يحتاج إلى معالجة، وأيّ معالجة جدية للموضوع تبدأ بوجود النيّة لذلك، إذ لا يكفي الادّعاء. وهذه النية لم تتوافر لدى النظام المصري السابق، وربما توافر لديه عكسها تماما. لكن أيّ نظام جديد في مصر يملك هذه النية يفترض أن يعترف بوجود الملف، وهو مركب من قضايا ذات علاقة بهوية الدولة، والتعامل مع الأقباط كأقلية يمارس معها التسامح. وهنا مكمن الخطر، فالأقباط ليسوا في حاجة إلى تسامح، وهم لا يمثّلون رأيا مختلفا يمكن التعامل معه بمقاربة تعدّدية تسامحية. إنهم مواطنون أصيلون لا يحتملون من حيث وعيهم بذاتهم أيّ نوع من التمييز. ومن هنا فإنّ المفتاح للتعامل مع هذا الملفّ هو المواطنة المتساوية.
الديمقراطية هي الإطار الملائم لمثل هذه المقاربة، لكن عدم معالجة القضية الطائفية، بتخفيف تأثير فهم معيّن للدّين في الدولة، قد يحوّل الديمقراطية إلى إطار لتفاقم القضية بسبب القدرة غير المتاحة سابقا للتّعبير عنها، وهنا مكمن الخطورة.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :