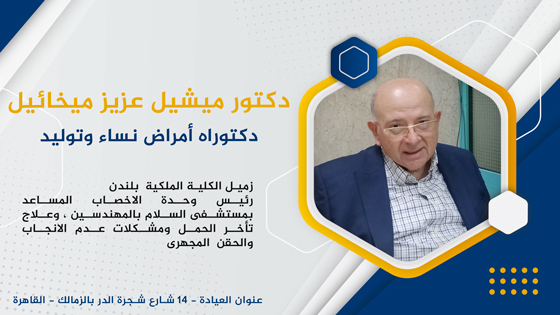فى الفكر المسيحى
ألفى شند
إذا كان الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية السمة المميزة المسيحية وفقا لتعاليم السيد المسيح فى الاناجيل ، وهو ما سارت عليه الكنيسة الاولى بعد الاعتراف بها كديانة رسمية فى الامبروطورية الرومانية سنة 312 وعبرت عنه العبارة الشهيرة للقديس أمبروسيوس المتوفى عام 397، والذي كان يشغل منصب حاكم ميلانو قبل أن ينضم إلى الكهنوت ويصبح أسقفاً، أكد على وجوب التمييز بين الدين والدولة "فبينما يمارس الإمبراطور أعلى سلطة زمنية، يجب أن يكون الإيمان والاخلاق مجالاً خاصاً بالأسقفية. " لكن بموجب الرسالة التى اوكلها لها السيد المسيح على ضوء تعاليمه وتوجيهاته، فإن للكنيسة الحق في إصدار حكمها الأدبيّ في القضايا السياسية التي تتعلق بكرامة وحقوق الانسان الأساسيّة وخلاص النّفوس، مستخدمة مختلف الوسائل الملائمة للإنجيل وخير الجميع . وفى نطاق هذا الحق رأى الفلاسفة المسيحيين ، فى شأن العلاقة بين الرعية والسلطة السياسية والقانون وشرعية الحرب .
حسب القديس اغسطينوس (354 – 430) فى كتابه "مدينة الله" وجوب طاعة السلطات على حذو بولس الرسول فى رسالته الى أهل روما "على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة، فلا سلطة إلا من عند الله، و السلطات القائمة مرتّبة من قِبل الله، حتى إن من يقاوم السلطة، يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم، فإن الحكام لا يخافهم من يفعل الصلاح، بل من يفعل الشر" (13: 1-4) فهو يعتبر السلطة الدينية اوالمدنية تفويض من الله ، و كلّ تمرّد على السلطة الحاكمة يُعتبر عصياناً يعاقب عليه القانون.
وبناءً على مبدأ التفويض، فإن طاعة الحكام هي "أمّ الفضائل "، و هي توجد على رأس هرم الفضائل. ويحضّ أغسطينوس على طاعة السلطة السياسية الأرضية، حتى و لو كانت سلطة جائرة، ما دامت لا تسعى إلى التحكم في ضمائر الناس وعقيدتهم الدينية.
وأورد أغسطينوس ثلاثة حجج للدفاع عن فكرة طاعة الولاة : أولا، أن الله يهب الحُكم لمن يشاء، مؤمنا كان أو وثنيا، لحكمة لا يعلمها إلا الله؛ ثانيا، قد يكون حكم الظالم تصرفاً إلهيا من أجل تهذيب النفوس و صرفها عن الشعور بالكبرياء، ثالثا، قد يكون الظالم أو الوثني مجرد وسيلة يسعى الله من خلالها إلى استتباب الأمن والسلام في الحياة المشتركة بين المواطنين، ومع ذلك، عندما يتجاوز الظلم حدّاً لا يُطاق، يصبح العصيان واجباً، غير أنّ المقاومة تظلّ روحية، ولا يُثني عن محبة العدو، مهما عظُم الظلم .
ومن حق الدولة ان تشرع القوانين ، ويقتضى ان تتوفر فيها الشروط الاتية : أولًا: يجب أن يصدر عن القانون الطبيعي، فليس القانون الجائر قانونًا، ولا يمكن أن يعطي الحق المطلق للحاكم، بطريقة تخلق له منفعة تُفْرَض على الرعية كحق واجب؛ لأن أساس الحق العدالة لا منفعة الأقوى، وأساس استخدام القوة أنها وسيلة لتأييد العدالة.
ثانيًا: القانون الوضعي أضيق نطاقًا من القانون الطبيعي، فهو لا يتناول سوى الأفعال الظاهرة، ويغض الطرف عن بعض الشرور، ليتفادى شرورًا أعظم، تاركًا لله المعاقبة على ما لا يعاقب القانون الوضعى عليه.
ثالثًا: القانون الوضعي تابع إلى لظروف الزمان والمكان، فإن من العدل تدبير الأخلاق بحسب اختلاف أحوال الإنسانية الخاطئة، فلا ينبغي اتهام شعب بالرذيلة إذا ما بدت لنا حكمته أدنى من حكمة شعب آخر أو عصر آخر، إن العدالة ثابتة، ولكن الناس متغيرون، ويذهب حق تأييد العدالة بالقوة إلى حد مشروعية الحرب؛ فيقول: للحرب خصوم يزعمون إنها مضادة للأخلاق، ويشقى الناس من ويلاتها، الحرب الممقوتة هي التي يحدوها حب الفتح أو الحقد والانتقام، ولكنها واجبة فى حاله التصدى للمعتدى، والامتناع عن شنها يؤدى إلى انتصار الأشرار، وهي نكبة خلقية، وإغراء للاشرار بالتمادي، وفتنة للآخرين، بينما تكف المقاومة شرهم، فالحرب مشروعة متى كانت الوسيلة الوحيدة لصيانة الحقوق المهددة، والذين يموتون فيها مائتون حتمًا يومًا ما، وهم إنما يموتون لكي تحيا الأجيال التالية في كرامة وسلم، فعلى الجند الطاعة، وهم لا يعتبرون قتلة؛ لأن القتل الذي حرمه الله هو الصادر عن هوى شخصي، عليهم الطاعة حتى ولو كانوا يشكون في عدالة حربهم، فإن الإثم يقع على صاحب السلطان لا عليهم، ولا يحق لهم العصيان إلا إذا كانوا على يقين تام بمنافاة حربهم للعدالة، على أن الحرب، إذا كانت ضرورة، فهي ضرورة محزنة، فلا أقل من أن تسودها الرحمة بحيث لا يؤتى فيها من الأفعال إلا الضروري للانتصار، وكم تكون الإنسانية سعيدة لو أنها صغيرة يعامل بعضها بعضًا معاملة الأسر المتحابة !
ولمشروعية الحرب، وضع أغسطينوس عناصر يجب أن تتوفر فيها كي تكون حربا عادلة مشروعة، وهذه العناصر هي:
يجب أن تكون متوافقة مع قانون الطبيعة، أو بأمر إلهي.
يجب أن تكون تحت قيادة شرعية فلا يحق للفرد أن يجمع الجيوش ويشن حربا علي دولة أخري.
يجب ان تكون الحرب لهدف سامي بأن تكون قائمة علي المحبة رغم استخدام العنفم وأن تكون لسبب عاد كاستعادة الحقوق أو معاقبة المعتدي. ويستشهد القديس أوغسطينوس علي مشروعية الحرب بنص من انجيل لوقا 3/ 14 حيث سأل بعض الجنود يسوع أن يوصيهم فلم يطالبهم باعتزال الجندية، وقال لهم : "لا تظلموا أحدا ولاتشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم"، ويقول القديس أغسطينوس وان كانت المسيحية تدين جميع أنواع الحروب لكانت النصيحة التي يقدمها الإنجيل للجنود الذين سألوا عن لخلاص، ان يلقوا أسلحتهم ويهجروا الجيش نهائيا، بل ان نصحهم بالقنوع في مرتباتهم بدل من عدم تحريم الجندية .
وتجدر الاشارة ، إن حملات الفرنجة التى سميت متأخرا بالحروب الصليبية التى جرت فى أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر ، وراح ضحيتها مابين مليون و 3 ملايين بمباركة من البابا اوربان الثانى استندت على تلك المبررات شرعية الحرب التى ساقها أغسطينوس ، فحسب المؤرخين ، لم تكن تبغى استعمار الشرق ونهب ثرواته ، كما تروى بعض كتب التاريخ العربية ، وإنما حسب موسوعة "قصة الحضارة" أن أول سبب للحروب الصليبية هو تقدم الجيوش الإسلامية تجاه أوروبا ، واسترجاع ولايات كانت رومانية ، وسوء معاملة بعض الحكام العرب غير الإنسانية للمسيحيين الفلسطينين والحجاج ، وتكرار الاعتداء بالحرق والنهب لكنيسة القيامة وهى أقدس مزار مسيحى على الاطلاق ، وفى مقدمة أسباب الحملات يقول المؤرخ ويل ديورانت فى كتابه "قصة الحضارة" وأول سبب مباشر للحروب الصليبية هو زحف الأتراك السلاجقة على عاصمة المسيحية البيزنطية فى ذلك الوقت القسطنطنية .
وبالمثل إسترداد شبه جزيرة ليبيريا (اسبانيا) التى تطلق عليها المصادر الاسلامية بلاد الاندلس من المستوطنين المسلمين . أما ماتلاها من حملات استعمارية فى العصر الحديث من حكومات يطلق عليها مسيحية كانت بدوافع غير دينية بهدف السيطرة السياسية والاقتصادية ، لم تحظ مباركة الكنيسة ، بل بعض هذه الحملات تصدت لها الكنيسة كما حدث ازاء غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 .
ويقول أغسطينوس : "لا يحق قتل الإنسان، ولكن هناك استثناء في الشريعة الإلهية، فإنه يجوز قتل الإنسان اذا كان قانون الطبيعة ، وهو ما لاتقره الكنيسة الكاثوليكية . يبرر ذلك، أو أن هناك أمر إلهي، اذا منح الله شخصا ما سلطانا بالقتل، فانه ليس إلا أداة في يد الله، وبذلك لا يعتبر هذا الشخص قاتلا . ورأى أغسطينوس فى الآية الانجيلية التي تقول: " لا تقاوموا الشر، بل من لطمك علي خدك الأيمن فحول له الآخر"(متى 5/39)، أن هذه النصوص يجب أن لا تفهم حرفيا، وإلا فإننا نتهم يسوع بمخالفة تعاليمه، لأنه لم يدر الخد الأيسر عندما لطمه واحد من الخدام وإنما اعترض وقال: ان كنت قد تكلمت رديّا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني؟" (يو 18/23)، وكذلك بولس الرسول، فعندما أمر حنانيا رئيس الكهنة أن يضرب بولس، اعترض بولس وشتم رئيس الكهنة قائلا له: "سيضربك الله أيها الحائط المبيّض.أفانت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس"(أع23: 1-5) .
ويقول أغسطينوس، على الدولة إقرار الملكية الفردية وحمايتها، المالك الحقيقي هو الله خالق الأشياء، ولكن الحيازة المشروعة والشراء، والبدل، والهبة، والإرث، تخول الحق في الملكية، أما الاستيلاء بطرق أخرى على ملك الغير فسرقة واغتصاب، ولا يبطل سوء تصرف المالك حقه في ملكه، ولو أريد توزيع الخيرات والمناصب على قدر العدالة والكفاية والفضيلة، لتعرض النظام الاجتماعي لتقلبات لا تحصى، فإن مثل هذا التوزيع عسير التحقيق، إن لم نقل: إنه مستحيل، وهو على كل حال قصير الأجل، ولا ينبغي أن نتوقع العدالة التامة في هذه الحياة كما لو كانت المدينة السماوية ممكنة التحقق على هذه لأرض.
ظل تفسير أغسطينوس لرسالة بولس إلى مؤمني روميه، حول طاعة السلطات المرجعية المعتمدة، يستند عليه فى الخضوع للسلطات حتى الظالمة حتىأدان البابا عريغور السابع الملك هنرى الرابع سنة 1076 وظهور اجتهادات دينيو تسمخ بعزل الولاة الطغاو وقتلهم فى القرن الثاني عشر الميلادى . قذهب القديس توما الاكوينى ( (1225-1274 ان الدولة تقوم على ضرب من التعاقد، ويستند الى تعريف شيشرون الجماعة بأنها «كثرة منظمة خاضعة لقانون عادل يرتضيه الفرد، ابتغاء منفعة مشتركة» (الجمهورية م١ ف٢٥). وان الملكية أفضل انظمة تالحكم ،ولا يوجد في الواقع نظام كامل أو نظام دائم، كل نظام فهو ينطوي على جرثومة فساد .وان أهم وظائف الدولة تأمين الجماعة من الخطر الداخلي والخطر الخارجي، فمن الوجهة الأولى تضطلع الدولة بالتشريع، أي بإقامة العدالة بين الأفراد، فلا قيمة للقانون الوضعي إلا إذا صدر طبقًا للعقل ولأجل الخير العام، طبقًا للقانون الطبيعي .
والقانون يظل لغوًا بغير جزاء، على القاضي تطبيق العدالة، ومراعاة الإنصاف دون التقيد بحرف القانون عند الاقتضاء، وتبرئة المتهم حين لا تقوم البينة على الذنب، فلأن يخطئ في حسن الظن بمجرم خيرٌ من أن يظلم بريئًا، ولا يدين القاضي بحسب اعتقاده الشخصي، بل بحسب ما تبين له باعتباره شخصًا عموميًّا، وهذا لا يمنعه من استخدام معارفه الخاصة لجلاء الحقيقة، فإن لم تنجلِ على النحو الذي يعلم، كان عليه أن يحكم بما ظهر أمامه فقط، أما العقاب فهو على العموم تعويض عن الذنب، ولكنه في هذه الحياة تأديب أيضًا، فهو رادع وإصلاح ، ومن ثمة عامل من عوامل السلام في المجتمع، وعقوبة الإعدام مشروعة .
ويطالب الاكوينى الرعية التقيد بوصية بولس الرسول فى رسالته إلى مؤمني روما- من منطلق أنّ الانصياع للحاكم يضمن حفظ الأمن داخل الحياة الجماعية، كما أنّ الفرد الواحد لا يضمن الأمان إلا داخل الجماعة، وعليه فإن وجود الدولة ضروريٌّ و يدخل في طبيعة الأشياء، وان إيمانهم المسيحى لا يُعفيهم من الخضوع لسلطة الحكم المدني، و مع ذلك، توجد حالات خاصة يحقّ فيها للمحكومين أن يتمرّدوا على الحاكم؛ فيقول: من الواجب على الحاكم أن يسعى إلى توفير الخير العام وإلى تحقيق العدالة التى تفترض وجود قوانين أزلية ، وهي قوانين تنبع من الحكمة الإلهية، و لذلك، يتوجب على القوانين الوضعية أن تستمد من القانون الإلهي حتّى تصبح هذه القوانين ملزمةً، وعليه، يملك الحاكم الحقّ في إصدار الأوامر إذا ما ظلّت ممارسة السلطة منسجمة مع القانون، أما إذا انتهك الحاكم القانون والعدالة، يحقّ للمحكومين أن يتمردوا على الحاكم، بل يجوز قتله أو نفيه، ولكنه أجاز ذلك فى حالتين : إذا ما اغتصب الحاكم السلطة واستولى عليها بالقوة من غير وجه حقّ، أو إذا ما أصدر الحاكم أوامر ظالمة، حتى وإن كان الجميع يعتر بأن حكمه شرعي . لكن قتل الطاغية أو الغاصب فغير جائز لفرد يقوم به من تلقاء نفسه، ولكن للشعب بأجمعه أو ممثلًا في مجلس مشروع أن يستعمل هذا الحق.
.وهو ما اعتمد عليه منظرى "لاهوت التحرير" الذى ظهر فى منتضف الستينينات فى القرن الماضى بامريكا اللاتينية فى تبرير الكفاح ضد الأنظمة الديكتاتورية والتى لا تراعى العدالة الاجتماعية .
استنتج مارتن لوثر (1483 – 1546) أب المذهب البروتستانتى مشروعيّة وجود السلطة الحاكمة، بناء على ماجاء في الرسالة إلى أهل روميه وعلى إباحة الاعتراض على الحاكم وعلى تشغيل الجنود المأجورين ، وقد قسّم الناسَ إلى فئة تنتمي إلى مملكة الله و فئة تنتمي إلى مملكة الدنيا. و من ينتمي إلى الفئة الأولى لا يحتاج إلى “السيف الدنيوي" .
وأوجب لوثر ضرورة الانصياع للسلطة الحاكمة على امتداد كتاباته اللاهوتية ، و من بين الأسباب التي ساقها ، حفظ السلم و النظام العام و كبح الشر. وعدم مقاومة الشر بالشر . ويجب علي المرء أن يمتثل لأوامر السلطة حينما تأمره بحمل السلاح ضدّ الأعداء، ما دام الحكام يسعون إلى استتباب الأمن. و قد يكون العنف أداة تحقيق ذلك، ما دام الشرع قد اجازه ولم يحرّمه. و هنا ميّز لوثر بوضوح بين حرية العقيدة و واجب الانصياع للسلطة. فالسلطة الدنيويّة ليست معنيّةً بعقيدة المؤمن و لا يحقّ للحاكم أن يفرض على المواطن اعتناق ديانة بعينها و لا أن يحارب الهرطقة. بالمقابل، لا يحقّ لرجال الكنيسة أن يتقلدوا وظائف سياسية تشكل سلطة.
يجب على الكنيسة ان تتجرد من كل مايمثل سلطة حتى فى نظامها ، فالمسيح و الرّسل لم يؤسّسوا كنيسةً، بل أسّسوا جماعة قائمة على المحبّة، و هي جماعة تقوم على وجود معلّمين و مريدين ، و لم تقم أبداً على علاقة حاكمين بمحكومين.
و عندما يتدخل الأمراء في شؤون الدين يحقّ للمؤمن أن يشقٌ عليهم عصا الطاعة، بينما لا يحقّ الاعتراض على قوانين الأمراء التي قد لا يرضى الله عنها، ما دامت في خدمة مصالح الدنيا ، لكنه لم يشجع على استخدام العنف .
فقد دعا سنة 1522 إلى عدم مواجهة الكاثوليك، ما دام التمرّد يصيب الأبرياء و المذنبين معاً ، و ما دام الله قد نهى عن التمرّد و العنف حتى لو كانوا على ضلال.
وتأتى كتابات اللاهوتى القبطى الارثوذكسى الاب متى المسكين(1919 – 2006) شيخ رهبان دير ابى مقار فى العصر الحديث فى هذا الشأن كراهب ناسك يعني بالجانب الروحي ، ورجل مصالحة بين الدولة المصرية والكنيسة فى وقت الازمات توافقية تبغى التوافق والانسجام بين الكنيسة والدولة ، حيث كتب ان للشخص المسيجى وطنيين ، أولهما الوطن السمائي، وثانيهما الوطن الأرضي .
فالوطن الأرضي هو المكان الذي ينمو فيه المسيحي ويحيا رسالته كأبن لله، هو المكان الذي فيه يظهر للعالم طبيعته التى تسلمها من المسيح ، الوطن السمائي هو مكان الاستقرار، هو البيت الأبدي الذي فيه سينال هذا الإنسان ما له، بنعمة البنوة. ونجد في تقسيم الأب متى المسكين للوطن السمائي والوطن الأرضي تشابهًا كبيرًا بينه وبين القديس أوغسطينوس فى كتابه " مدينة الله "؛ ربما استلهمه الاب متى المسكين من قراءة كتاب اغسطينوس "مدينة الله . إلا أن الجديد في تصور الأب متى المسكين هو أن الإثنين يكمل كل منهما الآخر، دون تغليب الواحد على الآخر. لكن يرفض الخلط بينهما ؛ فلكل منهما مجال، ولكل منهما اتجاه، ومهمه ، كما يرفض التقليل من شأن واحد على حساب الآخر. يقول الأب متى المسكين: "الوطن الأرضي ضرورة للإنسان؛ ليكون كاملًا جسديًا، كما أن الوطن السمائي ضرورة؛ ليكون كاملًا روحيًا أيضًا ، وكلاهما مطلوب من الشخص المسيحى" .
يحصر الاب متى مجال الدين فى خلاص الخاطئ – ملكوت الله – المناداه بالتوبة ، فهي مسئولة فقط عن المواطن نموه الروحي السليم. وذهب الاب متَّى إلى أن الكنيسة ليس لها اتجاه خاص في أنظمة الحكم، ولا تساند وضعًا اجتماعيًّا أو سياسيًّا، ولكن في الوقت نفسه تساند المواطن المسيحي، وتعطي له عطية عظيمة، ألا وهي «الحرية الكاملة»؛ كي يتصرف المواطن كيفما يشاء في أمور الدنيا حسب تقاليد المجتمع وأعرافه، وبما يتوافق مع الأخلاق السليمة.
فالمواطن يُسأل أمام الدولة عن تصرفاته، وإذا أخطأ فلن يصيب الكنيسة شرًا، وإنما سيتحمل عاره كمواطن مسيحي ، ولايدخل فى صميم رسالتها الخدمة الاجتماعية – حسب مفهومها العالمي – لكونها لا تقوم علي الشهادة للمسيح، ولا العطاء فيها يقوم علي اساس شركة الأخوة في المسيح، ولا المناداة بالتوبة، ولا علي الكرازة بالملكوت، ولا علي الصلاة المقتدرة ، ولأن الخدمات الاجتماعية لا علاقة لها بروح الكنيسة – تقوم بها الحكومات والتي لا تؤمن بالله . . ويؤكد على أن الدولة هي المسئولة عن ثقافة المواطن، وتربيته المدرسية، وبينما الكنيسة تعمل ماهو أعظم من ذلك ، فهى تقوم بتربيته الروحية والعمل فى أمور الدنيا حسب أصول الدنيا بأمانة وضمير حي مسيحى .
ويرى ان سلطة الكنيسة على المؤمن تنحصر فيما يختص بإيمانه، وعقيدته، وسلوكه الروحي. ولاتتدخل فى توجهه السياسى ، وإبداء الرأي، والاشتراك في كل ما يخص وطنه، في كل الأمور الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية على السواء، دون الرجوع إلى الكنيسة مادام يخاف الله . فخدمة الوطن الأرضي وساكنيه، ليست بواجب أخلاقي او فرض على المسيحي فقط، بل هذه الخدمة هي رسالة يظهر بها، وفي هذا الوطن، حب الله لمن يحيا معه.
المصادر :
-مدينة الله ، القديس اغسطينوس ، ترجمة الخور اسقف يوحنا الحلو ، دار المشرق اللبنانية 2004
-تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر الوسيط ، الفصل السابع القديس أغسطينوس ، المؤلف يوسف كرم ، القاهرة 1946
- ول ديورانت: قصة الحضارة ، ترجمة: محمد بدران ، (مكتبة الأسرة 2001) ، المجلد الثامن (15/16) ، ج 15 ، ص 11 و 12
-المصدر السابق ، الفصل التاسع القديستوما الاكوينى.
-إشكالية العدالة و الدولة و القانون في اللاهوت المسيحي في العصر الوسيط . المؤلف عز العرب لحكيم بنانى ، الناشروزارة الاوقاف والشئون الدينية ، سلطنة عمان 2015
-الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الاكوينى ، طبعة اولى 5 أجزاء ، ترجمة من اللاتينية المطران بولس عواد ، الناشر المطبعة الادبية ، بيروت 1882 – 1908
-الكنيسة والدولة ،الاب متى المسكين ، الناشردير انبا مقار ، الطبعة الثالثة 1969