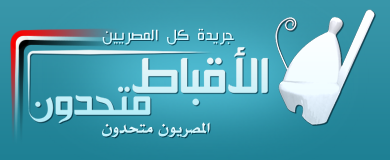جديد الموقع
الأكثر قراءة
- خواطر على هامش الانتخابات الرئاسية
- الديمقراطية دي تاعتي أنا
- مصدر لــ"الأقباط متحدون" : شفيق رئيسا للجمهورية بفارق 350 ألف صوت وحالة غضب تنتاب قيادات الجماعة
- الأرقام التي حصل عليها مرشحا الرئاسة و رأي الشعب في الصراع السياسي
- اللواء حمدي بخيت: الصدام بين العسكر والإخوان قادم لا محالة وسنضرب بيد من حديد على من يعبث بأمن مصر
مَسْخ الميدان من ثورة الصفوة إلى هوجة العوام
تختلف أو تتفق مع الدكتور محمد سليم العوا، فإن هذا لا يؤثر فى حقيقة ناصعة، هى أن هذا الرجل مثقف ملىء، وبليغ بلاغة حاضرة يعز وجودها فى زماننا، زمن هيمنة الركاكة، فى التعبير والتفكير. ولقد أطللت على ميدان التحرير هذا الثلاثاء، فشعرت بالأسف لما صار إليه الميدان، ونبتت فى ذهنى فكرة هذه المقالة. وعندما هممت بالكتابة، وجدتنى أبحث عن فقرة لفتت نظرى مما قاله وكتبه الدكتور العوا، ورأيتها خير استهلال أبدأ به، فهى تعبر عما يحرك الكاتب من دوافع، وعما يتحسَّب له من سوء فهم، وعما يقبض عليه من يقين برغم ذلك، تقول الفقرة:
المقالة. وعندما هممت بالكتابة، وجدتنى أبحث عن فقرة لفتت نظرى مما قاله وكتبه الدكتور العوا، ورأيتها خير استهلال أبدأ به، فهى تعبر عما يحرك الكاتب من دوافع، وعما يتحسَّب له من سوء فهم، وعما يقبض عليه من يقين برغم ذلك، تقول الفقرة:
 المقالة. وعندما هممت بالكتابة، وجدتنى أبحث عن فقرة لفتت نظرى مما قاله وكتبه الدكتور العوا، ورأيتها خير استهلال أبدأ به، فهى تعبر عما يحرك الكاتب من دوافع، وعما يتحسَّب له من سوء فهم، وعما يقبض عليه من يقين برغم ذلك، تقول الفقرة:
المقالة. وعندما هممت بالكتابة، وجدتنى أبحث عن فقرة لفتت نظرى مما قاله وكتبه الدكتور العوا، ورأيتها خير استهلال أبدأ به، فهى تعبر عما يحرك الكاتب من دوافع، وعما يتحسَّب له من سوء فهم، وعما يقبض عليه من يقين برغم ذلك، تقول الفقرة:«هناك من ينافق العوام وهناك من ينافق السلطان وهناك من يقول الحق فإن صادف أن الحق لا يعجب العوام فلا يجب أن يتهمه العوام بنفاق السلطان لأنهم فى هذه الحالة يريدون أن ينافقهم.. الحق حق.. أنا ضد نفاق السلطان وأيضا ضد نفاق العوام. ورحم الله الامام الغزالى الذى قال «نفاق العوام أشد من نفاق السلطان».
نعم نفاق العوام هو الأشد، لأنه مُشعِل للفتنة، والفتنة أشد قطعا من القتل، لكننى أضيف إلى ذلك شيئا آخر من خلال قناعة كونتها عبر عملى كطبيب نفسى لبعض الوقت، وكشغوف بالعلوم النفسية طول الوقت، وهذه القناعة تبلورها الآية الكريمة «ونفس وما سوَّاها فألهمها فجورها وتقواها»، فالنفس الإنسانية تنطوى على الخير والشر معا، على التقوى والفجور، على التسامى والانحطاط، على المتناقضات جميعا، وما طابعها الكُلِّى إلا محصلة نهائية للاختيار بين الأضاد. كذلك أرى مسألة العوام والصفوة، ولا أريد أن أقول النخبة لفرط ما تشوه هذا المصطلح وتم ابتذاله.
العوام والصفوة متناقضان لا يشيران فى رأيى إلى أنماط اجتماعية أو طبقية أو ثقافية، بل هما يشيران إلى «حالات» بشرية يمكن أن تتجلى فى الذات الفردية للأشخاص كما الذات الجمعية للحشود، يصطف بعضها فى سفوح الابتذال والهبوط، ويتسنم بعضها ذُرى الرقى والرفعة. فلا المستوى التعليمى ولا الاقتصادى ولا الاجتماعى يمكن أن يدل على هذا أو ذاك، وهى خبرة قريبة رأينا فيها وجوها وحناجر تطفو على سطح أيامنا الأخيرة، وتنصبُّ علينا من فوق المنابر المختلفة ومن خلال الشاشات والميكروفونات والمنشورات، قاصفة عقولنا ووجداننا بهذاءاتٍ لا معقولة، وأفكارٍ خرقاء، بعضها يلبس قناع السياسة، وبعضها يتلبس بلبوس الدين، وهى جميعا مما لا يمكن صدوره عن الصفوة، بالرغم من أن مُصْدِريها يكونون أساتذة جامعة أحيانا، ومنتمين لمهن مرموقة فى كثير من الأحيان، وليسوا من الفقراء ولا سكان العشوائيات أبدا. ومع ذلك هم عوام.
عوام فيهم هوج، وزعيق، وتعصب لرؤى أحادية النظرة وضيقة الأفق، ومنحازة بسوقيةٍ وعنفٍ كما أفراد العصابات، بلا إعمال لأفضل ما وهبه الله أيانا، العقل، والذى لا يكون عقلا إذا ما نزعنا عنه سمة التفكير النقدى فى البحث الدؤوب الصادق عن الحق، وهى سمة قد يفتقر إليها حامل دكتوراه ويتمتع بها أمى بسيط، فيكون الأول من العوام والثانى من الخواص أو الصفوة. وللأسف المرير، فإن معظم من سادوا حياتنا فى أعقاب أيام ثورة يناير الثمانية عشرة الراقية النبيلة كانوا من العوام بالمعنى الذى أشرت إليه. فقد باتت كلمة العوام هى العليا فى كل ما ران على حياتنا طوال هذه الشهور الخمسة عشر أو الستة عشر، ولو راجعنا كبوات هذه الشهور الطوال الثقال لاكتشفنا سطحية تفكير العوام وغوغائية العوام وهوج العوام وتعصب العوام وهياج العوام وابتذال العوام فى كل المنعطفات القاسية أو الدامية التى عصفت بنا.
التعديلات الدستورية التى نسفت أولوية الدستور كبداية مسيرة نحو الصعود الديمقراطى كانت تفكير عوام، بالرغم من أنها صدرت عن عقول من تُفترَض فى بعضهم صفة الصفوة، وكان التجييش لـ«نعم» فى الاستفتاء المشئوم فِعل عوامٍ لم يحفظوا للدين جلاله عندما زعموا أن «نعم» هى لله، وأسماها أحدهم «غزوة الصناديق» وعليها كانت جلافة الدعوة إلى أن من لا يعجبه ذلك من المصريين عليه أن يهاجر إلى مكان آخر، وكانت كندا هى المقترح الذى تكرَّم أحدهم به على المحرومين من رضاه المقدس، ثم توالى بعد ذلك العجب العجاب من الظاهرة «العواميَّة»، والتى أسهم فيها كل طيف سياسى، بلا استثناء، بقسط ملحوظ، وكذلك القائمين على الحكم.
لماذا حدث ذلك البروز لسلوك العوام فى هذه الفترة الهابطة فى أعقاب الصعود الراقى الذى تجلت به ثورة يناير فى أيامها الثمانية عشر المجيدة، والتى أذهلت العالم، بل أذهلتنا نحن أنفسنا عندما اكتشفنا فى دواخلنا، شعبا وجيشا، كل هذه الينابيع الصافية من عشق الحق والخير والجمال، والبسالة والنبالة التى رفعت فى الميدان رايات القيم الأخلاقية والإنسانية العليا فى مواجهة دولة الباطل والقبح والانحطاط، لماذا انحدرنا إلى اعتصامات غوغائية ومليونيات قندهارية وقطع إجرامى للطرق وجوائح سحل وتعرية وفقأ للعيون واستفزازات سياسية صبيانية لا معنى لها إلا عشق الصدام باسم الثورة؟
اجتهادى المتواضع فى تشخيص هذا الداء الذى مسخ ثورتنا إلى هوجة وحوَّل ميدانها إلى مُوُلِد أو سويقة، هو الإلحاح على طلب القوة دون الحق، والتنازع على اختطاف أكبر قطعة من كعكة الحكم لا التوافق على تكريس أعظم قدر من الحِكمة لجبر خاطر هذه الأمة المكلومة، ومن ثم كانت الأكاذيب التى استلزمت ارتداء شتى الأقنعة، بعضها دينى باسم الشريعة وبعضها دنيوى باسم الثورة، وطبيعى أن يكون فرسان هذه المعمعة هم الأكثر نرجسية والأشد تعصبا والأنكى فى ضيق الأفق والمراهقة السياسية، وهؤلاء جميعا ساهموا بسحرهم الأسود فى مسخ ميدان الثورة النبيلة إلى ساحة هوجة وبيلة، وكانت «مليونية» الثلاثاء الماضى طافحة بكل هذا الوَبَال، وإليكم بعض ملامحه:
● رجل بعيون ثعلب وابتسامة ثعلب، تخرَّص على البنين والبنات من شباب الثورة وأمعن فى الخوض فى أعراضهم بلا دليل ولا مبرر إلا الانتصار لذاته المُدَّعية، رأيته زعيما مرفوعا على الأعناق يهتف باسم ثورة يناير المصرية ويحارب بدماء شهدائها، بينما رأيناه فى هوجة الدعاية الانتخابية يجعر بعاصمة لمصر غير القاهرة، ولا يكف عن تقبيل أيادى الرائجين ورءوسهم بتواضع مفتعل يكشف عن خبايا عيون الثعلب وصفرة ابتسامة.
● زعيم من الوزن الثقيل الذى يستحيل رفعه على الأعناق، كشف عن نفسه بين فسطاطين لا ثالث لهما، إما أنه ابنٌ عاق أو أنه كاذبٌ مراوغ، وكلاهما فيما يدعو إليه من عظائم النفاق، كاد يورد أتباعه البسطاء موارد التهلكة، ويشعل حريق فتنة كبرى فى الوطن. ظهر أخيرا فى الميدان الذى سبق أن ترك اتباعه محشورين فيه، بل تنصل منهم عندما وقعت الواقعة، وكان أعجب وأكذب ما دعا إليه فى ظهوره الأخير الميمون هو تحريض المتظاهرين فى الميدان على الاعتصام والـ«مرابطة»، بينما الذاكرة القريبة لا تنسى أنه لم يرابط ولو ليلة واحدة فى هذا الميدان مع مناصريه الذين صدَّقوا كذبته، وعالج الكذبة بأكاذيب متسلسلة، منها وعكة ألزمته الفراش لكنها لم تحل بينه وبين الهرولة إلى شاشات «التوك شو» عندما دعاه داعى الظهور.
● ثوريون شباب لا ينكر لهم أحد دورهم كطليعة من طلائع التمهيد للثورة ثم الثبات الرائع فى ميدانها، تجمدوا على هتاف واحد ينادى بسقوط العسكر وتسليم السلطة فورا! فورا لمن؟ لا لأحد إلا للذين باعوهم بينما كانوا يُسحَلون وتُشوَّه صورتهم وسيرتهم، هؤلاء الذين عندما تمكنوا من برلمان جأروا بأن الشرعية للبرلمان لا للميدان، وعندما طار بحكم قانونى برلمانهم الذى كان مسخرة تاريخية فى كثير من مشاهد أعضائه تحت القبة وخارجها، عادوا يستقوون بالميدان. الميدان الذى جمع بين الحابل والنابل على صيحة واحدة كانت تخرج من الحلوق، لا من الصدور النقية والقلوب الحسنة كما كان هتاف الميدان فى أيام الثورة الخوالى الأولى «إيد واحدة.. إيد واحدة».
هذا ليس ميدان التحرير الذى عُرِف بالثورة وعُرِفت به، وكان بحيرة خير جامعة تنصب فيه موجات الثائرين بتلقائية القلوب العطشى للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكل المصريين دون تفرقة ولا تمييز، صار مستنقعا للاستقطاب والتحشيد تصب فيه الأتوبيسات القادمة من كل حدب وصوب حمولاتها البشرية المدفوعة بأوامر السمع والطاعة، لاستعراض القوة وممارسة الضغوط السياسية، لا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كأساس، بل من أجل «التمكين» من السلطة كهدف وغاية، وهو تمكين لن يتمخض إلا عن إقصاء جديد وتكويش متجدد، مادامت شهوة الحصول على القوة تفوق صبوة الوصول إلى الحق.
هذا ميدان الهوجة لا الثورة. ميدان صراع العوام على السلطة. فلا كانت الهوجة، ولا كان العوام.
نقلا عن الشروق
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :