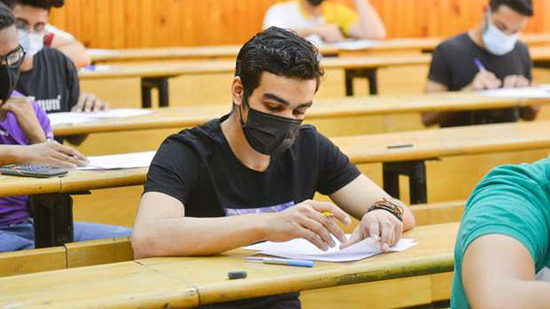ماهر عزيز بدروس
توطدت علاقتى بصيدلى مثقف يخدم في كنيسة قائمة بإحدى ضواحى القاهرة، ولما تعرف على خدمتى السابقة بإحدى كنائس شبرا مصر، كأمين عام الخدمة في مطلع التسعينيات، وعلى أثر مناقشات جريئة في معطبات التعليم الكنسى والنقد الدينى، دعانى لألقى محاضرة على اجتماع الخدام والخادمات بكنيسته وترك لى اختيار الموضوع.
وقع اختيارى على موضوع كنت منشغلاً به آنذاك وهو: "فيم يكون المؤمنون شركاء مع اللـه؟"
وقدمت له عنوان المحاضرة: "شركاء مع اللـه"، التي كانت بحثاً لاهوتياً مصغراً في الكتاب المقدس، والتراث اللاهوتى، عن "الشركة مع اللـه".
كان أحد مراجعى المهمة كتاب للأب "متى المسكين" بعنوان: "الإيمان بالمسيح".. وكانت مقدمة الكتاب التي لم تزد على اثنتى عشرة صفحة من القطع الصغير بالنسبة لى حينها قطعة ذهبية في اللاهوت المسيحى، الذى يؤصل للفهم الكتابى للتثليث والتوحيد، خاصة فيما يرتبط بالعلاقة الأزلية بين الأبوة والنبوة، والحياة القائمة الفعالة المنبثقة من الآب لتنصَبّ في الابن، التي صنعت مماثلة قوية بعلاقة الأبوة بالنبوة في الذات البشرية.
ولقد استعنت بمقدمة الكتاب في شرح أحد محاور محاضرتى المعنون: "شركاء في التثليث والتوحيد"، وكان لابد أن أذكر مرجعى في ذلك: كتاب "الإيمان بالمسيح" للأب "متى المسكين"، كعهدى دائماً في البحث العلمى النزيه لإثبات المراجع التي يرجع إليها البحث، حفاظاً على الحقوق الفكرية والأمانة العلمية.
وإذ بلغت هذا الحد في محاضرتى التي حضرها آباء الكنيسة الثلاثة، وقف كبيرهم وانتزع الميكروفون من يدى ليخاطب جمهور الخدام والخادمات أمامى قائلاً: "سيادته ذكر اسماً لم يذكر في هذه الكنيسة منذ خمسة وعشرين عاماً، ولن يذكر ثانية البتَّة، وكل كتب هذا الاسم مُحَرَمَة، والرجوع إليها خطيئة كبرى ضد الكنيسة وضد الأرثوذكسية".. وكأنه بذلك يدفع عن نفسه وعن كنيسته تهمة نكراء بشعه تضعه رغماً عنه في قفص الاتهام، فأخذت الميكروفون منه وعَقَّبت: "في حدود علمى لم يصدر بيان كنسى – بابوى أو مجمعى – يُحَرِّم كتب الأب "متى المسكين"، ولا يمكن في مسألة توقيع الحرم على كل كتبه أن يؤخذ بكلام تتداوله الشفاه نقلاً واحداً عن واحد، وإذا صح هذا الكلام فهو ليس إلا عودة إلى محاكم التفتيش والجهل".
لكننى أكملت محاضرتى في جو مُكْفَهِرّ، وقد تكدرت تماماً، وتكدَّر العديدون أيضاً من المستمعين لمحاضرتى.
لم أكن قد وقفت حتى هذه اللحظة على عمق الأزمة الموجهة للأب "متى المسكين".. أو قل عمق الصراع الذى تعيشه الكنيسة القبطية آنذاك..
وانتبهت بعد ذلك إلى تَعَقُب هذا الصراع في وجوهه المختلفة، فإذا بأهوال الانقسام والتكفير والقذف بالهرطقة وروح محاكم التفتيش تتبدى أمامى وأنا غائب عنها..
لقد تفتحت عيون جيلى على كتابات الأب "متى المسكين" بوصفها ملاذ الرصانة الفكرية في العرض الدينى لأفكار اللاهوت والإيمان، وكان المثقفون منا يجدون ضالتهم في أسلوبه الذى يحترم عقل القارئ بنسق فكرى يعتمد الكتابة الجادة، والتعبيرات غير المستهلكة، والاجتهاد الواضح في تقديم العقل، ولذلك أحبه طلائع الخدام والخادمات في جيلى، ونظروه معلماً فكرياً لاهوتياً وروحياً جليلاً..
كان الأب "متى المسكين" قد نجح في تحويل دير "الأنبا مقار" ببرية شيهيت إلى قلعة للفكر الدينى والريادة العقلية للروح والإيمان، واستطاع أن يؤسس مدرسة فكرية وبحثية متقدمة في قضايا الإيمان واللاهوت، وقد ترابط أعضاء هذه المدرسة ترابطاً متسقاً كما فى هارمونى متماسك لإبداع البحوث المعمقة، فتتابعت الكتب المرجعية الموثقة في الصدور لتشبع نهم المتعطشين إلى البحث العلمى اللاهوتى والدينى الرصين، وراحت رفوف المكتبة القبطية تزخر بأعمال تمتاز بالجدة والعمق، بدءًا من "حياة الصلاة الأرثوذكسية" (1952)، ومروراً "بالقديس أثناسيوس الرسولى" (1981)، وانتهاءً "بشرح الرسالة الأولى للقديس بطرس الرسول" (2004)، و"مع المسيح" (في أربعة مجلدات – 2005/2006).
وقد كان يوظف تلامذته النبهاء من الرهبان في تجهيز الترجمات والتوثيقات والمباحث اللازمة لإعداد هذه الكتب، التي يضع هو عليها في النهاية بصمته الفكرية المميزة في الصياغة اللفظية، والمنطق الكتابى، والرؤية الروحية، والإدراك اللاهوتى، والرسالة العقلية، والتصحيف والتبويب.
بين الإيمان والهرطقة: من أين عقروه؟
فى جميع كتاباته كان الأب "متى المسكين" يحاول دائماً أن يجدد في الصياغات الموروثة من الجيل الآبائى الأول، والتي لم يجرؤ على الخروج منها مفكر دينى أرثوذكسى حتى بدأ هو يكتب.
وفى كتابته كانت قدرته اللغوية، وثقافته الكتابية والعامة، رَاِئُدُهُ في التعبير الكتابى واللاهوتى، الذى عمد كذلك إلى التجديد فيه، لكنه في غمرة سعيه للتجديد التعبيرى في الروحيات واللاهوتيات، وفى مطاوعته لرغبته العارمة في الإبداع الذى يكسر رتابة الإكليشيهات المحفوظة - التي فقدت جدتها وفاعليتها عبر الاستخدام المتواتر، وصارت تعبيرات مسكينة فارقتها الحياة - أقول في غمار محاولته أن يَبُثَّ أقوالاً جديدة لم يفسدها الترديد المتكرر، وأن يبتكر صياغات محدثة بكل نضارتها الأولى، فاته أن مساحة الإبداع في التعبير اللاهوتى محدودة جداً، وأن سليقة الإبداع الأدبى لا يمكن أن تفعل فعلها في اللاهوت كما في الأدب الدينى أو التأملات..
وهنا سقطت منه تعبيرات لاهوتية غير دقيقة عديدة أخذوها عليه وعقروه بها.. فكان من أغرب الاتهامات التي وجهت إليه الاتهام بالهرطقة، الذى أراد مخالفوه ومبغضوه أن يلصقوه به، ليقضوا به على تاريخه الروحى واللاهوتى والرهبانى كله، ويقتلوا به أثره الذى تركه في كتاباته لتجديد الفكر والوعى الكنسى، وهو التاريخ الذى لا يناقضه إلا مكابر، ولا ينقضه إلا جهول، ويحتفى به العالم كله الذى نقلتْ إليه الترجمةُ جُلّ الإنتاج الفكرى، والروحى واللاهوتى، للأب "متى المسكين"..
ولقد أَمْسَكْتُ بمجلة الكرازة التي تصدر عن المقر البابوى أيام احتدمت على الأب "متى المسكين" حرب الاتهام بالهرطقة، وهى المجلة التي نشرت سلسلة مقالات هجومية اتهامية متجنية أطلقها عليه السوط اللاهب الطاغى بالمفتريات الكنسية التي طالت الكثيرين في ذلك الوقت الحزين.. السوط اللاهب الطاغى للأسقف الذى وضعته المقادير الظالمة على رأس فريق محكمة التفتيش، ليلهب باتهاماته الباطلة ظهر الأمناء المجتهدين، ويقصيهم عن الكرامة الكنسية، ويشوه شخوصهم، وينال منهم، ويحذفهم باتهامات الهرطقة من سِفْرِ التاريخ..
أقول أَمْسَكْتُ بمجلة الكرازة لأتمعن أحد مقالات القذف بالهرطقة اللاهوتية للأب "متى المسكين"، فوجدت أن ما يربو على 95% منها لا تزيد على كونها مماحكات لفظية، و5% الباقية هي محاولات الأب "المسكين" للتجديد اللاهوتى، فأغلقوا عليه الفخ!!
لكن الذين عاصروا الأحداث السياسية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة للرئيس السادات، يدركون أن "العقرة اللاهوتية" التي عقروا بها الأب "متى المسكين" ربما تعود في الأصل إلى "العقرة السياسية" التي ظنوا أنه قد جَرَحَهُم بها، وهو منها براء!!
فلقد أراد الرئيس السادات وجهاً وجيهاً في الإكليروس القبطى يتعامل معه بديلاً لبابا القبط الذى زج به في الإقامة المحددة آنذاك بأحد الأديرة على سبيل الاعتقال، ووجد في الأب "متى المسكين" ضالته المنشودة، انطلاقاً من الفكرة التي سادت منذ حركة يوليو للضباط الأحرار، التي اعتبرت الأقباط مجرد "ملف أمن دولة" محفوظ في أدراج العنصرية، ومفتاحه الوحيد هو البابا الذى إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على الأقباط جميعاً، لأنه "الإمام" الأوحد الذى يدينون له بالولاء، ويقدسه القبط تقديساً مهولاً لوضعه الدينى على رأس الكنيسة، بقوة تراث دينى مهول يغرس إليهم أنه "ممثل المسيح على الأرض"، بحسب التلقين المغلوط، والتقليد الدينى العقيم المتوارث في التعظيم الأخرق للإكليروس، خصماً من التمجيد الوحيد للائق بالسيد المسيح.
لكن الأب "المسكين" كان أميناً للبابا وللكنيسة، فأفهم رئيس البلاد أن البابا لا يمكن لأحد من الإكليروس أن يحل محله أو يقوم مقامه – مهما كانت الظروف – طالما هو حَيُّ على رأس الكنيسة، واقترح عليه مجلساً من خمسة أساقفة لإدارة شئون الكنيسة في غيبة البابا لا يكون "المسكين" نفسه واحداً منهم، وهو ما أخذ به الرئيس السادات..
لكنهم أحكموا ظنونهم الفقيرة حول شخص الأب "المسكين"، متهمين إياه بالتقرب إلى رئيس البلاد على حساب شخص البابا، وبأنه قد عقرهم "عقرة سياسية" راحوا ينتقمون منه بعدها بأن عقروه "عقرتهم اللاهوتية"، رغم شهادة الكثيرين حينها بأن اقتراب الأب "المسكين" من رئيس البلاد قد أعفى الكنيسة والشعب القبطى الكثير من الويلات.
بين الواقع والأسطورة: التهويل والتهوين
عاش الأب "متى المسكين" رجلاً طبيعياً مسيحياً ملتزماً يحاول أن يجتهد في محيطه برسالة الحداثة والاستنارة الروحية، واجتهد بالأكثر في جعل رؤاه الفكرية والروحية تتجسد في الواقع ونفس الأمر..
كان يرى في نفسه صاحب رسالة محملاً بواجب مهم عليه أن ينفذه في الواقع الكنسى الذى ينتظر النهضة.. فجدد في الرهبنة بديره على مثال التجارب التاريخية الأولى التي عكست مجد المدرسة اللاهوتية بأيدى اللاهوتيين الكبار أمثال أوريجانوس وإكليمنضس السكندرى، مرتكزاً على أسس البحث والدرس والفاعلية الفكرية والروحية، فطبع الرهبنة في دير أبى مقار بطابعه المجدد..
وقد صَدَرَ في ذلك عن رؤيا تجديدية للرهبنة القبطية، تخرجها من الأمراض المزمنة التي تحالفت عليها عبر التاريخ، والتي لم تدم طويلاً للأسف بفعل التربص العدائى تجاهه من قِبَل أقطاب الكنيسة، الذين استشعروا خطراً عليهم من جراء محاولته التجددية، فعمدوا إلى تخريب تجربته وتشويهها، بزرع شيطانى في ديره، ببعض لاعبى الرهبنة التقليدية، فنخروا بأمراضها المزمنة عظام التجددية بالدير العتيد!!
ولقد قادته تجربته في تجديد الرهبنة القبطية في دير أبى مقار إلى تجربته الثرية في التجديد اللاهوتى القائم على البحث والدرس والتأصيل العلمى للفكر الدينى، مستعيناً في ذلك بمدرسته الفكرية اللاهوتية ذاتها التي أراد أن يطبع بها الحياة الديرية في دير أبى مقار..
ولكنه كرجل طبيعى كانت له كذلك بعض الأخطاء المنهجية والإدارية.. فلقد ساق الرهبان في الدير – على سبيل المثال – على نحو لم يجعل من المساواة في التعامل الراية التي ترفرف على الدير كله، حتى لقد قهر ثلاثة من الرهبان في ليلة ليلاء على الفرار من الدير في منتصف الليل سيراً على الأقدام من برية شيهيت إلى القاهرة، وواحداً منهم كان من أعز اصدقائى، وكان من المقربين جداً إليه!!!
ولقد حابى كذلك وجوهاً عديدة لأجل مطامح وضعية مختلفة..
أما أن تدور ماكينة التعظيم الرهيبة فتظل تدور وتدور حتى ترفعه إلى القداسة التي تتصاغر أمامها كل النفوس، فيبدأ صنع الأسطورة الشعبوية التي يصير بمقتضاها الشخص الطبيعى شخصاً خيالياً لا يمكن أن يدركه عقل بشر لمجرد انخراطه في الرهبنة، فذلك هو بعينه الجنون الذى عمل في الكثيرين منذ ألفى سنة مضت حتى اليوم.. وهو الجنون الذى آن له أن ينتهى الآن وإلى الأبد وإلى غير رجعة!!!
والظاهر أنه من حسن المقادير أن الخلاف عليه لم يعجل بصنع خرافة القداسة حوله سوى بين الكثيرين من مريديه، الذين تسوقهم جسدانيتهم الطبيعية إلى تعظيمه، ليتحصنوا في قداسة تخيلية يقحمونها عليه، ليكونوا هم أيضاً تلاميذ القداسة.. وجه آخر من الخبل الروحى حتى بين المثقفين!!
على أن المقادير الحسنة في عصرنا الراهن، التي أَلَمَّت بنا على رؤوس كل الأشهاد، قد أشهدتنا كذلك على الكيفية التي تتم بها صناعة أسطورة القداسة حول أناس عاديين عاشوا بيننا وعاصرنا نقائصهم المدمرة، التي ما فتئت أن تحولت إلى قداسة خادعة مزعومة بمجرد رحيلهم، بصناعة رخيصة مبذلة من مناصريهم، الذين رأوا أن قيمتهم الذاتية هم أنفسهم تتعاظم وحدها بصنع الأسطورة الخيالية والتمسح فيها.. ينطلقون في ذلك من إرث هائل يحوط بهم ويدفعهم.. تسلموه بأساطير القداسة المنسوجة على غياهب التاريخ..
بل إن من بين هؤلاء الناس العاديين الذين عاشوا بيننا من ثَبُتَ عليه خلال التحقيق بين الرهبان في جريمة قتل أنه عاش الدنس والزنى والشذوذ والمتاجرة الخسيسة بالمال والعلاقات المخجلة.. ثم عند موته وقف أسقف خطير بحجم أسقف أورشليم ليملأ الدنيا بخداعية مذهلة في صنع القداسة الملعونة، فادعى أن أحداً من معارفه أبلغه أنه رأى في منامه أن السماء مفتوحة تستقبل هذا الراهب الراحل – لأنه تاب – بجيوش المنتقلين، وعلى رأسهم السيدة العذراء مريم، ليصرخ الملايين في كل الأرض من المغيبين المخبولين بأحلام القداسة الملعونة: "ياللقديس العظيم"!!
هكذا يتضافر الجهل والجسدانية والخبل المقدس في صنع أسطورة القداسة لأناس عاديين عاصرناهم بين ظهرانينا، ولم يظهر يوماً أي دليل عليهم للقداسة الخيالية!!
لكن الأب "متى المسكين" الجليل سيبقى له مجده المحفوظ على التاريخ، بأنه المفكر المجدد في الكنيسة القبطية، واللاهوتى الأرثوذكسى المجتهد صاحب التنبيه الفاعل للعقل القبطى المعاصر من غفلته، التي طالت ردحاً كبيراً من الزمن، وسفير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى كنائس العالم قاطبة بكتاباته المترجمة إلى لغات الأرض الحية في معاهد وكليات اللاهوت.. والراهب الذى ترك للرهبنة تجربته الواعية الواقعية لعهد جديد قد تتطهر فيه من كل ما علق بها منذ تأسست حتى اليوم من مثالب وأوجاع.
إن أعظم تكريم للأب "متى المسكين" هو الاحتفاظ به رجلاً طبيعياً أميناً في الاجتهاد لأجل الله والكنيسة، بعيداً عن الاتهام بالقداسة التي تخلعه من عالم البشر الرواد إلى عالم الافتراء على اللـه..