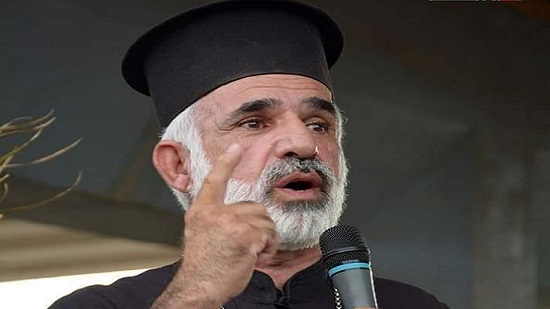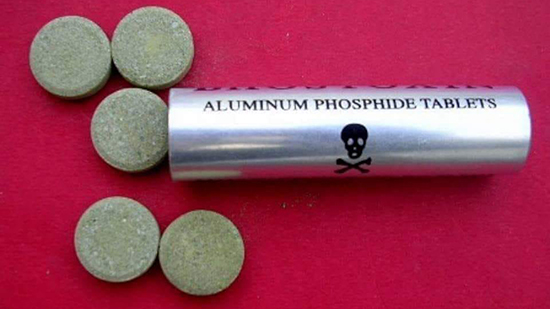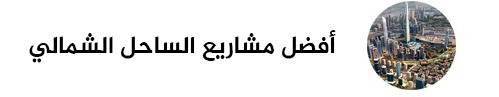د. جهاد عودة
على مدى العقد الماضي، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة وبعيدة المدى ساهمت في مستويات غير مسبوقة من التقلب وعدم اليقين. أعادت بعض هذه التحولات تشكيل العديد من السمات التقليدية للنظام الجوبلوتيكى المعمول به في المنطقة لعقود، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه القدرة على القيام بذلك في المستقبل القريب. تعمل المنافسة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الإقليمية، وكذلك المخاطر الجديدة من قبل القوى العالمية الناشئة، على إعادة تحديد ملامح الجغرافيا السياسية الإقليمية والطريقة التي ترتبط بها هذه المنطقة بالاتجاهات العالمية الأوسع.
على مدى العقد الماضي، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة وبعيدة المدى ساهمت في مستويات غير مسبوقة من التقلب وعدم اليقين. أعادت بعض هذه التحولات تشكيل العديد من السمات التقليدية للنظام الجوبلوتيكى المعمول به في المنطقة لعقود، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه القدرة على القيام بذلك في المستقبل القريب. تعمل المنافسة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الإقليمية، وكذلك المخاطر الجديدة من قبل القوى العالمية الناشئة، على إعادة تحديد ملامح الجغرافيا السياسية الإقليمية والطريقة التي ترتبط بها هذه المنطقة بالاتجاهات العالمية الأوسع.
إن الأهمية الجيوسياسية للبنى التحتية ليست شيئًا جديدًا، كما يتضح من المنافسة المستمرة منذ قرون للسيطرة على بعض الممرات الاستراتيجية مثل مضيق جبل طارق والبوسفور والدردنيل ومضيق هرمز، مضيق تيران أو قناة السويس. مع الاعتراف ببعض السمات الثابتة، يأخذ تحليلنا في الاعتبار أيضًا تأثير الاتجاهات الجديدة على المستويين العالمي والإقليمي. علاوة على ذلك، في حين أن دراسة البنى التحتية كانت سمة رئيسية في الجيوبلتكس الكلاسيكية، هناك جوانب مرتبطة غالبًا جيوبلوتكس الحاسمة – جيوبلوتكس للتعاون وأهمية الجهات الفاعلة بخلاف الدول مثل الشركات عبر الوطنية أو المدن أو مجموعات المجتمع المدني لتوفير بعض الأمثلة. على الصعيد العالمي، يعد الاتصال والرقمنة اتجاهين لا رجعة فيهما. نتيجة للعولمة والعوامل التمكينية التكنولوجية، أصبح الأفراد ومراكز الإنتاج مرتبطين بشكل متزايد من خلال الشبكات المادية والافتراضية. لقد أصبح ضمان السيطرة على وسائل نقل البضائع والمعلومات لا يقل أهمية عن السيطرة الإقليمية، إن لم يكن أكثر من ذلك.
لقد أدخل Covid-19 بعض الفروق الدقيقة، حيث يجري نقاش حيوي حول إمكانية اتجاهات إلغاء العولمة، ونهاية عصر النقل إلى الخارج والحاجة إلى تقصير سلاسل التوريد، والتي يمكن أن يكون لها آثار هائلة على مشاريع تطوير البنية التحتية. اذا حدث هذا، سيزيد من أهمية مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يتعلق بآثار الرقمنة، وعلى نطاق أوسع، ما يشار إليه غالبًا بالثورة الصناعية الرابعة، فإن أهمها هو أن البنى التحتية الافتراضية والتحكم في الفضاء الإلكتروني أصبحت بالغة الأهمية مثل الموانئ أو الجسور أو الطرق. وقد أدى ذلك إلى تغيير استراتيجيات الجهات الفاعلة التي تتمثل مهمتها في حماية الأمن القومي أو السلع العالمية وكذلك أولويات أولئك الذين يحاولون تعطيلها.
على الصعيد العالمي، تشمل الاتجاهات الأخرى التي يجب مراعاتها عملية إزالة الكربون بسبب زيادة الوعي البيئي وتأثير تغير المناخ، والتغيرات التكنولوجية السريعة في كفاءة وتكلفة الطاقات النظيفة. سيكون لهذا آثار كبيرة عندما يتعلق الأمر بمركزية البنى التحتية للطاقة مثل خطوط الأنابيب أو المصافي وسيغير أيضًا طرق التجارة البحرية. على الرغم من أن هذا يمثل اتجاهًا عالميًا، إلا أن آثاره ستكون أكثر صعوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ثقل الهيدروكربونات في اقتصاديات العديد من بلدانها. أخيرًا، تأخذ هذه الدراسة أيضًا في الاعتبار تحولات القوة العالمية، وبشكل أكثر تحديدًا، صعود القوى غير الغربية في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أصبح دور الصين وروسيا في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا الآن مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد تصبح الهند أيضًا لاعبًا مهمًا في العقود القادمة. في كل هذه السياقات، تلعب البنى التحتية – العسكرية أو المدنية، المادية أو الافتراضية – دورًا رئيسيًا. ستكون آثاره أكثر صعوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ثقل الهيدروكربونات في اقتصادات العديد من بلدانها. أخيرًا، تأخذ هذه الدراسة أيضًا في الاعتبار تحولات القوة العالمية، وبشكل أكثر تحديدًا، صعود القوى غير الغربية في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أصبح دور الصين وروسيا في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا الآن مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد تصبح الهند أيضًا لاعبًا مهمًا في العقود القادمة. في كل هذه السياقات، تلعب البنى التحتية – العسكرية أو المدنية، المادية أو الافتراضية – دورًا رئيسيًا. ستكون آثاره أكثر صعوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب ثقل الهيدروكربونات في اقتصادات العديد من بلدانها. أخيرًا، تأخذ هذه الدراسة أيضًا في الاعتبار تحولات القوة العالمية، وبشكل أكثر تحديدًا، صعود القوى غير الغربية في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أصبح دور الصين وروسيا في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا الآن مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد تصبح الهند أيضًا لاعبًا مهمًا في العقود القادمة. في كل هذه السياقات، تلعب البنى التحتية – العسكرية أو المدنية، المادية أو الافتراضية – دورًا رئيسيًا. أصبح دور الصين وروسيا في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا الآن مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد تصبح الهند أيضًا لاعبًا مهمًا في العقود القادمة. في كل هذه السياقات، تلعب البنى التحتية – العسكرية أو المدنية، المادية أو الافتراضية – دورًا رئيسيًا. أصبح دور الصين وروسيا في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا الآن مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد تصبح الهند أيضًا لاعبًا مهمًا في العقود القادمة. في كل هذه السياقات، تلعب البنى التحتية – العسكرية أو المدنية، المادية أو الافتراضية – دورًا رئيسيًا.
1- تعكس دراسة الطاقة والبنى التحتية هذه تأثير الديناميكيات الإقليمية الرئيسية في ثلاثة جوانب. أولاً، إلى جانب منافسة القوى العالمية، شهدنا تنافسات إقليمية أكثر حدة وتشكيل تحالفات معادية من الجهات الفاعلة الإقليمية وخارج الإقليمية. لجأت القوى الإقليمية الطموحة التقليدية والجديدة إلى مشاريع البنية التحتية لإظهار قوتها و / أو زيادة نفوذها و / أو بناء علاقات خاصة مع القوى العالمية. تقدم هذه الدراسة العديد من الأمثلة على هذا الاتجاه. ثانيًا، هناك سمة أخرى تتمثل في حقيقة أن حدود المنطقة غير واضحة بشكل متزايد. لم يكن هناك اتفاق على الإطلاق حول المكان الذي تبدأ منه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تنتهي، ولا يوجد تعريف توافقي حول من هو داخل ومن يخرج. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، يغير الترابط بين المغرب العربي والساحل والفكرة الكاملة لوجود منطقة البحر الأحمر التي تشمل جزءًا من الشرق الأوسط والقرن الأفريقي الطريقة التي تتم بها مناقشة العديد من الجوانب. تعتبر البنى التحتية من أوضح الأمثلة وفي نفس الوقت محرك رئيسي لهذا الاتجاه. أخيرًا، هناك اتجاه ثالث يشكل الجيوبلتكس الإقليمية وهو العسكرة، الناتجة عن أجهزة أمنية قوية وذات مغزى سياسي تقليديًا، وسباق تسلح متزايد وانتشار الصراعات في جميع أنحاء المنطقة. في ضوء هذا الاتجاه، فإن أوجه التآزر بين البنى التحتية البحرية المدنية والعسكرية وتسليح الفضاء الرقمي هي قضايا تستحق الاستكشاف. على الرغم من أن البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبطة بشكل عام بالتوتر والتنافس والصراع، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا حافزًا لخفض التصعيد والتعاون والسلام.
يمكن أن يؤدي تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة إلى تقليل تكاليف الطاقة وتنويع العملاء والموردين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs). في ظل ظروف معينة، يمكن حتى التعامل مع البنى التحتية كإجراء لبناء الثقة ويمكن للجهات الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي (EU) تقديم مساهمة إيجابية وبناءة لتعزيز «التفكير الجيوسياسي التعاوني» على النزاع الذي يهيمن حاليًا على النقاش من خلال الاستثمار في البنى التحتية. في هذا المجال، يمكن أن يضيف الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة في ضوء سجله الحافل بالاستفادة من البنية التحتية الحيوية لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فيه. من الشبكات والكابلات إلى الطرق وشبكات النقل، يعد مستوى الاعتماد المتبادل الذي وصلت إليه الدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية أحد أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أحد أهم عوامل التمكين لحرية حركة البضائع (سواء المادية أو غير مادي) والناس. بالانتقال إلى البعد الخارجي، تلعب البنى التحتية دورًا أساسيًا في سياق علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه وجيرانه. على هذا النحو، يشيرون أيضًا بقوة إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على حسن سير البنى التحتية الحيوية لأمنه وتنميته.

في ضوء القرب الجغرافي وأنماط التعاون الوظيفي، تخلق البنى التحتية لمنطقة الشرق الأوسط فرصًا وتحديات لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه نتيجة للاتجاهات الإقليمية والعالمية المذكورة أعلاه. أولاً، تمثل البنى التحتية الحيوية في المنطقة – مثل خطوط الأنابيب والكابلات الرقمية والموانئ والمرافق الداخلية – أصولاً استراتيجية لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك المصادر المحتملة للتوتر بسبب النزاعات والتوترات والمنافسة الإقليمية والدولية حولها. يخشى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حدوث اضطرابات كبيرة في البنى التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأنها يمكن أن تعرض أمن مواطنيها وإنتاجهم واقتصاداتهم للخطر. البنى التحتية للطاقة والنقل، مثل الموانئ والطرق البحرية السريعة وخطوط الأنابيب والشبكات، محطات النفط والغاز الطبيعي المسال البحرية والبرية، ونقاط الاختناق البحرية في المنطقة معرضة بشكل متزايد للاضطرابات بسبب الصراعات والتوترات الجيوسياسية، أولاً وقبل كل شيء تلك التي تتمركز في منطقة الخليج. وهذا بدوره له تداعيات على أوروبا. وبالمثل، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة الصين على مصالحها الاقتصادية وشكل الحكم القائم على القواعد، والذي يستغل أيضًا البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كميدان معركة رئيسي. ثانيًا، تعد بعض هذه المجالات جديدة إلى حد ما بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه حيث لا يزال يكافح من أجل تطوير تشريعات متطورة وأدوات مناسبة للتعامل مع التحديات الناشئة عن انتهاك حقوق المواطنين أو الشركات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالاستخدام. من هذه البنى التحتية.
على هذه الخلفية، تخلق جيوبلتكس للبنى التحتية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عددًا من التحديات أمام الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تفتح أيضًا فرصًا ملموسة للانتقال من الصراع إلى التعاون ومن التجزئة إلى التكامل. أولاً، تسمح البنى التحتية بالفعل بتعزيز المنطق التعاوني عندما يتم ترويض النزاعات الأيديولوجية والسياسية. بالبناء مرة أخرى على تاريخ التكامل الناجح للاتحاد الأوروبي بدءًا من التطوير والشعور بالملكية للبنى التحتية المشتركة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتوسط في مشاريع البنية التحتية عبر الحدود كوسيلة لتهدئة التوترات ولإيجاد أرضية مشتركة قائمة على المصالح الملموسة. ثانيًا، يتيح التعامل مع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة متنوعة من اللاعبين على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المؤسسات فوق الوطنية، والسلطات الوطنية. لا يمكن اغتنام هذه الفرص إلا إذا أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر جدية بشأن رغبته وطموحه – على النحو الذي حدده الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دن لين – ليكون لاعبا جيوبلوتكيا. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني هذا تنمية رؤية جيوبلوتكيه أوسع تنطوي على استخدام الأدوات والسياسات التي تعالج النزاعات (المحتملة) من جذورها، ليس فقط لمنعها ولكن أيضًا لإدارة – ومحاولة وضع حد – للعنف و الاضطراب الذي يحملونه معهم بمجرد أن يبدأوا في الحركة. باختصار، هذا يعني لعب دور جيوببلوتكى أكثر قوة من خلال حل النزاعات بجانب إدارة الأزمات، وهو ما يقوم به الاتحاد الأوروبي بالفعل. بهذه الطريقة، سيكون الاتحاد الأوروبي أكثر استعدادًا لإدارة الأهمية الجيوسياسية للبنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قام الاتحاد الأوروبي بوضع جديد للبناء على استراتيجياته الحالية والمستقبلية للمساهمة في النمو المستدام والسلمي واستخدام البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وكذلك خلق الحوافز للتعاون والتقارب. سيكون النهج الإقليمي للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجغرافيا السياسية للبنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفتاحًا للنجاح حيث يمكن الاستفادة من سياسات التجارة والاستثمار والطاقة والاتصال بشكل أكثر استراتيجية ونجاحًا ضمن مجموعة أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة. إن الوباء الحالي سيؤخر مثل هذه التطورات لكنه لن يوقفها تمامًا.
على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تعزيز الموقع الاستراتيجي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط على الخرائط العالمية: مع نمو بنسبة 477٪ في كمية البضائع التي تتداولها موانئها بين عامي 1995 و 2018، تخدم منطقة البحر الأبيض المتوسط حاليًا 20٪ من الشحن العالمي2. اعتبارًا من اليوم، لا يوجد طريق بديل فعال مثل البحر الأبيض المتوسط لربط آسيا بأوروبا. يمكن القول إن ضمان هذا الممر وسط التوترات الأمنية المستمرة في الخليج العربي سيكون أحد أكثر الاهتمامات الأمنية إلحاحًا لكلتا القارتين في السنوات القادمة. تخلق المركزية المعززة للبحر الأبيض المتوسط وموانئه فرصًا للنمو للمنطقة وللأسواق الأوروبية والأفريقية الأوسع التي يربطها: ليس فقط في صناعة الشحن ولكن أيضًا في القطاعات الاقتصادية التي تزدهر حول بنية تحتية جيدة الأداء ومتصلة جيدًا. كانت بعض البلدان أكثر ذكاءً من غيرها في الاعتراف بهذا الأمر في وقت مبكر: داخل المنطقة، فإن حالة المغرب التي تضع نظام الموانئ في صميم الإنعاش الاقتصادي أمر ملحوظ، بينما من بين المستثمرين الأجانب، تعد الصين الأكثر مشاركة وحريصة على الحفاظ على المدى الطويل. الاستثمارات.

ومع ذلك، فإن البحر الأبيض المتوسط يستفيد جزئياً فقط من الفرص الاقتصادية الحالية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف استراتيجيات تطوير الموانئ من قبل دول البحر الأبيض المتوسط وقلة الاهتمام باستثمار الموارد الاقتصادية. كما يجب تقييمه على خلفية التطورات في صناعة الشحن على مستوى العالم، ولا سيما الحصة السوقية المتزايدة للشحن العابر – أي شحن البضائع إلى وجهة وسيطة، ثم إلى وجهة أخرى. أدى الارتفاع الكبير في أنشطة الشحن العابر إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط كسوق متصل ولكنه يميل إلى خدمة السوق العالمية أكثر من السوق المحلية، وخاصة أكبر المصدرين في العالم بدلاً من البلدان التي توجد بها مراكز الشحن العابر. يفسر هذا جزئيًا سبب وضع البحر الأبيض المتوسط بشكل مهم للغاية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI). اليوم، يعتمد نمو حركة النقل البحري وتراجع نموها في البحر الأبيض المتوسط – ونظام البنية التحتية الذي يدعمها – اعتمادًا كبيرًا على التدفقات التجارية المستمرة والقوية على طول الطريق بين الشرق والغرب. لقد أثر الوباء الحالي الناجم عن تفشي فيروس Covid-19 بشكل كبير، مما أظهر درجة ضعف موانئ البحر الأبيض المتوسط واعتمادها على التجارة الدولية وصادرات الصين. انخفضت أحجام الحاويات العالمية ما بين 8-10٪ منذ بداية الأزمة، وانخفضت الواردات من آسيا ما بين 10-15٪ . من المرجح أن يتوقف المزيد من الاضطراب في تدفقات التجارة الدولية، مؤقتًا على الأقل،
كان حوض البحر الأبيض المتوسط بطبيعة الحال مفترق طرق لنقل البضائع والأشخاص، الذين خلقت رحلاتهم ومواجهاتهم مفهومًا ثقافيًا واجتماعيًا مميزًا تم تحديده بكلمة «البحر الأبيض المتوسط». تاريخياً، كان إنشاء قناة السويس عام 1869 نقطة تحول في تاريخ البحر الأبيض المتوسط: فقد ساعدت قناة السويس على عكس عملية التهميش التي كان يمر بها البحر الأبيض المتوسط منذ القرن السادس عشر لصالح المحيط الأطلسي ووضعته. في قلب طريق تجاري رئيسي واحد. ثم أصبح البحر الأبيض المتوسط أسهل وأرخص طريق للنقل بين آسيا وأوروبا. أدى ظهور النقل بالحاويات في صناعة الشحن بعد حوالي قرن من الزمان إلى تحويل المنطقة إلى ممر إلزامي للتجارة العالمية: اليوم، ما بين 7 ٪ و 8 ٪ من إجمالي البضائع المتداولة عالميًا يسافر عبر قناة السويس. أثبتت طريقة نقل البضائع بالحاويات وأنظمة النقل البحري والداخلي ذات الصلة أنها مفيدة للعولمة، بطريقة جعلت هاتين العمليتين متشابكتين إلى حد كبير: أدى إدخال النقل بالحاويات إلى جعل تكاليف نقل البضائع عبر الكوكب أرخص 20 مرة من ذي قبل.، مما يسمح بظهور سلاسل القيمة العالمية (GVCs) بدورها، الاتجاهات في التجارة العالمية، والتحولات والتوسع في سلاسل القيمة العالمية، تحدد الآن اتجاه الاستثمارات في جغرافية النقل، تفضيل التنمية الاقتصادية لمنطقة أو أخرى. صعود الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الصين، حيث اتخذت التجارة العالمية العملاقة الطريق عبر المحيط الهادئ، يليها طريق الشرق والغرب، الممر البحري الأكثر ازدحامًا في العالم – يأتي الممر عبر المحيط الأطلسي في المرتبة الثالثة لكل. ذلك، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط نموًا هائلاً في الاستثمارات في القطاع البحري على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت منصة لوجستية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة لطريق التجارة بين الشرق والغرب – تربط آسيا وأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وربط المحيطين الأطلسي والهندي. يليه طريق الشرق والغرب، الممر البحري الأكثر ازدحامًا في العالم – يأتي الممر عبر المحيط الأطلسي في المرتبة الثالثة . لذلك، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط نموًا هائلاً في الاستثمارات في القطاع البحري على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت منصة لوجستية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة لطريق التجارة بين الشرق والغرب – تربط آسيا وأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وربط المحيطين الأطلسي والهندي. يليه طريق الشرق والغرب، الممر البحري الأكثر ازدحامًا في العالم – يأتي الممر عبر المحيط الأطلسي في المرتبة الثالثة. لذلك، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط نموًا هائلاً في الاستثمارات في القطاع البحري على مدى العقدين الماضيين، وأصبحت منصة لوجستية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة لطريق التجارة بين الشرق والغرب – تربط آسيا وأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وربط المحيطين الأطلسي والهندي. كان نمو أنشطة إعادة الشحن عاملاً حاسماً في تطور نظام الموانئ المتوسطية على مدى العقود الماضية. شكّل النقل العابر 28٪ من التجارة العالمية في عام 2012، أي ضعف ما كان عليه قبل 20 عامًا. يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بنمو التجارة بالحاويات لمسافات طويلة وبالتحول في نموذج أعمال شركات الشحن نحو العملقة، أي استخدام سفن أكبر بشكل متزايد لجني أكبر الفوائد من وفورات الحجم. نظرًا لاستخدام السفن الضخمة لنقل البضائع عبر مسافات طويلة (على سبيل المثال طريق الشرق والغرب)، يتم بعد ذلك تفريغ حمولتها وتقسيمها إلى سفن أصغر في الموانئ الوسيطة، ثم المضي قدمًا نحو سوق الوجهة النهائية. تميل عمليات إعادة الشحن إلى الحدوث في مساحات جغرافية ملائمة (أسواق الشحن العابر، وتسمى أيضًا المحاور الوسيطة) التي تربط بشكل طبيعي أسواقًا متعددة، مثل منطقة البحر الكاريبي، وبحر جنوب شرق الصين، والبحر الأبيض المتوسط ، في الواقع. يمثل النقل العابر غالبية – وفي بعض الأحيان مجمل – الأنشطة في العديد من موانئ البحر الأبيض المتوسط ،
تتمتع موانئ البحر الأبيض المتوسط بموقع استراتيجي لخدمة أعمال الشحن من البحر إلى البحر، حيث تعمل كحلقة وصل بين الأسواق العالمية والإقليمية ؛ ومع ذلك، تظل الموانئ الكبرى في شمال أوروبا أهم بوابات الأسواق الأوروبية، حيث تتمتع بميزة كبيرة بسبب نظام النقل متعدد الوسائط. تظل القيود الرئيسية على موانئ البحر الأبيض المتوسط ضعيفة على وجه التحديد في الاتصال متعدد الوسائط، مما يحد من فرص توسيع المناطق النائية والمزايا الاقتصادية ذات الصلة. ومع ذلك، فقد تسبب نمو موانئ البحر الأبيض المتوسط في حدوث تحول في نظام الموانئ الأوروبية ككل: لا تزال الموانئ الأربعة الأولى هي روتردام وأنتويرب وهامبورغ وبريمرهافن – حتى أن أنتويرب يُشار إليها على أنها أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسطلأنها غالبًا وجهة الشحن المشحونة عبر قناة السويس متجهة إلى السوق الأوروبية. ومع ذلك، فإن موانئ الحاويات في البحر الأبيض المتوسط تلحق بالركب، ولا سيما الموانئ الأربعة الأولى على البحر الأبيض المتوسط ، التي سجلت نموًا قويًا للغاية على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019: الجزيرة الخضراء (+ 8.2٪)، فالنسيا (+ 12.5٪)، بيرايوس (+ 24.4٪) وبرشلونة (+ 5.97٪). وفقًا لتوقعات النمو الأخيرة، سيتفوق ميناء بيريوس قريبًا على ميناء بريمرهافن باعتباره رابع أكبر ميناء للحاويات في أوروبا. في حين أن النمو في إعادة الشحن كان فرصة لموانئ البحر الأبيض المتوسط ، إلا أن هذا النوع من النشاط يمكن أن يعيق التعاون الإقليمي ويحد من العائد الاقتصادي الإجمالي للاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية. يتم تحديد أسواق إعادة الشحن من خلال مجموعة من الاستثمارات الجغرافية والاستراتيجية: على سبيل المثال، يعد البحر الأبيض المتوسط ممرًا طبيعيًا للتدفقات التجارية بين الشرق والغرب، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال إنشاء قناة السويس. ومع ذلك، فإن خيارات الموانئ الفردية للتعامل مع التدفقات التجارية داخل نفس المحور الوسيط تختلف حسب تقدير شركات الشحن، ويمكن أن تتغير بمرور الوقت. لا يتم تحديد القدرة التنافسية للميناء من خلال الجغرافيا فقط – أي قربها من خط الشحن الرئيسي – ولكن أيضًا من خلال الجودة الشاملة للخدمات المقدمة.
إن الاتجاه إلى استخدام السفن العملاقة واحتكار القليل من مجمعات الشحن الصناعية النشطة في البحر الأبيض المتوسط Ocean Three، يدفع الموانئ للتنافس على استثمارات الشركات. يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين شامل في البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في المنطقة، ولكنه أيضًا يخلق ديناميكية المنافسة بين الموانئ التي تخدم نفس السوق. تميل هذه الأسواق إلى التشبع بسرعة، لصالح أولئك الذين يستثمرون أولاً. مثال على ديناميكية ميزة المحرك الأول تقدمه حالة المغرب في المغرب العربي، والتي سيتم استكشافها بمزيد من التفصيل في القسم التالي. من خلال أن تصبح مركزًا ناجحًا للشحن العابر في المغرب العربي، ألهمت طنجة المتوسط البلدان المجاورة أن تحذو حذوها – حيث وضعت ليبيا وتونس والجزائر خطط تجديد لأنظمة الموانئ الخاصة بها – بينما تركت في نفس الوقت القليل من الإقبال بين المستثمرين الأجانب على ذلك. يوجهون أموالهم إلى مكان آخر. أخيرًا وليس آخرًا، تميل أنشطة إعادة الشحن التي لم يتم دمجها بشكل جيد في استراتيجية تطوير منطقة الميناء الخلفية إلى دعم الأنشطة البحرية أكثر من اقتصاد الدولة خارج نطاق المحيط المباشر للميناء. كما هو موضح في القسم التالي من خلال حالتي طنجة المتوسط وقناة السويس الجديدة، وهي استراتيجية تجمع مواني متكاملة تتضمن تدخلات ليس فقط في الموانئ ولكن أيضًا في مجالات مثل الصناعة والتجارة. كانت الاستثمارات في جنوب البحر الأبيض المتوسط قوة دافعة أخرى وراء تطوير البنية التحتية البحرية الشاملة في المنطقة. على وجه الخصوص، فإن محور إعادة الشحن الجديد لطنجة المتوسط وتوسيع قناة السويس هما حالتان تستحقان المزيد من الاستكشاف للتأثير الكبير على العمارة البحرية الشاملة للمنطقة، والدور الذي لعبته في التنمية الاقتصادية للمغرب ومصر، على التوالي.

كانت طنجة المتوسط مشروعًا ذا أولوية للحكومة المغربية في عملية تنويع الاقتصاد المغربي، الأمر الذي يركز بشكل أكبر على الصادرات والاقتصاد البحري، حيث حصل على ما يقرب من 30 ٪ من إجمالي الاستثمارات العامة. تقع مدينة طنجة المتوسط في مضيق جبل طارق، وهي متصلة بـ 186 ميناء في جميع أنحاء العالم وهي موطن لمركز صناعي يضم 900 شركة. يشتمل المجمع على أربع مناطق تجارة حرة موجهة للتصدير، حيث لا يتم فرض رسوم جمركية، وهي مصممة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة: تم إنشاء أكثر من 70.000 فرصة عمل بفضل المشروع – 6000 في الميناء، وأكثر من 60.000 في الميناء. منطقة التجارة – بحسب رئيس الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط . اليوم، طنجة المتوسط هي أكبر موانئ إفريقيا وواحدة من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط. سبقت إنشاء Tanger-Med عملية أوسع للتخطيط الاقتصادي، بما في ذلك الاستخدام المكثف للدبلوماسية العامة لجذب الصفقات مع شركات الشحن – يتم تشغيل محطات الموانئ من قبل APM Terminal، ومملوكة لشركة Maersk الدنماركية، وشركة Eurogate الألمانية، ومحلية. مؤسسة. نشجع بشدة على نقل عمليات الإنتاج إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) التي تم إنشاؤها حول مرافق الميناء. نقلت رينو إس إيه عمليات إنتاجها بالكامل الموجهة لخدمة الأسواق الأفريقية والأوروبية إلى المغرب، وفتحت شركات مثل بيجو إس إيه وسيمنز وهواوي منصات لوجستية في طنجة. لذلك، عندما أصبح الميناء جاهزًا للعمل رسميًا في عام 2018، كانت البيئة الاقتصادية الأوسع حولها جاهزة لتحقيق الفوائد المثلى لاقتصاد البلاد. تم افتتاح أحدث محطات الموانئ في يونيو 2019.
على عكس حالة طنجة المتوسط إلى حد ما، اتبعت عملية تجديد قناة السويس مسارًا مختلفًا: أطلق المشروع الرئيس المصري السيسي في عام 2014، وتم تنفيذه في وقت قياسي. تم الانتهاء من تحديث القناة في عام 2015 بعد أن استغرق 11 شهرًا فقط، مما ضاعف من سعة القناة السابقة – من 49 إلى 97 سفينة قادرة على المرور في نفس الوقت، وانخفض وقت العبور من 18 إلى 11 ساعة، مما أدى إلى خفض تكلفة التشغيل بنسبة 5-10٪ . توفر القناة الجديدة بديلاً مناسبًا ليس فقط لرأس الرجاء الصالح ولكن أيضًا لقناة بنما لطرق معينة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة:[4] )، ولعبور المحاور العابرة للقارات – مثل كولومبو ودبي وطنجة المتوسط وبيرايوس وجيويا تاورو والجيسيراس، على سبيل المثال لا الحصر. افترض الخبراء وجود تأثير مباشر لقناة السويس الجديدة على زيادة نمو التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأوروبا.
على الرغم من الفرص المحتملة التي فتحها المشروع لزيادة الحركة البحرية، إلا أنه اجتذب انتقادات عديدة وتم إدراجه في قائمة ما يسمى بمشاريع السيسي الغرور . إلى جانب التعزيز الموضوعي لقدرة القناة على خدمة التجارة الدولية، يزعم النقاد أن مستويات النمو الحالية في الاقتصاد العالمي والتدفقات التجارية راكدة، ولا تبرر المشروع الضخم، حيث كان من الممكن توجيه الاستثمارات إلى مناطق وقطاعات اقتصادية أخرى في الدولة التي يعاني اقتصادها. علاوة على ذلك، فإن سرعة تصور المشروع وتنفيذه لم تترك سوى القليل من الوقت للتخطيط الاقتصادي الأوسع بعد تحقيق التوسع. أعقب التجديد بعد ذلك فقط وضع تصور لخطة استثمارية أكبر تهدف إلى جعل منطقة القناة منطقة تنمية اقتصادية، بما في ذلك المراكز الصناعية ومراكز البحوث، ومشروع منطقة ممر قناة السويس (SCZone. ) يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية تسمح للسويس بالاستفادة من كونها في قلب الطريق بين الشرق والغرب، وليس فقط كنقطة مرور إلزامية. تعد الصين أحد المستثمرين الأجانب الرئيسيين في منطقة SCZone من خلال مذكرة تفاهم موقعة بين مصر وبلدية تيانجين الصينية، لإنشاء منطقة التجارة الحرة على غرار منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في تيانجين (TEDA) («قناة السويس» الهيئة «، 2019). هذه ليست حالة منعزلة ولكنها مثال على الوجود المتزايد للاستثمارات الصينية في المنطقة، كما هو موضح في القسم التالي. تعد الصين أحد المستثمرين الأجانب الرئيسيين في منطقة SCZone من خلال مذكرة تفاهم موقعة بين مصر وبلدية تيانجين الصينية، لإنشاء منطقة التجارة الحرة على غرار منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في تيانجين (TEDA) («قناة السويس» الهيئة «، 2019). هذه ليست حالة منعزلة ولكنها مثال على الوجود المتزايد للاستثمارات الصينية في المنطقة، كما هو موضح في القسم التالي. تعد الصين أحد المستثمرين الأجانب الرئيسيين في منطقة SCZone من خلال مذكرة تفاهم موقعة بين مصر وبلدية تيانجين الصينية، لإنشاء منطقة التجارة الحرة على غرار منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في تيانجين (TEDA) («قناة السويس» الهيئة «، 2019). هذه ليست حالة منعزلة ولكنها مثال على الوجود المتزايد للاستثمارات الصينية في المنطقة.
2- أن تدويل الصين وشركاتها هو أهم ظاهرة في أوائل القرن الحادي والعشرين. بعد توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، يتزايد حضور الصين في أوروبا، حيث يعد البحر الأبيض المتوسط أحد الأماكن التي يتجلى فيها هذا التحول. زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية (FDI) في أوروبا ما يقرب من خمسين مرة في ثماني سنوات – من 840 مليون دولار في عام 2008 إلى 42 مليار دولار في عام 2016، عندما أصبحت الاستثمارات الصينية في أوروبا أكبر بأربعة أضعاف من الاستثمارات الأوروبية في الصين. في حين أن الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أوروبا كان في عام 2016 يقع تحت عنوان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (11.8٪)، فقد تضاعفت الاستثمارات في قطاعي النقل والبنية التحتية معًا في عام 2017، تمثل الحصة الأكبر من الإجمالي (15.3٪) (مجموعة الروديوم). في جنوب أوروبا، استهدفت الصين بشكل أساسي البلدان التي تمر بعمليات خصخصة مهمة وإعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، ولا سيما إيطاليا والبرتغال واليونان. علاوة على ذلك، أنشأت الصين في عام 2012 منصة 17 + 1[5] (سابقًا 16 + 1)، يجمع الاتحاد الأوروبي (EU) ودول خارج الاتحاد الأوروبي لتنسيق الاستثمارات في طرق النقل الرئيسية التي تربط جنوب شرق ووسط أوروبا تحت مظلة واسعة لمبادرة الحزام والطريق.
تم تعريف مبادرة الحزام والطريق في الصين على أنها أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا في التاريخ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق التقديري ما بين 1.2 و 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2027. تم إطلاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين – جنبًا إلى جنب مع مبادرة الحزام والطريق – الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وهو عبارة عن متاهة من مشاريع البنية التحتية التي تمتد وتتصل عبر أوراسيا وحولها. يتألف الحزام الاقتصادي لطريق الحرير من ستة مشاريع اقتصادية وممرات برية ذات صلة تربط الصين بأوروبا. يخلق طريق الحرير البحري حلقة حول أوراسيا: الجزء الجنوبي يمتد على طول الطريق عبر المحيط الهندي، عبر جنوب شرق آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ، بينما يربط القسم الشمالي آسيا وأوروبا عبر طريق البحر الشمالي (NSR) عبر القطب الشمالي، والذي الصين تدعو طريق الحرير الجليدي. صاغت الحكومة الصينية المبادرة كأداة لتعزيز ودعم اقتصاد التصدير الصيني الهائل، وتعزيز التعاون الدولي، مع إنكار أي طموح جيوسياسي وأمني أكثر طموحًا. تشمل مبادرة الحزام والطريق مشاريع تطوير البنية التحتية بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على طول الطريق، على غرار استراتيجية التنمية الاقتصادية الخاصة بالصين. على الرغم من عدم التأكيد صراحةً في الإعلانات والوثائق الرسمية، تنظر الصين إلى البحر الأبيض المتوسط من منظور إقليمي، كما يتضح من تعدد المشاريع إما المخطط لها أو قيد التطوير في كل ركن من أركان حوض البحر الأبيض المتوسط تقريبًا. وبعضها مصنّف ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما الاستثمارات في البنية التحتية البحرية والتواصل ؛ البعض الآخر مرتبط بـ BRI، على الرغم من عدم وجود علامة تجارية مباشرة، مثل مشاريع التنمية الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواقعة بالقرب من مرافق الموانئ. الفقرة التالية تحدد بإيجاز أمثلة مهمة. دون محاولة أن تكون قائمة شاملة للاستثمارات الصينية في المنطقة، فإنها تقدم فكرة عن حجم الوجود الصيني المتنامي في البحر الأبيض المتوسط.

المشروع الذي سلط الضوء رسميًا على هذه المسألة هو الاستحواذ على حصة 67 ٪ في هيئة الموانئ اليونانية في بيرايوس من قبل شركة China Ocean Shipping Company Limited، المعروفة باسم COSCO، أكبر شركة صينية مملوكة للدولة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. بدأت مشاركة COSCO مع الميناء في عام 2008 بامتياز لمدة 30 عامًا لإدارة محطتين واستمرت في إنشاء محطة ثالثة في عام 2013. واليوم، تتمتع COSCO بالسيطرة الإدارية الكاملة على سلطة الميناء وجعلت بيريوس البوابة الرئيسية لـ دخلت البضائع الصينية إلى أوروبا، لدرجة التنافس على المركز الرابع من حيث أنشط الموانئ الأوروبية من حيث حاويات الحاويات التي يتم تداولها سنويًا. تهدف منصة 17 + 1 المذكورة أعلاه إلى ضمان أنه بمجرد دخول البضائع إلى السوق الأوروبية، يمكنهم السفر بسهولة عبر البر والبحر. وبالمثل، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين الصين وإيطاليا في مارس 2019 تتبع نفس المنطق. إيطاليا هي ثالث أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أوروبا (بعد المملكة المتحدة وألمانيا) وكانت أول دولة في مجموعة السبع تلتزم رسميًا بمبادرة الحزام والطريق. من بين 24 نقطة من مذكرة التفاهم، هناك مشروعان مهمان بشكل خاص في المجال البحري، وهما الاستثمارات المخطط لها في مينائي جنوة وترييست الإيطاليين. في 9 نوفمبر 2019، أرست اتفاقية متابعة الأساس لتطوير منصات لوجستية في الصين ستكون مرتبطة مباشرة بميناء ترييستي، من المفترض أن تعزز تصدير «صنع في إيطاليا» في الصين القارية، . تعمل الصين أيضًا على تطوير مدينة مرسيليا للتجارة الدولية (MITC) حول ميناء مرسيليا – والتي، كما ذكرنا، أحد منافذ البوابة الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط – وقد وقعت شركة التكنولوجيا الصينية متعددة الجنسيات Huawei مؤخرًا عقودًا مع هيئة الموانئ في طنجة المتوسط تفتتح منصة لوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بطنجة («هواوي تنشئ مركزًا لوجستيًا إقليميًا»). تقوم مجموعة Shanghai International Port Group (SIPG)، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، ببناء محطة جديدة في ميناء حيفا الإسرائيلي، بشرط امتلاك حقوق تشغيل المحطة لمدة 25 عامًا بعد دخول المرافق حيز الخدمة في عام 2021 ( أتلي، 2019). تمتلك كوسكو حصة 20٪ في محطة حاويات قناة السويس (SCCT) في بورسعيد في مصر بموجب امتياز مدته 49 عامًا.
أدى دخول الصين إلى الفضاء البحري المتوسطي، فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الأوسع نطاقًا وإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا وأفريقيا، إلى زيادة الاهتمام والتساؤل من قبل مجتمع الخبراء وصانعي السياسات والناخبين على حد سواء. ومع ذلك، في حين سارعت واشنطن في تعريف مبادرة الحزام والطريق على أنها تهديد اقتصادي وعسكري محتمل للولايات المتحدة (الولايات المتحدة) والتحالف عبر الأطلسي، فقد احتفظ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بموقف أكثر غموضًا ولم يتحركوا إلا مؤخرًا نحو نهج أكثر تحديدًا. وتأطير حازم للعلاقات الصينية الأوروبية. في يونيو 2019، من خلال إعلان الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الاتحاد الأوروبي والصين – نظرة استراتيجية،عرّف الاتحاد الأوروبي الصين للمرة الأولى على أنها «منافس استراتيجي، يفشل في تبادل الوصول إلى السوق والحفاظ على تكافؤ الفرص.
الشك السلبي والمخاوف المتعددة قصيرة وطويلة الأجل فيما يتعلق بالشروط والأحكام الصينية بموجب مبادرة الحزام والطريق تسود النقاش الأوروبي وهي سائدة بين صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر: السلوكيات الاقتصادية الصينية غير التنافسية – مثل تشويه الأسعار بسبب الإعانات الحكومية، والتمييز ضد الشركات الأوروبية بموجب المناقصات الصينية، وتقييد وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية ؛ تهديدات للأصول الاستراتيجية الأوروبية والملكية الفكرية والمعرفة التكنولوجية ؛ الخسارة المحتملة للقيادة الاقتصادية للشركات الأوروبية – من حيث الحفاظ على القدرة على إنشاء ومراقبة الأسواق وقواعد التبادل، وتحديد الأسعار واختيار شركاء الأعمال ؛ والمخاوف من التداعيات المعيارية والسياسية الأوسع للاستثمارات الصينية، خاصة فيما يتعلق بمعايير البيئة والعمل وحقوق الإنسان. في فبراير 2019، بعد ضغوط من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، قدم الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لضمان التنسيق وتشجيع التعاون بين آليات الفرز الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه اللائحة توفر إطارًا مفيدًا لدعم دول الاتحاد الأوروبي في تحديد «المخاطر المحتملة على الأمن أو النظام العام» التي يمكن أن تكون ملازمة للاستثمارات الأجنبية، إلا أنها لا تقدم كفاءات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستثمار، كما أنها غير ملزمة قانونًا بأي شكل من الأشكال، وبالطبع لا ينطبق على دول الجوار في الاتحاد الأوروبي. قدم الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لضمان التنسيق وتشجيع التعاون بين آليات الفرز الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه اللائحة توفر إطارًا مفيدًا لدعم دول الاتحاد الأوروبي في تحديد «المخاطر المحتملة على الأمن أو النظام العام» التي يمكن أن تكون ملازمة للاستثمارات الأجنبية، إلا أنها لا تقدم كفاءات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستثمار، كما أنها غير ملزمة قانونًا بأي شكل من الأشكال، وبالطبع لا ينطبق على دول الجوار في الاتحاد الأوروبي. قدم الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لضمان التنسيق وتشجيع التعاون بين آليات الفرز الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه اللائحة توفر إطارًا مفيدًا لدعم دول الاتحاد الأوروبي في تحديد «المخاطر المحتملة على الأمن أو النظام العام» التي يمكن أن تكون ملازمة للاستثمارات الأجنبية، إلا أنها لا تقدم كفاءات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستثمار، كما أنها غير ملزمة قانونًا بأي شكل من الأشكال، وبالطبع لا ينطبق على دول الجوار في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى كونها مصدرًا لا جدال فيه للمنافسة، يمكن لسياسة الاستثمار الصينية أن تنتج حوافز لزيادة التعاون عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وخاصة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ودور أكبر للاتحاد الأوروبي في تلبية الحاجة الحالية لتطوير البنية التحتية في المنطقة. إن مكانة الخبرة الأوروبية القائمة على الميزة التكنولوجية، والاستثمارات في الابتكار واللوائح المستندة إلى القواعد للنمو المستدام هي المفتاح لضمان أن الدول الأعضاء الأوروبية تحافظ على السيطرة على أسواقها وأصولها الاستراتيجية. هذا المفهوم هو في الواقع أصل استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2018 بشأن «ربط أوروبا وآسيا – اللبنات الأساسية
لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي». الاستراتيجية هي أقرب شيء موجود للاستجابة لمبادرة الحزام والطريق وتهدف إلى تمهيد الطريق لمعالجة فجوات الاستثمار المحددة في أوراسيا، يقدر أن أوروبا وآسيا ستحتاجان 1.5 و 1.3 تريليون يورو على التوالي في الفترة من 2021 إلى 2030 (الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، 2018). تهدف خطة الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تعزيز الاتصال بين القارتين من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات: بناء أرضية مشتركة للاتصالات والشبكات الفعالة ؛ إقامة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف تقوم على قواعد مشتركة ومعايير مشتركة ؛ وتعبئة موارد القطاعين العام والخاص. تعد الاستراتيجية نقطة انطلاق جيدة لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي ونواياه: للمضي قدمًا، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة موارد كافية بموجب الإطار المالي متعدد السنوات (MFF) 2021-2027، وتبسيط سياساته المتعلقة بالاتصال والأصول الاستراتيجية، مثل البنية التحتية البحرية.
سيكون المنظور الإقليمي في معالجة الاتصال هو مفتاح النجاح، لا سيما في العالم البحري، الذي يخدم شبكة عالمية من طرق التجارة، وحيث يصعب تحديد الحدود أكثر من البر. يمكن للاتحاد الأوروبي توفير التمويل لتحفيز المزيد من رأس المال العام والخاص لمشاريع البنية التحتية ويمكنه استخدام خبرته في شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) لتقديم المساعدة الفنية، وتعبئة الموارد لدعم الاستثمارات خارج حدودها، إلى شرقها. والدول المجاورة الجنوبية. تتمثل الخطوات في هذا الاتجاه في إعلان صوفيا الصادر في مايو 2018 عن قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان من أجل زيادة مستدامة في الاتصال في مجالات النقل والطاقة ورأس المال الرقمي والبشري ؛ الاقتراح المتضمن في استراتيجية الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وآسيا «لتمديد ولاية منسق (منسقي) ممر TEN-T التابع للاتحاد الأوروبي إلى منطقة التوسيع والجوار ضمن المراجعة المتوخاة لتنظيم TEN-T والتي يجب استكمالها بحلول عام 2023» واقتراح المفوضية لإطار عمل استثماري للعمل الخارجي، بناءً على الصندوق الأوروبي الحالي للتنمية المستدامة، والذي يعد جزءًا من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وينطبق على إفريقيا والجوار. لا يشير هذا الأخير إلى البحر الأبيض المتوسط من الناحية الإقليمية ولكن يمكن أن يوفر نقطة انطلاق مفيدة للنهج المستقبلية للمنطقة. البناء على الصندوق الأوروبي الحالي للتنمية المستدامة، والذي يعد جزءًا من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وينطبق على إفريقيا والجوار. لا يشير هذا الأخير إلى البحر الأبيض المتوسط من الناحية الإقليمية ولكن يمكن أن يوفر نقطة انطلاق مفيدة للنهج المستقبلية للمنطقة. البناء على الصندوق الأوروبي الحالي للتنمية المستدامة، والذي يعد جزءًا من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وينطبق على إفريقيا والجوار. لا يشير هذا الأخير إلى البحر الأبيض المتوسط من الناحية الإقليمية ولكن يمكن أن يوفر نقطة انطلاق مفيدة للنهج المستقبلية للمنطقة.
3-خارج الحدود المادية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، يلعب مضيقان أساسيان لطريق التجارة بين الشرق والغرب دورًا خطيرًا في التوترات المتصاعدة في الخليج العربي: باب المندب وهرمز. تعتبر الملاحة الآمنة عبر هذه المضائق ضرورية للاقتصاد العالمي، بالنظر إلى أن باب المندب هو نقطة وصول مهمة إلى قناة السويس، وهرمز هو الممر لمعظم النفط المتجه من الخليج العربي باتجاه آسيا. يقع مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم في البحر الأحمر، ويمثل أقصر طريق يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. تم تقسيمها من قبل جزيرة بريم إلى قناتين، وقد كانت طريقًا تجاريًا نشطًا لعدة قرون. ازدادت أهمية باب المندب بعد بناء قناة السويس وكذلك مع تصدير النفط من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. في عام 2018، تدفق ما يقدر بنحو 6.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر المضيق في كلا الاتجاهين، نحو أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. كما أنها تتعامل مع معظم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين واليابان وآسيا في طريقها عبر السويس. يمكن للسفن التي تحمل النفط من الخليج إلى أوروبا وأمريكا الشمالية أن تتجنب باب المندب بالسفر حول الطرف الجنوبي من إفريقيا، لكن المسافات المتزايدة ستضيف إلى تكاليف الشحن والوقود وتعطل الإمدادات. تستغرق الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى روتردام حوالي 22 يومًا عبر باب المندب وقناة السويس، مقارنة بـ 39 يومًا حول إفريقيا. كانت منطقة باب المندب واحدة من أكثر المناطق التي تتعرض لتهديد من هجمات القراصنة، وقد تم تعليق استخدام المضيق في عام 2010 في ذروة أزمة القرصنة الصومالية. أوقفت المملكة العربية السعودية استخدام المضيق مؤقتًا في عام 2018 بعد هجوم مليشيات الحوثي اليمنية على ناقلتين.

يعد مضيق هرمز الممر البحري الرئيسي الذي يشحن من خلاله مصدرو الخليج العربي (البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) نفطهم إلى الأسواق الخارجية. فقط إيران والمملكة العربية السعودية لديهما طرق وصول بديلة إلى ممرات الشحن البحري. تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن ما يقرب من 17 مليون برميل من النفط يوميًا – حوالي 35 ٪ من جميع صادرات النفط المنقولة بحراً – تمر عبر المضيق. هذا المسار هو أيضًا المسار الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والذي يمكن لهؤلاء المنتجين من خلاله نقل نفطهم إلى شرق آسيا. تعتمد دول الخليج الفارسي بشكل كبير على الإيرادات من هذه الصادرات: فهي منطقة رائدة في إنتاج النفط، وتمثل 30 ٪ من العرض العالمي. وفي الوقت نفسه، تعتبر شرق آسيا منطقة رئيسية مستهلكة للنفط: فهي تمثل 85٪ من صادرات الخليج. مضيق هرمز هو الطريق البحري الوحيد للخارج. يذهب خط أنابيب سعودي إلى البحر الأحمر لكن طاقته محدودة بحوالي خمسة ملايين برميل من النفط يومياً («ضبط ناقلة النفط الإيرانية»، 2019). يمكن أن تحدث الاضطرابات عندما تهدد الدول بمنع بعضها البعض من المرور عبر هذه المضائق. وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عدة مرات، بينما أجرت السعودية وحلفاؤها مناورات بحرية لإظهار استعدادهم وقدرتهم على الرد إذا واصلت إيران ذلك. غالبًا ما تشارك الولايات المتحدة في التحالفات لموازنة إيران. في يونيو 2019، أفادت أنباء عن انفجارات استهدفت ناقلتين نفطيتين في خليج عمان مقابل هرمز. ووقعت الحادثة بعد حوالي شهر من هجوم منفصل على أربع ناقلات في مايو. في ذلك الوقت، وجدت التحقيقات التي أجرتها الإمارات أن الألغام المستخدمة لإدامة الهجوم تشير إلى تورط جهة فاعلة تشبه الدولة. زعمت الولايات المتحدة أن تورط إيران كان شبه مؤكد.
التوترات المتصاعدة، بالإضافة إلى التناقضات المتزايدة عالميًا ضمن التحالفات الأمنية التقليدية، تستدعي مزيدًا من الاهتمام الذي سيوليه الاتحاد الأوروبي لأمن الملاحة في الخليج. أي خطة للاتصال المستدام تهدف إلى أن تكون فعالة يجب أن تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية. تنص استراتيجية الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وآسيا صراحةً على الحاجة إلى تكثيف مشاركتها، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لضمان حرية وأمن الملاحة بين أوروبا وآسيا. ومع ذلك، لا يزال يتعين متابعة الخطوات الملموسة. في أعقاب هجوم يونيو / حزيران مباشرة، اقترح وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيريمي هانت، إنشاء فريق عمل بحري متعدد الجنسيات لحماية وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي . المبادرة، على الرغم من عدم استبعادها عن قصد للولايات المتحدة، كانت موجودة كبديل لعملية الحارس بقيادة الولايات المتحدة. كانت هذه محاولة لإبعاد الدول الأوروبية عن الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية للضغط الأقصى على إيران، والتي انتقدها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على نطاق واسع، إلى جانب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). على الرغم من وجود الاتحاد الأوروبي في المنطقة منذ عام 2008 في عمليات مكافحة القرصنة في أتلانتا ويونافور، إلا أن الخطة لم يتم تنفيذها وسط مقاومة من الدول الأوروبية وكذلك إيران، مما أدى إلى انضمام المملكة المتحدة إلى عملية الحراسة بعد كل شيء. انضمت المملكة العربية السعودية أيضًا في سبتمبر 2019، في أعقاب هجوم على أكبر منشآتها لمعالجة النفط في نفس الشهر، أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون مسؤوليته عن ذلك.