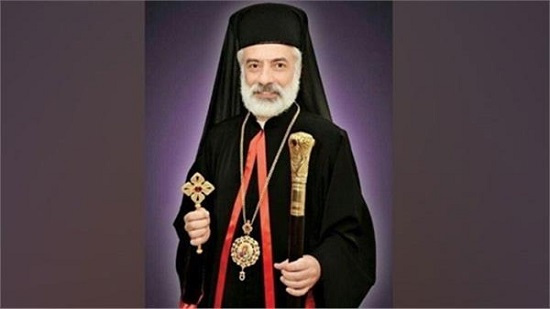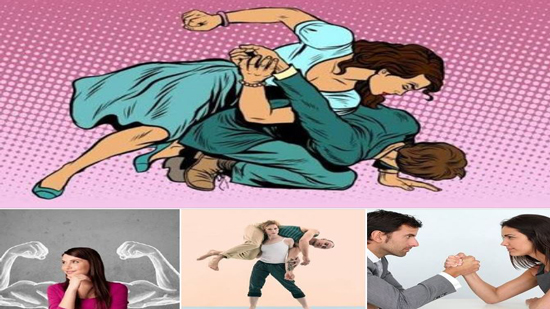عادل نعمان
أصبحنا على يد هؤلاء وبفضلهم ننام على غزوة ونهب ونفيق من النوم على الأخرى. جيوش جرارة معبأة، حمر مستنفرة ومحرضة على أهبة الاستعداد للذود عن الدين حتى لو كان الهدف إحباط مؤامرة وصول طبق من الكشرى إلى أسرة غير مسلمة تسد به رمقها أو تشبع جوع أطفالها.. أو قطع الطريق على شربة ماء لفاطر بعذر أو بدون.. أو تعطيل صب كوب من الشاى ينبه من كان على سفر.. أو فرض الحصار لمنع وصول غداء أو عشاء لسائح غريب، ويقتضى الأمر إغلاق أبواب المطاعم فى وجوه هؤلاء.. وإجبار كل خلق الله على الصيام، مَن كان منهم مريضًا أو على سفر، مسلمًا كان أو غير مسلم، مكلفًا أو غير مكلف، وإبعاد شبح الطعام ورائحته ونكهته، والنساء وفتنتهن وجمالهن، والسيجارة ورائحة التبغ الفواحة، والطيب وشذاه، حتى لا نؤذى مشاعر صاحبنا الصائم، ويظل صامدًا صلبًا دون إغواء أو غواية، فصاحبنا صائم على حرف.
لا يهم أن يكون الغازى أو المدافع أو الفاتح كاذبًا أو صادقًا، شريفًا أو فاسدًا، منحلًا أو عفيفًا، بارًّا بأهله أو عاقًّا لهم، يرد الأمانات لأهلها أو آكلًا لأموال اليتامى وميراث البنات والصغار.. ولما يرفع يديه ليحبط محاولة تهريب طبق الكشرى فى «
غزوة الكشرى الكبرى» أو غيرها، يُرفع على الأعناق ويتقدم الصفوف ويغفر الناس له ما تقدم من ذنبه فى حق العباد واليتامى وذوى القربى وما تأخر.. هكذا نحن نمجد البذىء والخادش للحياء والسافل والفاحش إذا رفع راية الدفاع والذود عن الإسلام منافقًا ومخادعًا ومضللًا، مهما طال أذاه الأبرياء أو جار على مظلوم، أو داس على برىء فى غزوته الميمونة، أو قتل أو أحرق أو سلب أو نهب، ونصدقه ونثق فيه، وكأنه حامى الحمى والحارس الأمين على دين الله.
نحن يا سادة لم نتخذ الإسلام دينًا نتقرب به إلى الله، أو نمارس شعائره فى أمن وسكينة، أو نحسن به إلى الناس، أو نمهد به الأرض لصالح الأعمال والأفعال وإعمار الأرض، أو زيادة الإنتاج، أو نرسم به طريق المحبة والسلام بين الناس، بل اتخذناه قوة وبطشًا ووسيلة للقهر والإجبار وحجة للاستعلاء والاستقواء، كما اتخذه الأوائل زلفى وذريعة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم التى حُرموا منها، ومبررًا للسطو والغزو على البلاد للخروج من حالة الفقر والعوز والحاجة كما كانت صناعة الإمبراطوريات القائمة، إلا أن استمرار هذه الخدعة تحت ستار الدين أمر لم يعد مقبولًا أو محمودًا أو مستساغًا، وقد كان ضرورة سياسية واقتصادية فى فترة تاريخية، حتى لو كان الدين سندًا له ونصيرًا بحكم الظروف والأحوال.. ولو لم يكن لهذا الحزب العربى البدوى من دين يجتمعون حوله ويلتحفون بقوته ما استطاعوا إلى ما فعلوه سبيلًا.. ولولا قوة هذا الحزب ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه وامتد من المشرق إلى المغرب، وما استطاعا معًا إقامة هذه الإمبراطورية، وانتصر كل منهما للآخر، إلا أنها خدعة قد انطلت على العوام، وأصبح فض الاشتباك والتشابك بين السياسة والدين أمرًا عسيرًا، وكذلك بين مصالح العباد ومنافعهم وبين الهدف الأسمى للدين، وبين القيام بالعبادة كما وجبت وبين الأذى الذى يلحق بخلق الله إذا امتنعوا، وبين الجهر بالشعيرة وبين من أراد الاحتفاء بها سرًا بينه وبين خالقه، وبين حق المسلم وحق الآخر فى دينه وعباداته.. وهى أمور تفرضها الضرورة فرضًا لا مناص ولا فكاك منها، وإلا خسر الطالب والمطلوب.
أما عن العوام (جمع عامة، ويطلق على الجمهور من الناس)، وهم أدوات المشايخ، وأداة غزواتهم وحروبهم، ووسيلة الحفظ والتعبير والملاحقة والمطاردة.. فقد وجب الحفاظ عليهم دائمًا فى حالة استنفار واستعداد.
يقول أحد المضللين من مشايخنا: «متى خرج العوام من أيدى علمائهم ضاعوا».. هؤلاء العوام الذين يستكينون ويرضخون ويطيعون، يصف العلماء الواحد منهم «كالميت بين يدى مغسله» يصنع فيه ما شاء، أداة طيعة تُساق وتُجرّ إلى ساحات الوغى والغزو دون وعى أو رشاد، هذا هو ما أنتجته أيديهم من بطش وقسوة، وهذه تربيتهم وصناعتهم وبضاعتهم التى جهلت وفسدت وتلفت، منهم من يتلاعب بالدين ويستثمره لمكسب ومغنم كما تلاعب به أجداده وربحوا وكسبوا، ومنهم من فقد العقل والتمييز والتفكير والرؤية والرؤيا والهدف، ومنهم من فقد الحكمة، وهم كُثر، حين تغافلوا عن دور العقل، وتجاهلوا غريزة الاستطلاع والفضول والبحث عن المعارف والعلوم وكشف أغوار الطبيعة وفهم مسالك ودروب الحياة واكتشافها ولمس الحقائق والنظر إليها.
وليس غريبًا هذا على الإنسان، حتى البدائى، وإلا ظل على بدائيته وهمجيته، وهذا هو سر الله فى خلقه، إعمال العقل والتفكير والتدبر والارتقاء.
غزواتكم تُرد إليكم.. تنتحرون كل ساعة، وتتأخرون عن الركب فراسخ وأميالًا كل يوم، وتُواجهون بالعناد والإنكار من الصغير قبل الكبير، وتخسرون وتتقهقرون وتخجلون بعد كل
غزوة من الغزوات على مسمع ومرأى من الناس، وندعو ونبتهل إلى الله أن يُكثر ويبارك فى غزواتكم حتى يكتشف العوام الطريق القويم.
نقلا عن المصرى اليوم