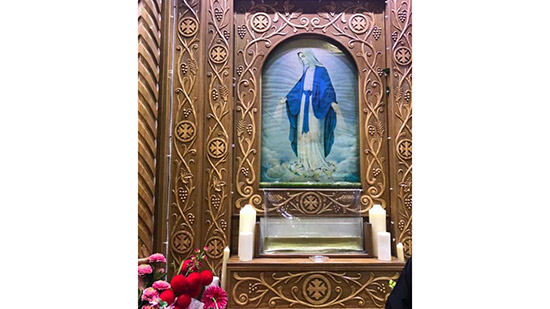عادل نعمان
ولا أظن أن سباقا بين فريقين فى الوصول إلى القاع والهاوية والحضيض تراه العين وتتعجب، كهذا السباق بين أتباع الدولة الدينية من جهة وبين حلفاء الديمقراطية المشبوهة، فتقع الأولى فى جعبة الفاشية الدينية، والثانية فى هاوية الديكتاتورية المطلقة، وكأنهما من مسبية واحدة.
ولا أظن أن أحدا ينكر هذه الحقيقة، وإن أسرها أحدهم فى نفسة لغاية أو لمصلحة، أو حتى كان أحد أطراف المنافسة والمبارزة وكان فى مركز القيادة والصدارة، حوزة دينية كانت أو من أهل الرشد والهدى والرشاد أو المجالس الكرتونية.
ولو خرج من صفوف المستفيدين والوصوليين يوما، أو أحيل إلى التقاعد لحمل لواء الإصلاح، وامتطى صهوة التصحيح والتعديل، ورفع قلمه مناديا باقتفاء أثر ثوار التغيير الذين وصمهم يوما بالخيانة والعمالة، وأصحاب الأجندات الخارجية.
وليست الدولة المدنية فى خصام وعراك مع الدولة الدينية فقط، بل هى فى خصومة ومنازعة مع كل الأنظمة الاحتكارية والاستبدادية والقمعية والديكتاتورية، حتى لو قدموا للشعب طعاما صباحا ومساء على صوانٍ من ذهب وفضة.
هى فى حرب وصراع ضد أى نظام يمارس الحجر على حرية الرأى والعقيدة والفكر، أو يمارس شكلا من أشكال التفرقة والتمييز بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو المذهب وعدم المساواة بينهم، أو يقف على مسافات متباينة بينه وبين الأديان، أو يفرض على المواطنين أوضاعا لا تتفق وكرامة الإنسان، أو تهدر الدولة مبدأ تكافؤ الفرص وألا يكون أساس الاختيار هو الكفاءة والعلم والخبرة.
أو يحجر على رجال العلم ويعتمد بديلا عنهم رجال الدين والدروشة وأهل الثقة، الأهم أن الدولة المدنية تساند وتنتصر لتداول السلطة بالطرق السلمية، ويكون الفصل لصندوق الانتخاب، لكن الكارثة أن هذا الصندوق ليس حرا، فهو قريب من يد الحاكم ومجاور لرجال الدين وملاصق لرجال المال السياسى.
ودون لف أو دوران، لا مخرج إلا باستبعاد كل صور الفساد والإفساد والمفسدين والمضللين وتجار السياسة والدين من التجربة الديمقراطية فى بداياتها الأولى، فإذا سارت خطواتها الأولى سيرا محمودا صحيحا، وحطت فى مكانها بثبات وثقة.
ووضعت حملها بأمانة فليطمئن الشعب على غده وعلى أجياله، وهذا الاستبعاد هو البديل السلمى عن صيغة الصراع الطبقى بين أصحاب المصالح، وهى الطبعة النهائية لصراع ممتد من الديمقراطية الإثينية حتى النموذج الحالى، وحين كان الصراع فى أوروبا قائما لإقرار الديمقراطية كانت بلاد العرب ترزخ تحت سيوف الخلافة التى تعتبر كل صور الحكم كافرة.
بل كلما زادت الديمقراطية نموا وثباتا فيها زاد الاستبداد عمقا فى بلادنا، وما رأينا من صور الديمقراطية المتطورة الحالية إلا نتائجها، وقد مرت فى رحلة طويلة عبر قرون من الصراع الدموى المرير حتى استقرت فى حجر الشعب، وهو أمر مستحيل قبوله الآن أو الإقرار به، فإن النعيم الذى يحياه الغرب هو نتاج كفاح وصراع وقتال فى سبيل الديمقراطية والحرية وهو أمر يصعب الوصول إليه إلا إذا استبعدنا وجوها كثيرة عن المشهد الديمقراطى لتأسيس دولة مدنية عصرية.
ولا أظن أن فى هذا ظلما للمستبعدين مؤقتا إذا ما ضمنّا حياة مستقرة هادئة وهانئة لهم، فلا قيادة دون رخصة، ولا سباق لغير المؤهلين، ولا حرية قبل رغيف الخبز، وعلى قدر المشقة تأتى النتائج مرضية، ولما كان صندوق الانتخابات ليس هو الشكل الكامل للديمقراطية إلا أنه الخطوة الأولى التى يبدأ منها البناء، والطلقة التى تصيب الهدف، إذا صلحت صلح الحال كله.
وإذا فسدت مال البناء مهما ارتفع، فإن ضمان أمانة الاختيار والانتقاء تستدعى استبعاد كل الجهلاء والمزيفين والمضللين وتجار السياسة والدين من وضع هذه اللبنة حتى تشب وتبلغ وتصمد فى مواجهة رياح الفساد والتضليل، وهى فترة تتزامن مع بناء الإنسان وتثقيفه وتعليمه حتى يؤمن بأهمية الديمقراطية ونجاح الدولة المدنية الحرة.
ولا أرى إلا مجموعة من التصورات بديلا وقد يتفق معى البعض، وقد يتهمنى الآخر بالعنصرية «كما اتهمنى المرحوم سعد هجرس».
الأول: أتصور أن إعداد الدستور ليس مهمة لجنة تتساهل وتتمايل وتجامل بل هو مهمة المتخصصين فى القانون الدستورى وفقهائه على ألا يشغل أحدهم منصبا أو يسمح له بالترشح لمنصب سياسى أو قيادى.
الثانى: أن يتم تشكيل المجلس النيابى بالانتخاب الحر المباشر، على أن نتفق على مستوى علمى وتعليمى لمن يشارك هذه الانتخابات مؤقتا، أما الرئاسية فلها شأن آخر فى الترشح والاختيار، على أن توضع قواعد عامة حاكمة للمرشحين وأن يقتصر الانتخاب على فئات محددة.
إن بناء الديمقراطية فى دول العالم الثالث على غرار ما تم فى دول الغرب أمر مستحيل تكراره وقبوله، وخطر يدمر الأمة ويقضى عليها، والصراع الدامى المقرر حدوثه قد يدفع الوطن إلى هاوية لا عودة منها ولا رجوع، مما يجعل الاستبعاد المؤقت أخف الضررين، والمقبول على مضض، والمبلوع بقليل من الماء المر. (الدولة المدنية هى الحل).
نقلا عن المصرى اليوم