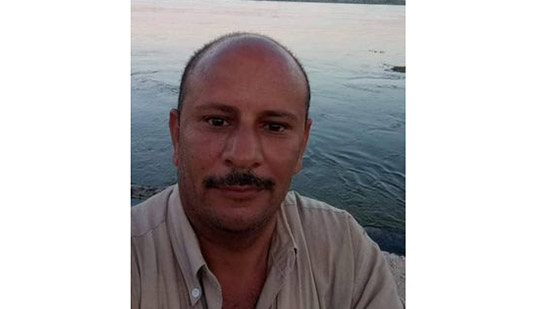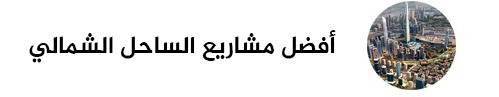القس باسليوس صبحي
المقدمة:
موضوع هذه الحلقة السادسة من سلسلة مقالاتنا "شخصيات من تاريخنا"، عن شخص تمر هذه السنة الذكرى السنوية الخمسين لرحيله، وهو العالِم القبطي والمؤرخ الكنسي ابن الإكليريكية البار المرحوم الأستاذ يسى عبد المسيح حنا، أمين مكتبة المتحف القبطي الأسبق، الذي غادر عالمنا الفاني يوم الثلاثاء 12 مايو 1959م، عن عمر يناهز الستين عامًا (حيث أنه وُلد في 29 يوليو سنة 1898م، ببلدة أشنين النصارى - مركز مغاغة، محافظة المنيا). تاركًا خلفه تُراثًا علميًا ضخمًا منه المنشور ومنه غير المنشور حتى اليوم.
تتلمذ راحلنا الكريم بالمدرسة الإكليريكية بمهمشة وتخرج فيها سنة 1922م، وتنقل بالعمل في أكثر من مكان منها مدرسة التوفيق، ثم الإكليريكية مدرسًا للغة اليونانية، وأمينًا لمكتبة المتحف القبطي مصر القديمة.
في هذا المقال سوف نسلط الضوء على الفضل العلمي لهذه الشخصية الفذة، وإسهاماته الجادة في مجال علم تاريخ الطقوس القبطية، حيث يُعد هو أول من بدأ دراسة هذا العلم دراسة وافية ونشر العديد من المقالات والدراسات عنه بالمجلات والدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية[1]، بمفرده حينًا، وبمساعدة صديقه العالِم الراحل BURMESTER أحيانًا أخرى.
فالغرض من هذا المقال ليس مجرد التأريخ له أو التسجيل التفصيلي لأثاره المكتوبة أو تأريخ لأعماله المنشورة، حيث سبق نشر هذا الثبت أكثر من مرة[2]، ولكن الغرض من هذا المقال هو الغوص في بحار بعض كتباته لإلتقاط العديد من اللالئ الجدد والعتقاء لنستنير بها ومن خلالها في دراستنا في مجال ذلك العلم السابق الذكر. نيح الله نفس عالِمنا الكبير في أحضان القديسين، وعوضه خيرًا نظير ما قدم للكنيسة من جهد ودراسة تُفيد الأجيال المتعاقبة.
أولًا: تقديم تعريف للمصطلحات الليتورجية القبطية:
كان المرحوم يسى عبد المسيح أول من وضع تعريف للمصطلحات الليتورجية القبطية أو ما يُعرف في اللغات الأجنبية باسم عِلم Terminology. فكان أول من وضع سلسلة مقالات باللغة الإنجليزية عن الذكصولوجيات القبطية، مبتدءًا بمقال يُعرف من خلاله ما هي الذكصولوجيات القبطية وإستخداماتها في الكنيسة القبطية، شارحًا أن العبادة (الليتورجيا) القبطية تنقسم إلى إجتماعين هامين، أولهما هو الاجتماع الكبير The Great Synaxisأي ما يُعرف في القبطية باسم ;ni]; `ncuna[ic والإجتماع الصغير The Little Synaxis أو بالقبطية ;kouji `ncuna[ic. والمقصود بالإجتماع الكبير خدمة القداس الإلهي، وأهم كتاب ليتورجي يُستخدم فيه هو كتاب الخولاجي، بينما المقصود بالإجتماع الصغير التسبحة وصلوات السواعي، وهذه الخدمة تعتمد بشكل أساسي على كتابي الأبصلمودية والأجبية[3]، كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. أي أن الإجتماع الكبير هو إجتماع سرائري يستلزم العنصر الكهنوتي لإتمامه، بينما لا يشترط تواجد إكليروس في الإجتماع الصغير، فهو إجتماع نشأ في الجو الرهباني حيث كان يندر التواجد الإكليريكي قديمًا. كما أن هذا الجزء من العبادة يستطيع المؤمن البسيط (رجلًا كان أم إمرأة) أن يؤديه بمفرده، كجزء من جهاده الشخصي.
ثم عاد وفند حديثه عن الذكصولوجيات في مقالين أخرين، أولهما عن تلك الذكصولوجيات الغير مستخدمة في كنيستنا الآن، أي الذكصولوجيات القبطية باللهجة الصعيدية[4]، وثانيهما عن الذكصولوجيات القبطية باللهجة البحيرية المستخدمة الكنيسة، والتي سبق ونُشرت بالطبع[5]. وللتفصيل نشر الذكصولوجيات البحيرية المُستخدمة بالكنيسة الآن على جزءين الجزء الأول من شهر توت إلى شهر كيهك[6]، والجزء الثاني من شهر طوبه إلى النسئ[7].
كما وضع مقالًا عن بعض الإبصاليات القبطية النادرة، مثل: مقالته عن إبصالية رومي (يوناني) عربي، التي نشرها باللغتين الإنجليزية[8] والعربية[9].
كما وضع تصنيفًا لهذه المصطلحات، أي ما يُعرف في اللغات الأجنبية باسم عِلم Typology، حيث كان أول من كتب عن عِلم Coptic Hymnology[10] أي الإيمنولوغيا القبطية، أي عِلم دراسة تاريخ وأصول قِطع التسابيح والألحان القبطية[11]، ثم تبعه كثيرون مقتفين أثره، ومتعلمين من منهجه العلمي في البحث والدراسة.
ثانيًا: تأريخ للعديد من الطقوس الكنسية:
كما كتب عن الليتورجيات الشرقية[12]، وزي إكليروس الشرق أي الملابس الكهنوتية: سواء الرهبان في الأزمنة السالفة أو الأساقفة والقسوس والشمامسة أيضًا[13]، والأواني المستعملة في الكنائس الشرقية أثناء تأدية الشعائر الدينية[14].
ومن الطريف أن هذه المجموعة من المقالات لم تأتي من فراغ، ولكن كانت نتيجة مجموعة من أبحاثه المدققة، بالإضافة إلى عدد من المرسلات بينه وبين المتنيح الأنبا مكاريوس مطران أسيوط السابق (1897-1944م)، الذي صار فيما بعد قداسة البابا مكاريوس الثالث الـ 114 (1944-1945م)[15]. ومن أهمية هذه المجموعة من المقالات، نشرتها ثانيًا جمعية مار مينا بالإسكندرية في كتابين.
حيث ذكر في هذه المجموعة من المقالات عدة أمور هامة، مثل:
1- كان الرسل لا يقيمون ليتورجية الا وهم صائمون، إستنادًا على ما جاء بسفر أعمال الرسل (13: 2).
2- لا يجوز لأحد من المؤمنين الدخول للكنيسة إلا وهو حافي القدمين وعاري الرأس [من قوانين البابا خرستوذولوس الـ 66 (1047- 1077م)].