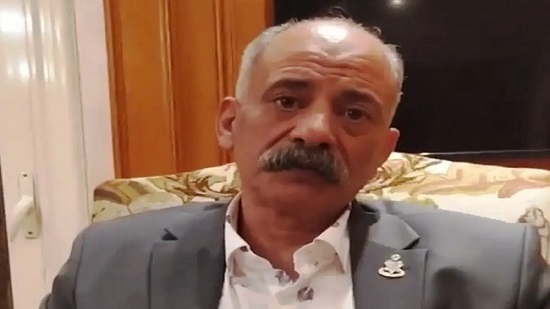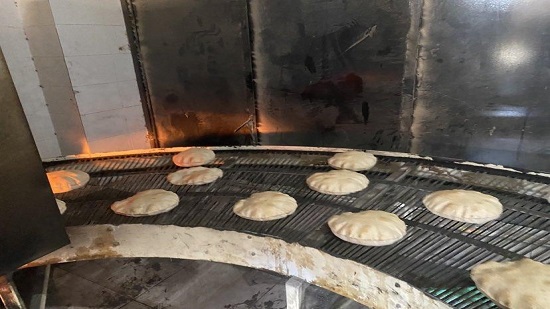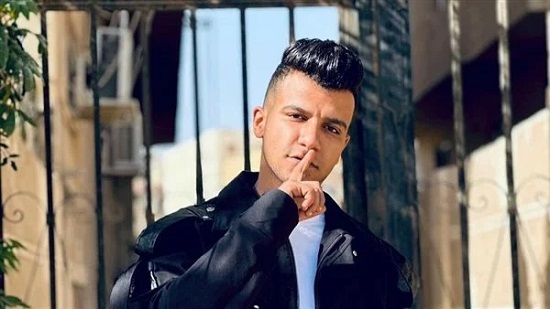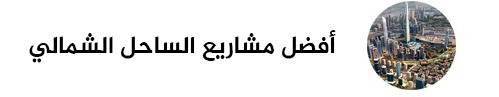نبيل عمر
توقفت عند العبارة المفتاح فى رواية شريف الشوباشى « الشيخ والفيلسوف»: من يريد أن يدرس الدين فليذهب إلى الأزهر، ومن يريد الفلسفة فعليه أن يتقبل آراء ضد الدين.
عبارة شكلت الرواية أو المناظرة بين الدكتور بسيونى أستاذ الفلسفة، والشيخ فرج إمام المسجد حول الدين والفلسفة، وهى عبارة صحيحة، فالفلسفة قائمة على السؤال والشك، والدين عمادة الإجابة واليقين، لكن هل التناقض بينهما حتمى وصراعهما بلا نهاية؟
سؤال يقفز من أحداث موثقة فى تاريخ الثقافتين المسيحية والإسلامية، فما أكثر الفلسفات التى تصارعت مع المسيحية فى الفكر الأوروبي، كما عرفت الثقافة الإسلامية كتابات ضد الفلسفة، منها كتابات حامد الغزالى عن تهافت الفلاسفة وعدم قدرتهم على فهم العالم باستخدام العقل فحسب، بل إن شيوخ الأندلس طاردوا ابن رشد وأهانوه لمجرد أنه وفق بين الإيمان والعقل، ومزج الدين بالفلسفة فى فهم الكون.
ويبدو أن الدكتور بسيونى أستاذ الفلسفة من دعاة عدم المزج، ويقطع بأن البحث الحر عن حقائق الكون يتطلب فصلا حادا بين الدين والفلسفة، كالفصل العنصرى الذى مارسته الثقافة الغربية ـــ ومازالت ـــ بين الإنسان الأبيض والإنسان الآخر.
وحين تحدث الدكتور بسيونى عن الأخلاق وتصرفات الناس فى الشارع والعمل والحياة عموما فى بلاد إسلامية (وطبعا ضرب مثالا بنا)، عزل هذه التصرفات عن البيئة التى يعيشون فيها، وربطها بالدين معيارا وحيدا لها، كما لو أن الدين عاجز عن «ضبطها»، فالناس رغم ظاهر تدينهم تحركهم المنفعة المباشرة لا الدين.
وهذا ربط تعسفي، فالإنسان عبر تاريخه كله ابن نظامه العام وقيمه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية المسيطرة فيه، فالإنسان لا يعيش فى مسجد أو كنيسة أو بيئة خالية من الصراع، وإنما فى مجتمع يختلف أفراده فى الفكر والثقافة والمصالح، لكن يجمعهم نظام عام حاكم لتصرفاتهم، وحسب كفاءة هذا النظام فى صيانة الحقوق والواجبات والعلاقات، تتشكل مجموعة قيم وعادات تشيع بين هؤلاء الأفراد، ويتصرفون على أساسها إلى جانب الدين!
مثلا تصرفات أهل الغرب فى الحياة العامة سواء كانوا متدينين أو ملحدين يضبطها نظام صارم وقانون نافذ وليس حب الأخلاق أو المثل العليا، وإذا ضعفت قبضة النظام والقانون بضع ساعات تنقلب الحياة إلى فوضي، وقد حدثت مرات فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا، أى أن الدين والفلسفة ليس بينهما تناقض أو توافق فى تفسير سلوكيات المجتمع، نعم هما يتحدثان عن الأخلاق والقيم الحميدة، لكن كلا بطريقته، لا اختلاف الدوافع، واختلافها لا يعنى تناقضا.
ويقصف الدكتور بسيونى الدين بحجج قوية ، مصدرها ممارسات رجال دين يهود ومسيحيين ومسلمين عبر التاريخ.
وأتصور أنه خلط فى هذه الحجج متعمدا بين رجال الدين والدين، فرجال الدين ليسوا هم الدين، ولا يمكن أن تكون تصرفاتهم أو مفاهيمهم حجة على دينهم.
وإذا تحدثنا عن الإسلام، إذ نال النصيب الأكبر من قذائف الفلسفة، من البديهى أن كتابات الفقهاء والأئمة مجرد اجتهادات بشرية فى أزمانهم حسب الحالة العقلية والمعرفية، ورغم كونها تراثا عظيما، فقد نجد فيه الصائب الصالح وقد نجد ما نختلف معه، لكن بالقطع نستطيع أن نتجاوزه بتفسيرات مختلفة وفق المفاهيم الكلية للقرآن عن العدالة والحق والخير ومكارم الأخلاق والدفاع عن النفس..إلخ.
وإذا كان الفيلسوف لديه نزعة غريزية لإعادة النظر فى الواقع والحقائق الموروثة ليجدد فكر العالم، هذا أيضا متاح فى الدين، لكن الله فوق الواقع، أما البشر فهم أعلم بشئون دنياهم، يغيرون ويبدلون فى واقعها كما تقتضى مصالحهم وقوانين العلوم المتغيرة، وهذا وارد فى نصوص قرآنية وفى الأحاديث النبوية، فالرسول والمسلمون الأوائل لم يتزوجوا على مذهب الإمام أبى حنيفة، لكن المسلمين المحدثين فعلوا وإذا لم يفعلوا فلا تثريب عليهم، وأيضا لم يعرف المسلمون الأوائل مذهب الإمام أبى حنبل أو تفسيرات الأشعرية، وبالطبع هى غير ملزمة لأى مسلم، أما تمسك رجال الدين الحاليين بالمذاهب والتفسيرات القديمة فهو جزء من عقلية سائدة وثقافة شرقية محافظة تكره التجديد، ولا علاقة للدين بهذه الحالة.
وأصل الإسلام وفصله فى القرآن وفى السنة المؤكدة التى تفسر مفاهيم القرآن ولا تناهض العقل، ثم نأتى إلى المفاهيم التى أمسك بها الدكتور بسيونى نقدا، كالجزية، والطاعة، ومشيئة الله وحرية الإنسان..وغيرها.
كلمة الجزية لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدا وفى سورة واحدة، ولها ظرف خاص، أى ليست أصلا فى العقيدة ولا فرعا، وإلا أوردها القرآن أكثر من مرة لتأكيدها كما فعل فى الأحكام، وطاعة أولى الأمر كما واضح من سياق الآيات جاءت من باب تنظيم العلاقات وليس من باب الإذعان والعبودية إلا لله، أما مشيئة الله فالدكتور بسيونى يفهمها على أنها إجبار البشر على فعل ما، يجب ألا يحاسبوا عليه، هذا فهم ناقص، فمشيئة الله هى علم الله، وعلم الله مطلق، فإذا قال لنا إنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء، فهو عالم بأن هذا الإنسان أو ذاك سيهتدى أو يضل لأسباب كامنة فى نفسه وتفكيره، وحين يخبرنا بذلك، يخبرنا بعلمه وليس بفرض الهداية أو الضلال عليه، والله خلق الأسباب كلها أنواعا وأشكالا وظروفا ودوافع حين خلق الكون، وعندما يعمل الإنسان بالأسباب تتحقق نتائجها.
المدهش أن بطل الشيخ والفيلسوف يبدأ الحكى بحادثتين من رواية الغريب لألبير كامو، موت أم «مورسو» فلا يكترث، ثم يقتل شخصا مجهولا على شاطئ البحر، لأن أشعة الشمس كانت قوية!
هذا ما كتبه الفيلسوف كامو ويستحيل أن يفسره العقل، فالإنسان اكثر تعقيدا من عقله.
نقلا عن الاهرام