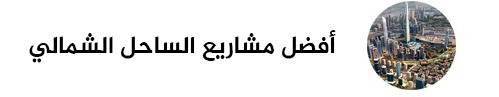حلمي النمنم
فى الأسابيع الأخيرة ازدادت الأحاديث عن أن نتائج الحرب العالمية الثانية والتى تشكل أسس النظام العالمى القائم تراجعت، بل لا يصح أن تبقى قائمة، فى الحدود الدنيا هى قيد المراجعة وصولا إلى التخلص منها.
هذه الأحاديث ترددت بقوة فى الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعضها نسب إليه شخصيا، ترامب لا يتردد فى أن يقول ما يريد بطريقته، مطيحا بكل قواعد البروتوكول والتقاليد الدبلوماسية.
لم يكن الرجل بحاجة إلى أن يتحدث صراحة فى ذلك، الوقائع والسياسات التى يتبعها منذ العشرين من يناير تؤكد ذلك المعنى بوضوح.
بدأت الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة خارجها، ليست طرفا فيها، بدأت حربا أوروبية/ أوروبية فى المقام الأول، لكن ما لبث هتلر أن وسع دائرة الحرب، ثم ارتكبت اليابان حماقة مهاجمة الولايات المتحدة فى عقر دارها، هجمات «بيرل هاربور» فدخلت الولايات المتحدة الحرب بكل ثقلها وقرر الرئيس هارى ترومان أن يكتب السطر الأخير فى الحرب بإلقاء أول قنبلة نووية على هيروشيما ثم قنبلة ثانية على ناجازاكى، إذلالا لليابان وإعلانا للعالم كله بمدى القوة الأمريكية وقدرتها على إزاحة من يتحداها أو يتجرأ على مناوشتها.
كان العالم منهكًا من الحرب ويبحث عن لحظة هدوء وسلام، صدق الجميع ما رأوه بأعينهم فى هيروشيما.
وهكذا انتهت الحرب والولايات المتحدة هى زعيمة «العالم الحر»، تقود الغرب كله وتتولى حمايته، المقصود هنا أوروبا (الغربية) فى المقام الأول. والحماية عسكرية بضمان عدم مهاجمة الاتحاد السوفيتى (روسيا حاليًا) لها، خاصةً بالسلاح النووى، حين انتهت الحرب كانت الولايات المتحدة هى الدولة النووية الوحيدة وكان معروفا أن ستالين يسعى لامتلاك هذا السلاح. وقد امتلكه بأسرع مما توقع الجميع، امتلك السوفييت القنبلة النووية سنة 1949، هنا باتت الحماية الأمريكية لأوروبا ضرورة وطنية وإنسانية، خاصة أن الولايات المتحدة قدمت مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا المدمرة من الحرب، باختصار قوة دفاع وحماية وقوة بناء وإعمار.
هناك كذلك الحماية السياسية والفكرية والثقافية (الأيديولوجية) من الأفكار الماركسية، التى يقوم عليها الاتحاد السوفيتى، وكان المشروع الأمريكى يقوم على أن الحماية الثقافية ومحاصرة الأفكار السوفيتية (المادية الجدلية) فى كل مكان، حتى خارج أوروبا، يمكن أن تمتد إليه، خاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث مصادر الطاقة ومنابع البترول، بالإضافة إلى الممرات المائية، فى المقدمة منها قناة السويس.
اتخذت الحماية السياسية والفكرية خطوات ثلاث:
الأولى: تبنى الفكرة الديمقراطية كمشروع للحكم وذلك بتبنى التعددية الحزبية والحريات العامة. شهدت تلك السنوات تأسيس العديد من دور الصحف، مؤسسات للنشر تم دعمها، بل تأسيسها، كتاب ومؤلفات تم الترويج لها، كتب بعينها تمت ترجمتها إلى العربية تركز على فكرة الحريات العامة والخاصة، حرية التعبير والتفكير تحديدا، جرى ذلك فى كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة ذاتها وفى أوروبا، وجرى كذلك فى منطقتنا العربية، كل ذلك كان بدعم مباشر من المخابرات الأمريكية، للحد من انتشار أفكار وكتاب اليسار الاشتراكى، كان الأمر معروفًا للبعض، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى تكشفت الكثير من الوثائق، كتاب «من يدفع للزمار.. الحرب الباردة الثقافية» ملىء بالوقائع والأسماء، الكتاب للباحثة ف. س. سوندرز، ترجمة الصديق الراحل طلعت الشايب، يمكن أيضا مراجعة كتاب د. غالى شكرى عن الأرشيف السرى للثقافة المصرية، بعض المخضرمين فى الحياة الثقافية يعرفون الكثير وبالأسماء.
ولابد من التوقف هنا، ذلك أن فكرة الحرية ورفض الاستبداد قديمة جدا فى المسيرة الإنسانية، حتى قبل اكتشاف «العالم الجديد» وظهور الولايات المتحدة، وليس كل من تمسك بالحرية وطالب بها ممولًا ولا مدفوعا من الولايات المتحدة، أسماء مثل عبدالرحمن الكواكبى وقاسم أمين ولطفى السيد، سبقوا تلك المرحلة بوقت طويل، الحديث عن أولئك الذين ظهروا فجأة فى تلك الفترة وجعلوا من هذه الفكرة النبيلة قميص عثمان يتكسبون به ويزايدون على الآخرين باسمه.
الثانية: الدعوة إلى قدر من «العدالة الاجتماعية» لمواجهة تغلغل الأفكار الاشتراكية، على الأقل سد الذرائع أمام الترويج لها، يمكن القول إن فكرة العدالة الاجتماعية وجدت أرضا خصبة لها فى أوروبا، تحديدا بريطانيا، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ونجاح الثورة البلشفية فى روسيا وارتفاع مد ستالين، لكن بعد الحرب الثانية صارت «العدالة الاجتماعية» هدفًا متفقا عليه فى معظم دول العالم، لتجنب البديل الشيوعى.
الملك فاروق نفسه تبنى هذا الشعار فى مصر مع نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه وقف به عند حد معين واعترض بشدة حين طالب البعض فى مجلس النواب ثم فى مجلس الشيوخ بتحديد الملكية الزراعية.
الثالثة: توظيف الدين سياسيًا وأيديولوجيا بدعوى أن النظرية الاشتراكية قائمة على الإلحاد وإنكار وجود الله، فى سبيل ذلك برز دور الكنيسة فى الولايات المتحدة وأوروبا وظهر من يسمون «الدعاة الجدد». خارج بلاد الغرب دعمت الولايات المتحدة- المخابرات المركزية- ما أطلق عليه «لاهوت التحرير» فى أمريكا اللاتينية، رحم الله د. حسن حنفى الذى ألح على ظهور مثل هذا اللاهوت فى مجتمعنا، وتبنى لسنوات فكرة إقامة ما سماه «اليسار الإسلامى»، ثم انصرف عنها إلى مشروعه «التراث والتجديد».
خارج أمريكا اللاتينية، فى منطقتنا العربية دعمت الولايات المتحدة جماعة حسن البنا واتخذت موقفًا عدائيًا من الملك فاروق بعد اغتيال البنا، فى سنة 1953، استقبل الرئيس الأمريكى فى المكتب البيضاوى سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، بينما لم تتم دعوة الرئيس محمد نجيب، رغم أنه كان يحظى بتقدير أمريكى. دعمت الولايات المتحدة كذلك عملية «الجهاد فى أفغانستان» سنة 1979، بدعم مالى مفتوح وتقديم «صواريخ استنجر»، المحمولة على الكتف، للمجاهدين، رغم أنها حرمت منها الجيوش الحليفة لها فى المنطقة.
ولما انتهت الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفيتى سنة 1990، تحولت الديمقراطية من خطوة إجرائية ونظام مفضل إلى هدف مطلق، بغض النظر عن أى ظروف خاصة، ومن لا يلتزم به يجب إسقاطه فورا، هكذا فعل جورج بوش الابن ثم من جاء بعده «باراك أوباما»، الذى قدم نفسه باعتباره «نبى الديمقراطية» وحامى حمى «الدين السياسى»، فجاءت النتائج عكسية وكارثية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فى منطقتنا تحديدا.
بعد الحرب العالمية الثانية كان يمكن للولايات المتحدة أن تتغاضى عن الديمقراطية فى بلد ما، إذا كانت الدولة لا تأخذ بالنظام الاشتراكى وتعادى الشيوعية، بل كانت على استعداد للوقوف ضد الديمقراطية، إذا جاءت باليسار الاشتراكى، حدث ذلك مرة فى إيطاليا وفى غيرها، لم تكن الديمقراطية مقصودة لذاتها، بل لمقاومة النفوذ السوفيتى، لكنها مع أوباما صارت هدفا بحد ذاته، طبعا الديمقراطية وفق رؤية أوباما نفسه.
اليوم مع الحديث الصريح عن انتهاء نتائج أو نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الاقتصادية الضروس التى أشعلها ويصر عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يجب أن نتوقع تراجعا كبيرا فى مسألة العدالة الاجتماعية وفى مسار الديمقراطية، وربما كذلك التوظيف السياسى للدين.
ارتفاع نسب الجمارك يعنى تراجع تبادل السلع والبضائع بين الدول وارتفاع الأسعار العالمية، وهذا يعنى تراجع حظوظ الفقراء اقتصاديا وعلى مستوى الخدمات أيضا، وكذلك تراجع فرص الانتقال إلى أوروبا والولايات المتحدة التى تراود شباب كثر حول العالم، بما يعنى ازدياد المشاكل والضغوط الداخلية فى كثير من دول العالم فى إفريقيا وآسيا تحديدا.
أما عن تراجع الديمقراطية وسيادة الدول فحدث ولا حرج، ما يجرى فى غزة نموذجا، قبل ذلك ما كان مسموحا لإسرائيل أن تصل فى التدمير إلى هذا المدى ولا أن تشن حربا طويلة المدة وتعتدى على الأراضى السورية واللبنانية إلى هذا الحد، والضمير الأمريكى مرتاح ومطمئن.
الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أحالها الرئيس ترامب إلى كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقد استجابا وبدأت اجتماعات التنسيق بينهما، كل هذا والإدارة السورية مستبعدة تماما.
هل الرئيس ترامب حالة استثنائية؟
قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، لكن هذا الرجل تعبير عن عصر وبيئة كاملة، هو جاء بالانتخابات وفاز بأغلبية مريحة جدا جدا، وفى أوروبا يتقدم «اليمين المتطرف» فى العديد من البلدان.
أخشى القول إننا نسير نحو عالم يقترب من عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى.
هل الرئيس ترامب حالة استثنائية؟ قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، لكن هذا الرجل تعبير عن عصر وبيئة كاملة، هو جاء بالانتخابات وفاز بأغلبية مريحة جدا جدا، وفى أوروبا يتقدم «اليمين المتطرف» فى العديد من البلدان.أخشى القول إننا نسير نحو عالم يقترب من عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى.
نقلا عن المصري اليوم