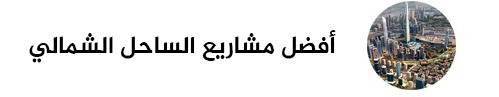الدكتور مهندس/ ماهر عزيز
تقاليد اختيار بطاركة الكنيسة القبطية
على مدى ألفي عام
بحث من إعداد :
سعد مايكل سعد ؛ ونادين سعد ريجلز ؛
ودونالد ويستبروك
.
ترجمه إلى العربية:
الدكتور مهندس/ ماهر عزيز
استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ
.
[ قصة الترجمة :
نشرت عقب انتخاب البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان مقالا بعنوان :
" الاختيار الحر والقرعة الهيكلية:
علي هامش اختيار بابا الفاتيكان "
ولقد أثار المقال مناقشات مهمة ، بادر بإحداها الكاتب والناقد والحقوقي والمؤرخ القبطي الكبير المهندس/ عادل جندي ، الذي تفضل وأرسل لي بحثا باللغة الإنجليزية في صميم الموضوع المثار ، ولقد وجدت البحث مهما للنشر باللغة العربية ، فعكفت علي ترجمته لتعميم الفائدة للإخوة والأخوات المهتمين والمتابعين ؛ وأيضا ليكون تحت نظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمع الأساقفة الموقر برئاسة غبطة البابا تواضروس الثاني . ]
ملخـــص البحث :
كل من يطالع تاريخ "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" منذ بداياتها وصولًا إلى انتخاب "البابا تواضروس الثاني" عام 2012، يجد تنوعًا في طرق اختيار 118 بطريركاً قبطياً، وقد اتسمت هذه الطرق في جوانب معينة بالتفرد في تاريخ المسيحية. وتتضمن الدراسات المتاحة حول تقاليد اختيار بطاركة الكنيسة القبطية في الأغلب تعميمات بدلًا من التركيز على التحليل الإحصائي الدقيق، ولذا تركز هذه الدراسة على كيفية علاج هذا القصور من خلال إجراء تحليل تاريخي وكمي لطرق اختيار البطريرك على مدار قرابة ألفي عام من تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقد تم تحديد طرق الاختيار الثمانى التالية بحسب ترتيب تواترها: إجماع الآراء بين رجال الدين والعلمانيين، والانتخاب من قِبل كهنة الأسكندرية، والتعيين من قِبل السلف، والانتخاب من قِبل العلمانيين منفردين، وإقامة القرعة الهيكلية بين المرشحين النهائيين، وتدخل الحكومة، والتعيين أو الرؤية الإلهية، والانتخاب من قِبل الأساقفة منفردين. وعلى الرغم من تنوع طرق الاختيار، وعلى الرغم أيضًا من التجارب الاجتماعية والسياسية التي شهدها الأقباط، ظل الزخم الديمقراطي يفرض نفسه. وتتناول هذه الدراسة أيضًا تمحيصًا نقديًا لقانون انتخاب البطريرك المعمول به حاليًا، الذي صدر في مصر عام 1957، وينظم عملية إقامة القرعة الهيكلية بين أفضل ثلاثة مرشحين منتخبين.
.
1- مقـــــدمــة :
على امتداد تاريخ الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، كانت رسامة بطريرك أو بابا جديد نقطة تحول في الحياة الكنسية، إذ أن المرشح الذي يقع عليه الاختيار لهذا المنصب - وهو أعلى وأرفع درجة كهنوتية في الكنيسة - يمكن أن يشغل هذا المنصب على مدى عقود، وأن يكون له دور فعال ومحوري في التوجيه اللاهوتي والاجتماعي والسياسي للمجتمع المسيحي الذي يضطلع بالإشراف عليه. ولذا فقد خضعت عملية الاختيار دومًا لقوى سياسية واجتماعية داخلية وخارجية، وشهدت تباينًا ملحوظًا بين الكنائس المختلفة، وتطورت تطورًا كبيرًا بمرور الوقت. ويُعد تاريخ بطاركة الأسكندرية الذي يمتد لألفي عام مثالًا بارزًا على ذلك، جدير بالاهتمام على المستويين البحثي والمسكوني.
من الأهمية بمكان فهم الأبعاد التاريخية واللاهوتية لمنصب بطريرك الأقباط التي كان لها تأثيرها على عملية الاختيار، ويُرجِع الأقباط تعاقب بطاركتهم إلى مرقس الإنجيلي، كما قام بطريرك الأسكندرية، على الأخص في القرون الخمسة الأولى، بدور رئيسي كبير في تشكيل المسيحية من خلال التفسير اللاهوتي وقيادة المجامع المسكونية. يضاف إلى ذلك أن بطريرك الأقباط كان هو الزعيم الروحي لأكبر طائفة مسيحية في إقليم الشرق الأوسط، التي طالما عانت الاضطهاد الديني والعرقي، وعلى مدار الخمسين عامًا السابقة، ازداد هذا الدور اتساعًا مع تنامي دور الكنيسة القبطية بوصفها كياناً عالمياً من خلال الجاليات المهاجرة حول العالم.
وتتطرق هذه الدراسة (1) لطرق اختيار البطاركة الأقباط البالغ عددهم 118 بطريركاً،حيث تسعى لاكتشاف موضوعات مثل إجماع الآراء والديمقراطية، والخضوع للإرادة المتصوَّرة لله. وقد تكررت الإشارة في كتاب "تاريخ البطاركة"- وهو من أوائل المؤلفات المتاحة التي تناولت التاريخ القبطي- إلى إجماع "الشعب" باعتباره أحد طرق اختيار البطريرك، ومن ناحية أخرى تستعرض الدراسة قانون انتخاب البطاركة المعمول به حاليًا، الصادر عام 1957، وتناقش محتواه مناقشة نقدية في ضوء التقاليد الكتابية والرسولية والآبائية والتاريخية التي قد تدعم فلسفته ومواده.
وتتضمن الدراسات المتاحة في أغلب الأحيان تعميمات حول تقاليد اختيار بطريرك الأقباط، حيث يتضاعف هذا القصور بسبب الافتقار حتى الآن إلى عمل يتناول هذا الموضوع واسع النطاق بأسلوب منهجي ونقدي وكمي. ومن هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة تحليلًا مدعومًا بتمحيص إحصائي اجتماعي وعلمي لطرق اختيار البطاركة، كما تجيب على عدة تساؤلات، مثل: هل كانت هذه الطرق بسيطة أم معقدة؟، ديمقراطية أم ديكتاتورية؟، سرية أم شفافة؟، دينية أم جماعية؟، وإلى أي مدى كانت بمنأى عن المناورات السياسية والقوى الخارجية؟
.
2- منهجية البحث والتصنيف :
في خضم السعي لتحقيق هذه المهمة، تم البحث في طرق اختيار جميع البطاركة (118 بطريركاً)، وتم تحديد المبادئ والتقاليد ذات الصلة، ومن ثم تحديد ثماني فئات منفصلة لهذه الطرق، ولا عجب أن نجد العديد من الانتخابات البطريركية التي تمت بأكثر من طريقة، وترد هذه الانتخابات تحت الطريقة المستخدمة بدقة، وفي كل حالة ينبغي التمييز بين اختيار البطريرك وطقس الرسامة أو التكريس، الذي يتم بوضع الأيدى عقب عملية الاختيار.
وقد كان على رأس المصادر التي تم الرجوع إليها "الموسوعة القبطية"، المتاحة الآن كجزء من "موسوعة كليرمونت القبطية" على الإنترنت على الموقع التالي: www.cgu.edu/cce؛ وكتاب الليتورجيا القبطية "السنكسار" (R. Coquin and A. Atiya, CE: 2171-90)؛ وكتاب "تاريخ البطاركة"، وهو من أكثر المراجع التي تم الاستشهاد بها في المؤلفات التاريخية القبطية المتاحة (J.D. Heijer, CE: 1239-42)؛ وكتاب "باباوات مصر"، الذي يتألف من ثلاثة مجلدات، بقلم ستيفن ديفيز (2004)، ومارك سوانسون (2010)، ومجدي جرجس وبيترنيلا فان دورن هاردر (2011).
وقد تعذر تحديد طرق اختيار 25 من أصل 118 بطريركًا، حيث يعزي ذلك إلى أن المصادر المتاحة محدودة للغاية، كما لم يمكن للسبب نفسه اكتشاف أي طرق اختيار جديدة تتجاوز الفئات الثمانية المبينة فيما يلى بعد. وقد وضح أثناء البحث أنه في أغلب الأحيان لا يرد في السيرة الذاتية للبطريرك طريقة اختياره، وحتى إذا وردت، فغالبًا ما تكون مبسطة إلى حد كبير، ومن ثم فإن هذا البحث مفتوح للآخرين للاستكمال لاحقًا. وفيما يلي أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال البحث بشأن الانتخابات الـ 93 المعروفة.
.
3- طرق اختيار بطريرك الأقباط :
• الطريقة 1: انتخاب بإجماع الآراء بين رجال الدين والعلمانيين :
من بين البطاركة الذين عُرفت طرق اختيارهم البالغ عددهم 93 بطريركاً، تم ترسيم 45 منهم بعد التوصل إلى إجماع آراء بين رجال الدين والعلمانيين. ولم يوجد في المصادر سوى وصف لتلك الانتخابات بالعبارة العامة التالية: "اختار الأساقفة والكهنة والقادة العلمانيون [الاسم] بالإجماع"، أما تفاصيل العملية فلم تكن مسجلة، وكما هو متوقع كانت هنالك أوجه تباين بينها من بطريرك إلى آخر.
كان البطاركة الثلاثة الأوائل الذين انتُخبوا بهذه الطريقة هم: كلاديانوس (Celadion)، البطريرك التاسع (157-167)، ويوليانوس (Julian)، البطريرك الحادي عشر (180-189)، وأثناسيوس الأول (Athanasius I)، البطريرك العشرون (328-373). ويتضح جليًا أن ترسيخ تقليد إجماع الآراء وتطبيقه على أوسع نطاق سمحت به الديناميكية الاجتماعية والسياسية وحركة الانتقال في ذلك الوقت، ما استغرق أجيالًا عديدة.
ومن الديناميات المثيرة للاهتمام في هذا التطور انتقال الكرسي البطريركي (الباباوي) من الأسكندرية إلى القاهرة. وخلال
العصر الفاطمي- وتحديدًا خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر- تناوب الكهنة والأراخنة (القادة العلمانيون) في
الأسكندرية والقاهرة على اختيار خريستودولوس (Christodoulus) (1047-1077)، وكيرلس الثاني (Cyril II) (1078-1092) على التوالي (Den Heijer 2009: 24-42).
وخلال النصف الأول من القرن العشرين تم تنظيم إجماع الآراء من خلال إنشاء مجمع انتخابي يضم فئات معينة من الناخبين، بما في ذلك الأساقفة والكهنة والقادة العلمانيين؛ وفاز كلٌّ من الباباوات المختارين - يوأنس التاسع عشر (John XIX)، البطريرك 113 (1928-1942)، ومكاريوس الثالث (Macarius III)، البطريرك 114 (1944-1945)، ويوساب الثاني (Yusab II)، البطريرك 115 (1946-1956) - بفارق كبير.
.
• اجمالى عدد البطاركة لهذه الطريقة: 45 بطريركاً .
ترتيب البطاركة: 9، 11، 20، 22-24، 28، 36، 37، 42، 43، 45، 47، 51، 53، 54، 55، 61، 62، 63، 66-69، 72، 73، 76، 80، 81، 83، 87، 95، 100-102، 106-115.
.
• الطريقة 2: انتخاب من جانب كهنة الأسكندرية :
حتى عهد ديمتريوس الأول (Demetrius I)، البطريرك الثاني عشر (189-231)، كان أسقف الأسكندرية هو الأسقف الوحيد في مصر كلها، وترأس مجلسًا ضم اثني عشر كاهنًا، وعند وفاته، انتخب الاثنا عشر خليفةً له من بينهم، ثم وضع الأحد عشر الآخرون أيديهم عليه (M. Shoucri, “Patriarchal Election” CE: 1911-2). ويتوافق هذا مع أدب الكنيسة القديم الذي يصف الدور البارز، بل والحاسم، لكهنة الأسكندرية، في انتخابات معظم أساقفة الأسكندرية، حتى انتخاب البابا ألكسندروس الأول (Alexander I)، البطريرك التاسع عشر (312-326) (HPCCA 1: 401-2)(2).
وعلى مدى عدة قرون بعد ذلك، وحتى في حضور أساقفة مصريين "وضعوا أيديهم" ورسموا بابا الأسكندرية، تشير المؤلفات إلى أن كهنة الأسكندرية أدُّوا دورًا رئيسيًا في انتخابه، بَيْدَ أن هذا الدور تراجع تدريجيًا عقب انتقال مقرّ البطريركية إلى القاهرة في القرن الحادي عشر. ومع ذلك لم ترد سوى اثنتي عشرة حالة مؤكدة لانتخاب الكهنة في كتاب "تاريخ البطاركة" أو الموسوعة القبطية، وقد يفوق العدد الفعلي للحالات المؤكدة ذلك بكثير، خاصة أن هذه الدراسة لم تتمكن من كشف طرق اختيار خمسة وعشرين بطريركًا، ربما يكون بعض منهم قد انتخبهم الكهنة في الأساس.
.
• اجمالى عدد كهنة الأسكندرية: 12 كاهناً .
ترتيب البطاركة: 5-8، 10، 13-16، 18، 25، 34 .
.
• الطريقة 3: التعيين أو التزكية من قِبَل السلف :
هناك تسع حالات صار فيها أحد المرشحين بطريركًا بناءً على تعيين سلفه أو توصيته أو دعمه الضمني. وكانت أولى هذه الحالات حالة أنيانوس (Anianus)، البطريرك الثاني (68-85). احتاج القديس مرقس (St. Mark) إلى سيامة قائد مخلص جدير بالثقة لرعاية كنيسة الأسكندرية التي كانت قد تأسست حديثًا، بينما كان يقوم بالتبشير في مناطق أخرى. وكانت هذه هي الممارسة الرسولية (تيموثاوس 1 - 1: 3، تيموثاوس 2 - 1: 6، تيطس 1: 5).
الحالة الثانية كانت حالة بطرس الأول (Peter I) (300-311) الذي اختاره سلفه ثيوناس (Theonas) (282-300) (HPCCA 2: 45). كان بطرس ابن أحد كهنة الأسكندرية، ووالداه تحت الرعاية الشخصية والرعوية للأسقف ثيوناس (Theonas) (HPCCA 1:207)، وتشير تقاليد الكنيسة إلى أن بطرس كان على صلة وثيقة على المستوى الشخصي بثيوناس، الذي كان كثيرًا ما يُشار إليه باسم "والد بطرس" و"الأب الذي ربّاه" (D. B. Spanel and T. Vivian, “Peter I,” CE: 1943-7). وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بطرس الثاني (Peter II)، البطريرك الحادي والعشرون (373-380)، عيّنه سلفه الموقر أثناسيوس الأول (Athanasius I) (A. Atiya, “Peter II,” CE: 1947).
وهناك ست حالات أخرى كانت لتوصية البطريرك السابق أو دعمه الضمني أثر بالغ على انتخابهم. وكانت أمنية البطريرك الأخيرة وهو على فراش الموت تساعد على تقديم مرشح، ويُنظر إليه بعد ذلك على أنه من بين المرشحين الآخرين. وكان عدد كبير من المرشحين أيضًا من تلاميذ البطريرك السابق، وبفضل العلاقة الوثيقة التي تربط بينهم اكتسبوا مكانةً بارزةً وخبرةً واسعةً في الشئون البابوية، وهو ما كان يؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان على أنه تزكية ضمنية لترشيحهم، وقد منحتهم هذه الظروف أفضليةً على غيرهم من المرشحين، وساعدت على تعزيز إجماع عام في الآراء. على سبيل المثال، خدم بنيامين الأول (Benjamin I)، البطريرك الثامن والثلاثون (622-661)، أندرونيكوس (Andronicus) (616-622)، مما مهد الطريق لانتخابه بطريركًا (C.D.G. Muller, “Benjamin I,” CE: 375-7).
ومع ذلك لم يُطبق مبدأ تزكية أحد السلف أو تعيينه لمرشحٍ منذ اختيار غبريال الخامس (Gabriel V)، البطريرك الثامن والثمانين (1409-1427)، أي منذ ما يتجاوز ستة قرون (K. Samir, “Gabriel V,” CE: 1130-3)، وهو ما يتماشى مع روح الديمقراطية التي تمت بعد ذلك في الكنيسة القبطية.
.
• اجمالى عدد التعيين أو الموافقة من قبل السلف: وعددهم 9 بطاركة .
ترتيب البطاركة: 2، 17، 21، 38-40، 49، 50، 88 .
.
• الطريقة 4: الانتخاب من جانب العلمانيين وحدهم :
عندما طلب التلاميذ من الكنيسة اختيار سبعة شمامسة - " فَاختَارُوا أيُّهَا الإخْوَةُ مِنْ بَينِكُمْ سَبْعَةَ رِجَالٍ لَهُمْ سُمْعَةٌ حَسَنَةٌ وَمُمتَلِئِينَ مِنَ الرُّوحِ وَالحِكْمَةِ فَنوكِلَ إلَيْهِمْ هَذِهِ الخِدْمَةَ" (أعمال الرسل 6: 3( - وضعوا مبدأً للانتخابات القبطية لجميع رتب رجال الدين عبر التاريخ، وأقدم مثال على ذلك هو أبيليوس (Abilius)، البطريرك الثالث (85-98)، الذي، وفقًا للتقليد، رُسمه الرسول لوقا بعد نحو خمسين عامًا فقط من بدء التقليد الذي ينص على اختيار الشعب ورسامة الكنيسة (HPCCA 1:149)(3).
هناك سبع وقائع أخرى وردت في المؤلفات انتخب فيها العلمانيون البطريرك الجديد، على ما يبدو دون مشاركة رجال الدين. وليس من المستغرب أنهم كانوا يختارون في بعض الأحيان علمانيًا أو شماسًا، وليس راهبًا أو كاهنًا، ومن الأمثلة على ذلك يوأنس السادس (John VI)، البطريرك الرابع والسبعون (1189-1216)، الذي كان علمانيًا (S.Y. Labib, “John VI,” CE: 1341-2).
وفي بعض الحالات، تشير المؤلفات تحديدًا إلى أن أراخنة الكنيسة، وليس "الشعب"، هم الذين انتخبوا البطريرك.
وفي الحقيقة وقعت الفترة الأكثر أهمية التي طبقت فيها هذه الطريقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كان الأراخنة الأقباط هم القادة الفعليون للمجتمع القبطي، فكانوا بالتالي في مواقع تمكنهم من التأثير بشكل حاسم على عملية اختيار البطريرك (Guirguis in Guirguis and van Doorn-Harder 2011: 37-40)(4). وهناك مثال بارز آخر هو حالة البطريرك بطرس السادس (Peter VI)، البطريرك رقم 104 (1718-1726)، الذي "اختاره بعناية" الأرخن لطف الله أبو يوسف نظرًا لإعجابه بتقشف بطرس وزهده كراهب في دير القديس بولس (Armanios 2011: 34-5)(5).
.
• اجمالى عدد العلمانيين وحدهم: 8 بطاركة .
ترتيب البطاركة: 3، 19، 44، 70، 74، 77، 103، 104 .
.
• الطريقة 5: إقامة القرعة الهيكلية بين المرشحين النهائيين :
حظيت إقامة القرعة الهيكلية كطريقة لاختيار رجال الدين بدعم من الكتاب المقدس، وكتابات آباء الكنيسة، والدراسات المعاصرة. على سبيل المثال، جادل رئيس الأساقفة باسيليوس (Basilios) بأن جيروم فهم وأدرك أن كلمة "رجال الدين" مشتقة لغويًا من الكلمة اليونانية "cleros"، التي تعني "القرعة أو الميراث" (“Priesthood,” CE: 2015-6). وفي الآونة الأخيرة، أيّد دينيس ماكدونالد (Dennis MacDonald) الرأي الذي ينطوي على أن تقليد إقامة القرعة الهيكلية، كما وصفه الرسول لوقا لأول مرة في سفر أعمال الرسل - أصحاح 1، كان في الواقع موروثًا عن التقاليد اليهودية واليونانية، حيث كان يستخدم غالبًا لأغراض توزيع الممتلكات توزيعًا عادلًا، واختيار الكهنة والقضاة (2003: 107-119). ومما لا شك فيه أن إقامة القرعة الهيكلية سمةً من سمات الكتاب المقدس العبري والعهد الجديد (سفر اللاويين 16:8، سفر يشوع 7:14، سفر صموئيل الأول 14:42، وسفر يونان 1:7، والأمثال 16:33 و18:18، وسفر أخبار الأيام الأول 26:13، وإنجيل لوقا 1:9، وإنجيل يوحنا 19:24، وسفر أعمال الرسل 1: 23-26).
وكما ورد في سفر أعمال الرسل، خاطب بطرس تلاميذ السيد المسيح، الذين كانوا حوالي 120 "أخًا وأختًا" (6)، ودعا إلى إجراء عملية انتخابية لتحديد من سيخلف يهوذا (Judas): "متياس" أم "يوسف"؟ في منصب الرسول الثاني عشر. وتُوِّجت العملية بإقامة القرعة الهيكلية (أعمال الرسل 1: 15-26). وبذلك أرست القيادة المسيحية الأولى سابقةً لبعض الانتخابات البطريركية القبطية. ولقد تمت سبع وقائع على الأقل أُقيمت فيها القرعة الهيكلية بين المرشحين النهائيين. وكان أول تطبيق لهذه الطريقة عند انتخاب البطريرك الرابع، كردونوس (Cerdo) (98-109)، الذي رُسِم بعد نحو 65 عامًا فقط من اختيار التلاميذ لمتياس (Matthias) بإقامة القرعة الهيكلية، وقد ورد وصف اختيار كردونوس بإقامة القرعة الهيكلية في كتاب "تاريخ البطاركة"، وهى مفهومة بوضوح كعملية تُوجِّهها إرادة الله، كما نُفِّذت من خلال القساوسة والأساقفة (HPCCA 1:150) (7).
ومع أنه يوجد احتمال كبير أن تكون طريقة إقامة القرعة الهيكلية قد طبقت في بعض الحالات الخمس والعشرين المجهولة، فإن المثال الثاني لم يظهر في المؤلفات المتاحة لهذه الدراسة إلا بعد ستة قرون في حالة يوأنس الرابع (John IV)، البطريرك الثامن والأربعين (775-799)، الذى طبقت طريقة إقامة القرعة الهيكلية في انتخابه نتيجةً لحالة السخط الشديد التي سادت عندما رفض مؤيدو المرشحين البطريركيين الثلاثة التزحزح عن مواقفهم (HPCCA 4:381-2; S.Y. Labib, “John IV,” CE: 1338-9). أما بالنسبة للبابا ميخائيل الخامس، البطريرك الحادي والسبعين (1145-1146)، فقد أُقيمت القرعة الهيكلية في ظل عدم وجود خيار واضح (S.Y. Labib, “Michael V,” CE: 1615-6).
ويشير "مارك سوانسون" إلى أن أحد أوضح البيانات الموثقة بشأن إقامة القرعة الهيكلية لاختيار البطريرك كتقليد راسخ جاء في عامي 1216-1217، عند اقتراح هذه الطريقة (ولكن لم يتم تطبيقها) للاختيار من بين المتنافسين بعد وفاة يوأنس السادس
(John VI) (2010: 86-88). وكان أحد المرشحين هو "داود الفيومي"، الذي أصبح فيما بعد كيرلس الثالث (Cyril III)
(1235-1243)، ويرد أدناه كمثال على تدخل الحكومة في اختيار البطريرك. وقد أدرج هذا التقليد رسميًا في قانون انتخاب البطريرك لعام 1957، الذي انتُخب بموجبه البابا كيرلس السادس (Pope Cyril VI) (1959-1971)، والبابا شنودة الثالث
(Pope Shenouda III) (1971-2012)، والبابا تواضروس الثاني (Pope Tawadros II) (2012 حتى الآن)، وفي كل حالة من هذه الحالات، أُقيمت القرعة الهيكلية بين ثلاثة مرشحين نهائيين بعد وضع أسمائهم على المذبح في قداس.
• اجمالى عدد إقامة القرعة الهيكلية: وعددهم 7 بطاركة .
ترتيب البطاركة: 4، 48، 71، 105، 116-118 .
.
• الطريقة 6: تدخل الحكومة :
منذ تنصير الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي، وحتى ما بعد الفتح العربي لمصر عام 639 ميلاديًا، كان تأكيد حاكم مصر لاختيار البطريرك إجراء شكلياً (M. Shoucri, “Patriarchal Election,” CE: 1911-2). ورغم من أن الحكومة لم تكن عادةً تتدخل في شؤون الكنيسة الداخلية، إلا أنها بسطت نفوذها في بعض الأحيان على مسألة اختيار البطريرك بدرجات متفاوتة.
هناك ستة اختيارات لبطاركة كان للحكومة أو للحاكم فيها تأثير واضح، إن لم يكن فرضًا فعليًا مباشرًا، على نتيجة الانتخاب. على سبيل المثال، نُصِّبَ ديسقوروس الثاني (Dioscorus II)، البطريرك الحادي والثلاثون (515-517)، في بادئ الأمر تحت رعاية السلطات الحكومية، لكنه حصل لاحقًا على تنصيب كنسي أكثر ملاءمة (E. Hardy, “Dioscorus II,” CE: 915). وكان من أكثر الاختيارات المؤسفة المعروفة ما حدث بالنسبة إلى كيرلس الثالث ابن لقلق (Cyril III Ibn Laqlaq)، البطريرك الخامس والسبعين (1235-1243)، فقد طعن معظم الأساقفة ورجال الدين والأراخنة في ترشيحه، لكنه لجأ إلى المناورات السياسية، وتقديم الهدايا في بلاط الملك الكامل، وإلى تعزيز علاقته مع ابن الميقات، كبير كتبة السلطان الأقباط. وكان للحاكم أيضًا مصلحة في استمرار هذه الحالة من الجمود. وبعد انقضاء 19 عامًا مؤلمة، انتصر ابن لقلق والحاكم في النهاية عندما لم يكن باقياً على قيد الحياة إلا اثنين فقط من الأساقفة لإجراء الرسامة، بَيْدَ أنه قد أرغم على رد الجميل للحاكم بدفع أموال من الذهب، ونتيجة لاحتياجه لجأ إلى السيمونية والضرائب على رعيته (S.Y. Labib, “Cyril III Ibn Laqlaq,” CE: 677; Werthmuller 2010: 57-60).
ومن الأمثلة المؤسفة الأخرى على التدخل الحكومي حالة يوأنس السابع (John VII)، البطريرك السابع والسبعين (1262-1268 و1271-1293)، وغبريال الثالث (Gabriel III)، البطريرك الثامن والسبعين (1268-1271). فلقد اختير غبريال بإقامة
القرعة عام 1261، لكن الوزير ألغى النتيجة عقب تلقيه رشوة قدرها خمسة آلاف دينار؛ ولما تعذر على يوأنس دفع غرامة
قدرها خمسين ألف دينار فرضها السلطان المملوكي على الأقباط، وقام بعزل يوأنس وأعاد غبريال للرسامة عام 1268.
لكن غبريال عجز بدوره عن دفع الغرامة الباهظة، فعزله السلطان وأعاد يوأنس مرة أخرى ليشغل منصب البطريرك حتى
عام 1293 (Swanson 2010: 97-100).
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان تأثير الحكام على اختيار معظم البطاركة ضئيلًا أو معدومًا، فقد كان يحلو لبعض الحكام لاحقًا عزل البطريرك ووضع شروط قاسية لإعادته لمنصبه. ومن الأمثلة على ذلك توتر العلاقات الذى حدث لفترات معينة بين البابا شنودة الثالث وكل من الرئيسين أنور السادات (1970-1981) وحسني مبارك (1981-2011)، فعلى الرغم من أن الكنيسة اعتبرت أن تعيين الرئيس السادات للبابا شنودة بطريركًا عام 1971 إجراء شكلياً، أصدر الرئيس السادات مرسومًا في 5 سبتمبر 1981 بوضع البطريرك قيد الإقامة الجبرية في أحد الأديرة، وتعيين مجلس بطريركي يضم خمسة أساقفة للإشراف على الكنيسة، وفي 6 أكتوبر 1981 اغتيل الرئيس السادات وخلفه الرئيس مبارك، واستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات للتفاوض على شروط عودة البابا شنودة إلى مقعده البابوي، التي تضمنت قبوله تعيينًا جديدًا من قبل مبارك بدلاً من إلغاء المرسوم الصادر عن الرئيس السادات. وبالإضافة إلى ذلك وافق البطريرك على عدة شروط مقابل إطلاق سراحه، مها قيامه بزيارات منتظمة إلى الدير، ومغادرة القاهرة يوم الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين)، والموافقة على عدم الاحتجاج ضد الحكومة، وهذا الشرط الأخير جعل الأقباط بلا مدافع كنسي عن حقوق الإنسان القبطى (Watson 2000: 116, 147).
.
• اجمالى عدد تدخل الحكومة: بعدد 6 بطاركة .
ترتيب البطاركة: 27، 31، 33، 41، 75، 78 .
.
• الطريقة 7: التعيين الإلهي ، أو الرؤية الإلهية ، أو العلامة الإلهية :
على مر التاريخ كان مؤيدو هذه الطريقة يستشهدون برواية لوقا التي تفيد بأنه ما دام الرسل والإخوة يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: "خَصِّصُوا لِي بَرنَابَا وَشَاوُلَ لِكَي يَقُومَا بِالعَمَلِ الَّذِي سَبَقَ أنْ دَعَوتُهُمَا إلَيْه" (سفر أعمال الرسل ١٣: ٢)(😎. واستناداً إلى ذلك يقضي التقليد القبطي بأن القديس مرقس الرسول كان بقيادة الروح القدس لتأسيس كنيسة الأسكندرية وكان أول بطريرك لها.
ومن أشهر الأمثلة على رؤية إلهية تؤدي إلى اختيار بطريرك اختيار البطريرك ديمتريوس الأول (Demetrius I)،
البطريرك الثاني عشر (189-231). وتقول القصة أن الأسقف يوليانوس (180-189) رأى في منامه رؤيا أعلمه فيها ملاك
بأن خليفته سيأتيه بعنقود عنب في صباح اليوم التالي، وهو أمر بعيد الاحتمال تمامًا لأنه كان خارج موسمه، وحدث في اليوم
التالي أن وجد ديمتريوس، وهو مزارع، عنقود عنب في غير أوانه فحمله إلى يوليانوس على فراش موته، وتم ترسيمه في
الحال (A. Atiya, “Demetrius I,” CE: 891-3). وهنالك مثال آخر هو ترشيح خائيل الأول (Kha’il I)، البطريرك السادس والأربعين (744-767)، بعد حلم رآه أحد الشمامسة، وأخذ الأساقفة ورجال الدين والأراخنة في الأسكندرية ترشيحه بعين الاعتبار لأن مداولاتهم السابقة بشأن أسماء أخرى لم تحقق الإجماع (S.Y. Labib, “Kha’il I,” CE: 1410-2). أما في حالة بنيامين الثاني (Benjamin II)، البطريرك الثاني والثمانين (1327-1339)، فقد أيدت نبوءة للقديس برسوم العريان (توفي عام 1317) ترشيحه، ومن ثم لم يلق ترشيحه أي معارضة من قبل رجال الدين أو العلمانيين (S.Y. Labib, “Benjamin II,” CE: 377-8).
وأخيرًا أدى تفسير حدث ما على أنه علامة إلهية إلى اختيار البطريرك الرابع والستين. إذ تلقى مجلس الانتخاب في الأسكندرية - الذي لم يكن قد بت في الأمر بعد - نبأ يفيد بأن أحد التجار الأثرياء قد تبرع بالمال للحاكم بأمر الله (996-1021)، لضمان صدور مرسوم بتعيينه بطريركًا، وحدث أن ذهب كاهن متواضع يعمل كخادم لمجلس الانتخاب لاستعادة جرة خل من أعلى الكنيسة حيث عُقد الاجتماع، وأثناء نزوله على السلم انزلق وسقط لكن الجرة لم تنكسر ولم ينسكب الخل، الأمر الذي رآه الأساقفة معجزة وعلامة لهم لانتخابه، فسارعوا إلى تكريس الكاهن قبل وصول التاجر من القاهرة بمرسوم الخلافة، وأصبح رجل الدين البابا زكارياس الشهير (Pope Zacharias) (1004-1032)، وردًا على ذلك - على سبيل الانتقام- أصدر الحاكم بأمر الله مرسومًا بهدم الكنائس في جميع أنحاء البلاد، وأمر بسجن زكريا لمدة ثلاثة أشهر، بل وأمر مرتين بإلقائه للأسود، إلا أن "البطريرك القديس" كان ينجو بمعجزة في كل مرة (HPEC 2.2:174-228; S.Y. Labib, “Zacharias,” CE: 2367-8).
.
• اجمالى عدد التعيين الإلهي، أو الرؤية الإلهية، أو العلامة الإلهية: وعددهم "5" بطاركة .
ترتيب البطاركة: 1، 12، 46، 64، 82 .
.
• الطريقة 8: الانتخاب من جانب الأساقفة وحدهم :
الحالة الوحيدة في المؤلفات المتاحة التي انتخب فيها الأساقفة البطريرك دون أي إشارة إلى مشاركة الكهنة أو العلمانيين هي حالة يوساب الأول (Yusab I)، البطريرك الثاني والخمسين (830-849). ورغم أن تطبيق هذه الطريقة يبدو حالة فريدة في الكنيسة القبطية، إلا أنها صارت الطريقة السائدة في تقاليد مسيحية أخرى، مثل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حيث يعقد الكرادلة الناخبون مجمعًا بابويًا لانتخاب البابا التالي.
.
• اجمالى عدد الأساقفة وحدهم: عدد 1 بطريرك .
ترتيب البطاركة: 52 .
• اجمالى عدد غير معلوم للباحثين: وعددهم 25 .
ترتيب البطاركة: 26، 29، 30، 32، 35، 56-60، 65، 79، 84-86، 89-94، 96-99 .
.
.
4- مناقشة قانون انتخاب البطريرك لسنة 1957 :
عقب ثورة يوليو 1952 أعلن بعض القادة الإصلاحيين في حركة مدارس الأحد صراحةً عداءهم لعدد من الأساقفة المحافظين، وربما كان ذلك تأثراً بالثورة المصرية التي أطاح فيها ضباط الجيش الشباب بالنظام الملكي، إلا أن هذا العداء الصريح حدا بمجمع الأساقفة إلى استبعاد إمكانية تقلد أحد مرشحي الحركة منصب البابا عقب وفاة البابا يوساب الثاني في نوفمبر 1956. وقد كان مرشحو مدارس الأحد الثلاثة الذين ظهروا آنذاك من مواليد الأعوام 1919 1920 و1923، ولم تتجاوز خبرة كل منهم في الرهبانية تسع سنوات، مما حفز مجمع الأساقفة إلى تغيير قانون الانتخابات ليقتصر الترشيح على من تتجاوز أعمارهم الأربعين عامًا، وأمضوا مدة لا تقل عن 15 عامًا في الرهبانية (Guirguis and van Doorn-Harder 2011: 58, 127).
وقد ظهر دافع آخر عندما اتضح أن مختلف الأطراف داخل المجتمع القبطي لن تقبل بعملية الانتخابات بنظام الأغلبية البسيطة المنصوص عليها في القانون المعمول به حاليًا، ما لم يضمن فوز مرشحهم. وقد سعى مجمع الأساقفة والمجلس الملي العام إلى تهدئة الوضع، وتعزيز الوحدة داخل الكنيسة، من خلال إعادة إدخال نظام القرعة كخطوة أخيرة في عملية الاختيار، وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون الجديد في 3 نوفمبر 1957 (Saad 2014: 89).
وبموجب هذا القانون يتم ترشيح المرشحين وانتخابهم بطريقة تتسم بالديمقراطية في جميع خطوات العملية(9). إذ يتم ترشيح المرشح من خلال تزكية من ستة أعضاء على الأقل من مجمع الأساقفة، أو من اثني عشر عضوًا من أعضاء المجلس الملي العام الحاليين أو السابقين (معظمهم من الأعضاء العلمانيين)، ولا يجوز لأي مرشح تقديم أكثر من تزكيتين [المادة 4]، بعد ذلك تقوم لجنة الترشيح، التي تتألف من قائمقام البطريرك رئيسًا، وتسعة أساقفة وتسعة أعضاء من المجلس الملي العام، بإعداد قائمة نصف نهائية بالمرشحين اللائقين، على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يتجاوز سبعة، وتتضمن مهام هذه اللجنة أيضًا فحص مؤهلات المرشحين المتقدمين والاعتراضات المقدمة ضدهم [المادة 6].
ويتولى مجمع انتخابي - كان يضم 2410 قبطيًا عند إجراء انتخابات عام 2012 - تصنيف المتأهلين إلى نصف النهائيات، ويُختار الناخبون الذين يضمون الكهنة والأراخنة بجميع الأبرشيات (مع عدد أكبر من الأسكندرية والقاهرة)، وأعضاء المجلس الملي العام، ووزراء الأقباط السابقين والحاليين، وأعضاء حاليين في البرلمان، ومجموعة من ممثلي الكنيسة الإثيوبية [المادة 9]. وأخيرًا بعد إقامة احتفال خاص بالقداس الإلهي تُقام القرعة الهيكلية بين أفضل ثلاثة مرشحين نهائيين [المادة 18].
لقي قانون عام 1957 عند صدوره معارضة شديدة، لا سيما من قِبَل حركة مدارس الأحد التي كان يقودها العلمانيون، التي استُبعد مرشحوها، حتى أن بعض المعارضين طالبوا بإجراء تصويت شعبي يشارك فيه جميع الأقباط بدلاً من نظام المجمع الانتخابي، وقد بلغت المعارضة ذروتها في عامي 1957 – 1958، لدرجة أن تطبيق القانون لأول مرة استغرق قرابة 18 شهرًا، بينما ظل المقعد البطريركي شاغرًا، وعاودت المعارضة الظهور مرة أخرى خلال انتخابات عامي 1971 و2012 (M. Shoucri, “Patriarchal Election,” CE: 1911-2).
وظهرت معارضة أخرى من النخبة المثقفة من اللاهوتيين، الذين عارضوا إقامة القرعة الهيكلية، واستندوا في تبريرهم إلى أن الرسل لم يلجأوا إلى إقامة القرعة الهيكلية إلا لأنهم لم ينالوا الروح القدس حينها (لأن عيد يوم الخمسين في سفر أعمال الرسل – إصحاح ٣ جاء تالياً لإقامة القرعة الهيكلية في سفر أعمال الرسل - إصحاح 1)، بينما حَلَّ الروح القدس على الناخبين الحاليين.
على أنه رغم المقاومة والاعتراضات المذكورة أعلاه، لا يزال غالبية الأقباط يؤيدون إقامة القرعة الهيكلية كوسيلة لتدخل العناية الإلهية (Watson 2000: 45-6, 52)، ويطلبونها تعويلًا على مراجع كتابية (كما أشرنا سابقًا في الطريقة 5)، بالإضافة إلى اقتناعهم بأن الروح القدس له دور في الأحداث، كما كان الحال فى العهد القديم ومع الآباء الرسل قبل يوم الخمسين (مثل سفر التكوين1: 2، سفر التكوين6: 3، سفر الخروج31: 3، المزامير 51: 11، سفر صموئيل الأول 10: 6-7، سفر إشعياء 42: 1، سفر بطرس الثانية 1: 21، إنجيل يوحنا 20: 22). وتجدر الإشارة إلى أن نجاح وهيبة البابا كيرلس السادس، الذي انتخب بإقامة القرعة الهيكلية بينما كان ثالث المرشحين في الانتخابات، وكذلك البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثاني، وقد كان كلاهما في المرتبة الثانية في الانتخابات، قد أضفيا المزيد من الشرعية على هذه الطريقة، وعززا شهادات فاعليتها في أذهان الأقباط. (10).
يضاف إلى ذلك أن انخرط الأقباط كان عميقًا في الانتخابات البطريركية لعام 2012، حيث يعتقدون أن لهم تأثيرًا في مسارها ونتائجها، حين استجابت غالبية الأقباط لدعوة الكنيسة لثلاث فترات صوم وصلاة، مدة كل منها ثلاثة أيام. وقد كان للنقد العام للمرشحين دور واضح في العديد من القرارات التي اتخذتها لجنة الترشيح، مثل استبعاد أساقفة الأبرشيات من القائمة نصف النهائية.
.
5- الخــــــاتمـــة :
توضح هذه الدراسة – التي تناولت طرق اختيار البطاركة الأقباط - سمات وتنوع التقليد الديمقراطي السائد الذي مارسته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بداياتها. وقد اختلفت الطرق التي استُخدمت لاختيار البطريرك باختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية. ومن الجدير بالملاحظة أن مبدأ الإجماع، على مستوى معين، هو القاسم المشترك بين غالبية اختيارات البطاركة الـ 93 المعروفة لدى الباحثين. وقد تطور هذا التقليد القبطي العريق من مصادر كتابية ورسولية، وكذلك من المفاهيم الكنسية الخاصة بالأرثوذكسية والأرثوبراكسية.
وتعويلًا على ما تم التوصل إليه من نتائج، التي تُشكل إطارًا قابلًا للتحسين والتنقيح مع اكتشاف المزيد من المصادر(11)، فإن طريقة الاختيار الأكثر شيوعًا كانت إجماع الآراء بين رجال الدين والعلمانيين التي طُبقت في انتخاب خمسة وأربعين بطريركاً. كما استُخدمت سبع طرق أخرى بين الحين والآخر، فاستخدمت كل طريقة من مرة إلى اثنتي عشرة مرة. ومن الواضح أن هذه الطرق نادرة الاستخدام- باستثناء طريقة إقامة القرعة الهيكلية التي لا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر- لا تُمثل تقاليد ثابتة أو سائدة؛ وفي أفضل الأحوال كانت استجابات عملية للظروف السائدة، وفي أسوأها لم تكن سوى ممارسات غير تقليدية لم تصمد أمام اختبارات الأرثوذكسية والديمقراطية وتاريخ الكنيسة. والجدير بالذكر أن أكثر الطرق البعيدة كل البعد عن الديمقراطية – وهي التعيين من قبل السلف، وتدخل الحكومة، وعمل الأساقفة بمفردهم - لم تُمارس منذ عدة قرون.
وللأسباب الواردة أعلاه، يمثل قانون عام 1957 عملية ترشيح وانتخاب متطورة وشفافة من قبل رجال الدين والعلمانيين. ولإضفاء مزيد من الصبغة الديمقراطية لهذا القانون، عيّن البابا تواضروس الثاني لجنة لدراسة القانون والتوصية بتعديلاته بعد تقلده منصبه بفترة وجيزة عام 2012، وفي 20 فبراير 2014 وافق مجمع الأساقفة على المسودة الجديدة التي أعدتها اللجنة. وقد تمحورت التغييرات المقترحة حول معايير تأهيل المرشحين، ولجنتي الترشيح والانتخاب، والناخبين، وإشراك الراهبات، وجميع الكهنة المكرسين، والمجالس الملية من جميع الأبرشيات في المجمع الانتخابي. وقد كان هذا الإشراك في السابق يتم بحسن نية لجنة الانتخابات أو أساقفة الأبرشيات، الذين يختارون بأنفسهم الممثلين الانتخابيين بالاختيار الشخصى المباشر.
وتعكس مبادرة البابا تواضروس لمناقشة نقاط القوة والضعف في قانون عام 1957، في حد ذاتها، النبض الديمقراطي في عملية انتخاب البطريرك القبطي، التي تعود إلى ألفي عام. ورغم النواقص في القانون الحالي والتعديلات المقترحة عليه، لا يزال لهما دور محوري في الحفاظ على ديمقراطية الكنيسة وممارساتها. ومن المرجح أن تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - التي وُصفت عن حق بأنها أقدم مؤسسة ديمقراطية في مصر - تعديل نفسها نحو إشراك أعضائها على نحو أكثر شمولاً في اختيار وريثها للكرسى المرقسى.
.
الحـــواشــى :
1- تم نشر النتائج الأولية لهذه الدراسة مسبقًا (سعد وسعد، 2001). ومنذ ذلك الوقت، ساهمت الأبحاث والمنشورات الأحدث في تحسين التحليل التاريخي الإحصائي وتوسيع نطاقه، وفي تنقيح الاستنتاجات وتوسيع نطاقها.
2- كما كتب ستيفن ديفيز 2004: 135، "يشير الأب جيروم في إحدى رسائله (حوالي 347-419/20) أنه في كنيسة الأسكندرية، اعتادت مجموعة من الكهنة انتخاب الأسقف الجديد من بين صفوفهم، وأنهم واظبوا على هذه الممارسة حتى زمن هرقل (Heracles) وديونيسيوس (Dionysius)... وتشير بعض المصادر الأخرى إلى أن انتخاب الكهنة لبطريرك الأسكندرية قد يكون استمر حتى أوائل القرن الرابع؛ بيد أنه، من المؤكد أن هذه الممارسة كانت قد توقفت في الوقت الذي انتُخب فيه أثناسيوس الأول (Athanasius I) عام 32. انظر أيضًا ديفيس 2004: 238، الحاشية رقم 4. يصف هاس (Haas) 1997: 217-222 هذه العمليات بالإضافة إلى الخلفية الاجتماعية والسياسية للانتخابات البطريركية في القرون الخمسة الأولى.
3- إذا كان لوقا هو من وضع يده على أبيليوس، كما ورد في الدساتير الرسولية (السفر 7)، فإن المثال الرسولي لانتخاب العلمانيين كان أكثر شيوعًا مما يُعتقد.
4- للاطلاع على المزيد عن هذه الفترة الانتقالية الفريدة، انظر جرجس ٢٠٠٠ (Guirguis 2000).
5- لا يقتصر التأثير الحاسم لشخص واحد على نتيجة عملية اختيار البطريرك على الطريقة الرابعة (العلمانيون وحدهم). مثال آخر هو كيرلس الثالث (Cyril III) كما هو موضح في الطريقة السادسة (التدخل القوي للحكومة).
6- تستخدم النسخة المترجمة للكتاب المقدس TNIV (النسخة الدولية الجديدة) عبارة "الإخوة والأخوات" (أعمال الرسل ١: ١٦)، بينما تستخدم ترجمات أخرى، مثل NRSV (الترجمة القياسية المنقحة الجديدة)، وترجمة NKJV (الملك جيمس الجديدة)، عبارة "الرجال والإخوة". ويُعتقد أن كل الترجمات تُقر بدور المرأة في عملية الترشيح لاختيار الرسول الجديد.
7- من الناحية التاريخية، تجدر الإشارة إلى أن هذه السردية من كتاب "تاريخ البطاركة"(المجلد الأول) تُمثّل سجلاً من القرن الحادي عشر لحدث من القرن الأول. ومع ذلك، يُفترض أن المصادر المستخدمة في صياغتها أقدم بكثير، حتى وإن كان مصدرها الدقيق مجهولًا.
8- في هذا الصدد نشير إلى أنه تم الاستشهاد بهذا المقطع في كثير من الأحيان لدعم تعيين الأسافقة للبطريرك من جانب واحد، وبالتالي، دعم تعيين الأساقفة للقساوسة.
9- الترجمة الكاملة للقانون متاحة في Meinardus 1970: 128-38.
10- إقامة القرعة الهيكلية طريقة معترف بها حتى في دساتير وقوانين العديد من البلدان والمنظمات.
11- من اللافت للنظر أن 13 حالة من أصل 25 حالة مجهولة للمؤلفين تتركز في الفترة من 1349 إلى 1634. وهؤلاء البطاركة الثلاثة عشر هم من بين 16 بطريرك مرقمين من 84 إلى 99. قد تكشف الأبحاث في المستقبل في المكتبة البطريركية القبطية والأديرة المصرية عن طرق اختيارهم.
.
المراجــــع ;
1) مجلة الدراسات القبطية – المجلد 16 (2014) 139-153 - doi: 10.2143/JCS.16.0.3066725.
2) Armanios, Febe : 2011 – المسيحية القبطية في مصر العثمانية - نيويورك
3) Atiya, Aziz S. : 1991 – الموسوعة القبطية – نيويورك – متاحة الآن على رابط موسوعة كليرمونت القبطية (www.cgu.edu/cce)
4) الموسوعة القبطية - انظر Atiya
5) Davis, Stephen J. : 2004 – البابوية القبطية المبكرة: الكنيسة المصرية وقيادتها في أواخر العصر القديم - القاهرة
6) Den Heijer, Johannes : 2009 – "وادي النطرون وتاريخ بطاركة الأسكندرية" – في: ماجد ميخائيل ومارك موسى (محرران) – المسيحية والرهبنة في وادي النطرون - القاهرة 24-42
7) Haas, Christopher : 1997 – الأسكندرية في العصر القديم: الطوبوغرافية والصراع الاجتماعي – بالتيمور
😎 Guirguis, Magdi and van Doorn-Harder, Nelly – 2011 – نشوء البابوية القبطية الحديثة: الكنيسة المصرية وقيادتها منذ العصر العثماني حتي الآن - القاهرة
9) Guirguis, Magdi : 2000 - أثر الأراخنة على أوضاع القبط في القرن الثامن عشر - AnIsl 34, 23-44
10) تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية بالأسكندرية: ترجمة وتحرير إيفيت باسل توماس ألفريد – PatrOr 1.2, 1.4, 5.1, 10.5. - باريس – 1904-15
11) تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية (تاريخ الكنيسة المقدسة): ترجمة وتحرير أوزوالد هوج إيوارت بورميستر وآخرون - 3 مجلدات - Textes et Documents de la SAC 2.1-3, 3.1-3, 4.1-2 – القاهرة – 1943-74
12) Meinardus, Otto F. A. : 1970 – مصر المسيحية: الإيمان والحياة – القاهرة
— 1999 – المسيحية القبطية في ألفي عام - القاهرة
13) MacDonald, Dennis R. : 2003 – هل يقلد العهد الجديد هوميروس؟ أربع حالات من أعمال الرسل - نيوهافن
14) Saad, Saad Michael and Saad, Nardine M. – 2001 – "انتخاب البطاركة الأقباط: تنوع التقاليد" - Bulletin of Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society - 6 - 20-32
15) Saad, Saad Michael : 2010 – "الحياة المعاصرة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية في الولايات المتحدة"- دراسات في المسيحية العالمية- 16 -207-25
16) 2014 : "العصر الحديث (1952-2011): - في لويس فرج (محرر) : التراث المسيحي القبطي: التاريخ والإيمان والثقافة - لندن – 87-102
17) Swanson, Mark N. : 2010 – البابوية القبطية في مصر الإسلامية – 641-1516 – القاهرة -
18) Watson, John H. : 2000 - بين الأقباط - برايتون - المملكة المتحدة
19) Werthmuller, Kurt. : 2010 - الهوية القبطية وسياسات الدولة الأيوبية في مصر – 1218 -1250 – القاهرة
المؤلفــــون:
• سعد مايكل سعد
موسوعة كليرمونت القبطية
جامعة كليرمونت للدراسات العليا
• نادين سعد ريجلز
• دونالد ويستبروك
قسم الدراسات الدينية
جامعة كليرمونت للدراسات العليا
المترجـم:
.
• الدكتور مهندس/ ماهر عزيز
استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ
.