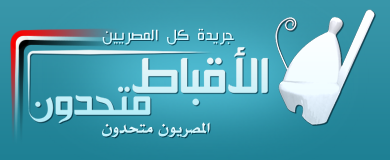إرهاب.. تحت قنــاع الفلسفة
بقلم: سهيل أحمد بهجت
الإنسان بما أنه كائن محدود الوجود حاله في ذلك حال سائر الموجودات التي لها بداية ونهاية، قد يبقى أسيرًا لهاجس الحتميات المادية والإلهية، والحقيقة أن الإنسان كائن حرّ ومجبر في الوقت نفسه، أو كما يقول جعفر بن محمد الصادق: "لا جبر ولا تفويض ولكن أمرُ بين الأمرين".. أي أن الإنسان يعيش ممتزجًا بالحالتين، فهو لا يملك قرار وجوده أو اختيار لونه واسمه وطبيعة هيئته، لكنه حينًا آخر يجد نفسه قادرًا على الاختيار بين قرارين متناقضين وأن يتخذ قرارًا مُناقضًا لرغباته ونزواته لأنه يمتلك مباديء أو يؤمن بمنهج معين، ولكن حتى هذه القرارات قد يتخذها مُجبرًا أحيانًا دون أن يشعر بذلك، وهذه القضية وإن بدت طوال التاريخ الإسلامي كقضية لاهوتية ثيولوجية، إلا أنها كانت تحمل بُعدًا سياسيًا في المضمون، فنجد مثلاً أن مَن كانوا يُسمون بالقدرية (رغم إنكارهم للقدر كحتمية) كانوا يُضطهدون باسم الرافضة "أي الشيعة حسب تعبير خصومهم" أو "الزندقة ـ وهم كل من جابه عقيدة الدولة"، بالتالي فإن كون الإنسان متأثرًا ومؤثرًا مسألة لا يمكن إنكارها، غير أن الإيمان بالإنسان الطبيعي لا يعني مطلقا اختفاء الإنسان ليُصبح جزءًا من هذه الطبيعة، فهو طبيعي من جهة التأثر وفوق طبيعي في التأثير على الطبيعة.
إن النازية، وهي من أحب الأمثلة لدى المسيري والتي يُوجِّه من خلالها الطعن إلى الحضارة الغربية، كانت مِنهاجًا ماديًا متطرفًا، والتطرف ظاهرة تشمل بدايات ظهور كل نظرية، فالخوارج على سبيل المثال كانوا من ضمن التطرف الذي رافق ظهور الإسلام ولكن حينما نسأل هؤلاء المفكرين في العالم الإسلامي: هل أن الإسلام يظهر جليًا في أفعال الخوارج كالأزارقة وغيرهم؟ أم أنهم كانوا يُمثلون "فهمًا جزئيًا" مُحاطًا بغلاف من الجهل الذي يسهل عليه تعميم الفكرة الجزئية، كما أن فكر الخوارج رغم تطرفه كان لا يخلو من إيجابيات، كتحويل الدين إلى مُدافِع عن هموم الشعب، ولكن المسيري هنا يُصر على أن النازية ـ وهي قد هُزِمت واندثرت منذ 60 عامًا ـ هي التجلي الفعلي والواقعي لفلسفة الغرب (المادّية)، والحقيقة أن الإسلام نفسه كدين هو في لُبه وجوهره الفلسفي يؤكد على أن العالم يدور في قانون السبب والمسبب وبالتالي يعيدنا الدين نفسه إلى المادة كطينة يستطيع الإنسان من خلالها إظهار إبداعاته، بالتالي نجد أن النازية حكمت ألمانيا ولكن مقابلها تجسدت مجموعة ديمقراطيات كبريطانيا وأمريكا وفرنسا والدول الاسكندنافية، إذن فلماذا هذه الانتقائية والتركيز على نظام دكتاتوري إجرامي وصل إلى السلطة بفعل ظروف غير طبيعية وشاذة عاشتها هذه المنطقة من العالم، إنه الحب والكره طبعًا هو الذي يتحكم بأحكام المسيري المنطقية، وأحيانًا ما نبدو منطقيين ولكن في الحقيقة نحن نبرر عواطفنا.
يقول المسيري:
"وعملية التفكيك هذه هي جوهر ما يُسمى "الاستنارة المظلمة" أي رؤية الإنسان باعتباره كائنًا طبيعيًا تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة داخله، أو القوانين الآلية الموجودية خارجه ولا يمكنه تجاوزها، وقد تحدث "هوبز" عن أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، وتحدث "داروين" عن علاقة القرد بالإنسان، وأجرى "بافلوف" تجاربه على "الكلاب" وافترض أن النتائج التي توصل إليها تنطبق على الإنسان، ويُلاحظ أن الحضارة الغربية الحديثة يوجد فيها عدد كبير من الأفعال تبدأ بمقطع de أو dis وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضي، تعبر عن جوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي" - المصدر السابق ص 56.
إن هوبز حينما يصف الإنسان بالذئب فهو لا يُعَبِّر عما يجب أن يكون عليه الواقع، وفرق كبير بين أن نطرح موضوعًا نصف فيه الواقع كما هو وموضوع آخر يهدف إلى وصف (ما يجب أن يكون عليه الواقع)، والمسيري حيث يريدنا أن ننظر إلى "ما يجب" أن يكون عليه المجتمع والفرد الإنساني، يطرح علينا كلام باحث يصف الواقع "كما هو"، وبالتأكيد فإن مقولة هوبز صحيحة، فطوال التاريخ كان الإنسان هو الذي يقتل أخاه الإنسان، وقصة ابني آدم تؤمن بها الأديان الثلاثة، حيث نجد إنسانًا يقتل إنسانًا آخر ومن خلالهما تبدأ سلسلة القتل البشري، كما أن الناس ومنذ بدء الخليقة وإلى الآن يبحثون عن مبررات لأفعالهم، وهي الصفة التي تحكم غالبية المجتمعات "التزاحمية".
إن تفكيك الواقع هو الذي يمثل السبب الرئيسي والأساسي الذي جعل تلك الحضارة الغربية تنطلق نحو النجاح رغم إخفاقات رافقت هذه العملية، كما أن التعددية في الغرب هي تعددية في الصميم قائمة على أن الحقيقة هي أمر نسبي وبالتالي يملك كل طرف حق ادعاء امتلاك الحقيقة، وما دام لا يلجأ إلى القوة لفرض وجهات نظره لأن استخدام القوة هنا يعني التخلي المسبق عن وسائل الإقناع وتطوير الفكرة عبر النقاش، ومحاولات المسيري باتجاه نقد العلمانية لم يهدف إلى بلورة تطبيق أرقى للفكرة بقدر ما استهدف الطعن وإيجاد "مثالب" الحرية على طريقة "مثالب العرب" أو "مثالب العجم" حينما كان الأقدمون لا يستخدمون إلا النقد السلبي الذي كان يهدف إلى إيصال المنطق إلى نتيجة مسبقة، فكان البحث يهدف إلى استنتاج مسبق يوصل المفكر إلى أن المذهب أو الدين الفلاني (زندقة وباطل وكذب).
إن مشكلة العقل الشرقي أساسًا تكمن في أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما يفهمه هذا العقل عن "العلم" وعن وظيفة العلم الحقيقية، فالشرقي ـ المسيري هنا خير نموذج ـ يريد من العلم وبكافة جوانبه أن لا يصف الواقع كما هو، بل يضيف إليه الجمال الخيالي الذي لا علاقة له بالواقع، فلو أراد عالم طبيعي أن يصف لنا نظام "الآكل والمأكول" في عالم الحيوان، فإن على هذا العالم أن يضيف إلى هذا النظام القبيح ـ لأنه نظام قائم على الغريزة ـ قصيدة حمد وشكر وثناء على روعة هذا النظام، مع أن وصف هذا النظام الطبيعي بالقبح أو الحسن هو شأن فلسفي وديني لا علمي، فهناك ثلاثة أنواع أو مظاهر للحقيقة، الأولى الحقيقة المادية العلمية والتي يسهل على الإنسان الوصول إليها، الثانية هي الحقيقة الدينية التجريدية التي تستطيع أن تتجاوز حتى بدهيات العقل البشري، الثالثة وهي الحقيقة الفلسفية وهي الأرقى كونها تنظم وجهي الحقيقتين ذات المظهرين المتناقضين، والحقيقة هي أن الفلسفة وحدها القادرة على نزع السلبية التي تحكم علاقات الدين بالمادة، ومن هنا نجد إضفاء الصنمية على كل ما هو مادي ومحسوس بالرغم من أن الإنسان يدرك حاجته إلى المأكل والمشرب قبل أن يدرك حاجاته الروحية، بينما يريدنا المسيري أن نقول بالعكس من ذلك حتى وأن تناقض هذا مع هذه الحقيقة البديهية التي لا تحتاج إلى كثير نقاش.
يحاول المسيري أيضًا فرض مصطلح آخر على الساحة الفكرية في عالمنا المسلم الشرقي ألا وهو مصطلح مرجعية وهو يقول عنه: "وهي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في خطاب ما، والركيزة النهائية الثابتة له، التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها، والمبدأ الواحد الذي تردّ إليه كل الأشياء وتنسب إليه، ولا يُردّ هو أو ينسب إليها، وعادة ما نتحدث عن "المرجعية النهائية" باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد، تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء. ويمكننا الحديث عن مرجعيتين: مرجعية نهائية متجاوزة ترتكز إلى نقطة خارج عالم الطبيعة والمادة والحواس الخمس، هي في النظم التوحيدية الإله الواحد المنزه عن الطبيعة والتاريخ، الذي يحركهما ولا يحل فيهما ولا يمكن أن يُرد إليهما، أما في النظم الإنسانية الهيومانية (التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله) فهي الجوهر الإنساني ورؤية الإنسان باعتباره مركز الكون المستقل القادر على تجاوزه." ـ العلمانية تحت المجهر ـ ص 57.
إن النقطة المركزية التي سنناقشها هنا هو أن وضع الإنسان مقابل الله وبهذه الاعتباطية هو تجاوز لكل المنجز العقلي البشري وبشتى انتماءاته البشرية، أو بالأحرى هو صيغة "معقلنة" لتخريفات سيد قطب ومحمد الغزالي السقا والإخوان وتنظيمات القاعدة وغيرها من تلك التي تضع الإنسان والمادة في معسكر وكأنه في مواجهة مع الله والملائكة وسائر جيوش السماوات، ولاحظ معي عزيزي القاريء كيف أنه وضع تعبير "النظم التوحيدية" من غير أن يحاول ولو حتى أن يعرفها لنا، إلى جانب التعبير الآخر "الإله الواحد المنزه عن الطبيعة والتاريخ" ليصبح بمقدوره أن يدخل أو يخرج من إطار هذه التعريفات حسب المزاج، فتصبح كل عقيدة أن تكون "غير توحيدية" و"مشركة" و"تؤله المادة"، بالتالي خرجنا مع المسيري مرة أخرى من الساحة الموضوعية الواقعية لندخل ـ والشيطان في التفاصيل كما يقول المثل ـ إلى ساحة العواطف والحب والبغض، ومرة أخرى خرجنا حتى من البحث الفلسفي عن الله لندخل في تصنيف الله نفسه كواحدة من الممتلكات فالله الإسلامي هو غير الله المسيحي وهو غير الله اليهودي وغير الله الشيعي "الرافضي حسب تعبيرهم".
إن الله أو الإله هو ليس شيئًا ماديًا يمكن أن نتوصل إليه كما نتوصل إلى تعريف للأرض والتربة والهواء وغير ذلك من الأشياء، فتصورنا عن الله يختلف من دين أو مذهب إلى آخر ناهيك عن الأشخاص، فكل فرد من الأفراد قد يمتلك تصوره الخاص عن الله وهذا يذكرني بمقولة رائعة لأحد الفلاسفة حيث يقول: "أنا لـــست ضـــد الله ولكنني ضد تصوركم الخاطيء عن الله". فالمسألة هنا مسألة ما يتصوره الإنسان عن خالقه، فقد يؤمن أحدهم بأن الله محب للحرب والقتال فيُفني حياته وحياة الآخرين في هذه الفكرة، بينما يؤمن آخر أن الله هو محب للسلام والمحبة ويقضي كل حياته ناشرًا السلام بين الناس، فهذان هما "تصوران ـ نموذجان" مختلفان للإيمان بالله، فهل هو نفس الإله وكلاهما يتصور عنه فكرة مختلفة، أم أن الله واحد ولكن الاختلاف في الأوهام التي نتصورها إيمانا بالله؟ إن المسيري يرفض الفكرة المنطقية الواقعية التي تقول بنسبة كل الأفعال الناقصة والشر إلى الإنسان والمادة ويصر على أن نصنع وهمًا أو لنقل بعبارة أخرى إن ننسب كل شيء إلى الله ـ والله هنا محدود بحدود تعريفات المفكر ـ ومرة أخرى نجعل الإنسان يقع ضحية للإنسان تحت شعار الإيمان بالله، ولا يظنن القاريء أننا هنا شططنا عن الموضوع وخرجنا عن الموضوع الذي طرحه المسيري، فالكاتب الذي نحن بصدد نقد أفكاره في نقده للعلمانية يؤمن بأن الله لم يخلق الإنسان كصفحة بيضاء، كما سيأتي، ولكنه إنسان يولد مع فكرة، ولا ندري ما هي هذه الفكرة، فابن البوذي يولد بوذيًا وابن المسلم يولد مسلمًا و..إلى آخر القائمة، والتنوع والتغيير لم يحصل في العقائد والأفكار إلا بفعل الحضارة الحديثة وثورة الاتصالات التي تنشر الفسق والفجور حسب المسيري.
والنقطة الأخرى التي نؤاخذ المسيري عليها هنا هي أن الله حسب تعريفه يحرك هذا العالم وهذا التعريف يُدخلنا مرة أخرى في متاهة أغرقت اللاهوتيين المسلمين لقرون، فمن ذا الذي يحدد لنا أين تبدأ إرادة الله وأفعاله وأين تنتهي وأين هو الإنسان في كل هذه المعادلة والمعمعة؟ بالطبع لا جواب على هذا بل تجاوز سريع لأسئلة قد تكلف أجوبتها شعوبا بأكملها، إن القرآن ككتاب مقدس للمسلمين يصنف كل أفعال أو أغلب أعمال الطبيعة إلى الله وهنا نحن أمام إشكال، فإذا كان الله وضع هذه القوانين المادية كلها فلماذا يضيف القرآن الشر والسوء إلى الفعل الإنساني وبالتالي وقع القانون المادي نفسه تحت طائلة تصنيفين ـ إلهي وإنساني ـ دون أن نمتلك أي مقياس، ولا أحد بالتأكيد يملك هذا المقياس، للتفرقة بين الإلهي والإنساني والطبيعي، وإذا كان الإنسان قادرًا اليوم على تصنيف الأجنة واستنساخ وإبداع الأنواع والتحكم بالأمطار؟ فهل هذا يعني أن الإنسان بالفعل قد أزاح الله عن سلطانه؟ لو نظرنا بسطحية وبمنهج المسيري الانتقائي، فإن ذلك سيكون صحيحًا، وإلا فإن الفلسفة تظهر لنا أن الطبيعة هي هبة الله للإنسان وعليه التوصل إلى قوانينها بعقله، وإلا فإن قوانين الطبيعة نفسها كفيلة بالقضاء عليه، فعليه أن يبني السدود ليتفادى الغرق ولا ينسب الفيضان الكارثي إلى الله وأن يزرع الأشجار ليتفادى التصحر ويأكل الغذاء الصحي وهكذا نجد أن الرمز الديني للعطاء الإلهي ليست صيغة حرفية جامدة، وإذا كان الإنسان حائرًا في تعريف نفسه طوال آلاف السنوات فكيف به يجد تعريفا لخالقه؟ إن الخلط بين حاجات الإنسان ـ والإنسان وكل متعلقاته نسبية ـ وبين الإلهي المطلق هو الذي جعل الشرق غارقا في غياهب التخلف والظلمة، فعلى الإنسان قبل كل شيء إيجاد صيغة واقعية للعيش فقد اكتشف كل دين أنه لم يعد يعيش معزولاً كما كان الحال في القرون الماضية وبالتالي عليه إيجاد صيغة تعايش.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :