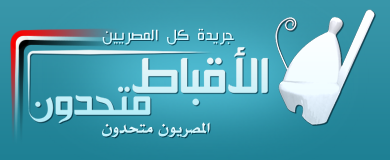الطائفية في العهد الملكي
بقلم:د.عبد الخالق حسين
مقدمة حول تأسيس الدولة العراقية
في مقال لي نشر على مواقع الانترنت في شهر آب 2010، بعنوان (الحل لأزمة تشكيل الحكومة) ذكرت فيه أن الدولة العراقية الحديثة تأسست عام 1921 كنتيجة مباشرة لثورة العشرين، على يد بريطانيا المحتلة، وبمساهمة نخبة من عراقيين، مدنيين وعسكريين، معظمهم من خريجي المدرسة العسكرية في الدولة العثمانية. وقد استوردت بريطانيا للعراق ملِكاً عربياً من الحجاز - هو الأمير فيصل بن الحسين- ورضي به العراقيون وخاصة قادة ثورة العشرين بعد استفتاء صوري.
وقد أثار هذا الكلام حفيظة أحد أنصار العهد الملكي، فرد بمقال غاضب ومطوَّل، أعقبها بمقال مسهب آخر أشد غضباً، أدعى فيهما أن تنصيب فيصل كان مشروعاً، ووفق اختيار الشعب العراقي الحر، وأن استخدام كلمة "استيراد" مغالطة ومهينة بحق الملك، الأمر الذي شجع ثلاثة باحثين أكاديميين أن ينشروا بحوثهم هو الموضوع ذاته، أقتبس ما توصلوا إليه من استنتاج بعد قليل.
فبعد ثورة العشرين، تأكدت بريطانيا استحالة حكم العراق مباشرة، لذا قررت تأسيس الدولة العراقية ومنح السلطة لمن آزرها. فعقد مؤتمر القاهرة في 11 آذار 1921 الذي تقرر فيه مصير العراق ومن يحكمه، وحضره تشرتشل الذي انتقل من وزارة الحرب إلى وزارة المستعمرات، فأصبح بذلك مسؤولاً عن حل مشاكل الشرق الأوسط. كما استصحب تشرتشل معه لورنس (المعروف بلورنس العرب). وحضره من العراق السير برسي كوكس، والجنرال هالدين، والمس بيل وجعفر العسكري، وساسون حسقيل، وثلاثة من المستشارين البريطانيين هم: سليتر، وايدي، وأتكنسن. وتم الاتفاق في المؤتمر على نفس الرأي الذي كان قد تقرر في لندن من قبل وهو أن فيصل هو الشخص الملائم لعرش العراق.(1)
وعلى أثر السجال المشار إليه أعلاه، نشر الباحث الدكتور عقيل الناصري، بحثاً من ست حلقات على موقع الحوار المتمدن، استنتج أن "تنصيب فيصل كان (استيراد) بكل معنى الكلمة". وأضاف: "نعم لم يكن (استيراده بضاعة متهرئة)، ربما كانت جيدة إلى حدٍ ما، ولكن تبقى صيرورة تنصيبه بمثابة فعل استيراد وتعيين بالإجبار وليس انتخاب."(2)
ثم تلاه الأكاديمي الدكتور عصمت موجد الشعلان ببحث آخر عنوانه: (شرعية ومعارضة تنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق) وعلى نفس الموقع، استنتج قائلاً: "قناعتي الشخصية المبنية على المعلومات الواردة في المراجع – ذكرها في نهاية البحث- بأن تنصيب الأمير فيصل ملكاً على العراق غير شرعي، وما بني على باطل فهو باطل."(3)
وأعقبه الباحث الأكاديمي الأستاذ الدكتور كاظم حبيب، ببحث حول نفس الموضوع جاء فيه: "كانت رغبة بريطانيا بعد إعلان احتلال العراق في نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية أن يبقى العراق تحت الهيمنة والسيادة البريطانية وأن يقاد من قبل حاكم بريطاني، كما كان عليه الحال في الهند. ولكن ثورة العشرين (حزيران/يونيو 1920) قد أقنعت الحكومة البريطانية باستحالة ذلك وأن عليهم احترام إرادة الشعب وإقامة الدولة العراقية. وحين تقرر إقامة الدولة العراقية، طرحت أسماء الكثير من المرشحين من بغداد والبصرة على نحو خاص ليكون أحدهم ملكاً على العراق. إلا إن إرادة بريطانيا كانت غير ذلك، إذ أن مؤتمر القاهرة الذي عقد في العام 1921 قد قرر أن يكون الأمير فيصل بن الحسين، الذي كان قد أطيح به في سوريا وأبعد عنها، أن يكون ملكاً على العراق بدلاً من سوريا. وكانت هذه إرادة مس گيرترود بيل، ورضخ السير برسي كوكس لإرادتها... فخيار الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق كان بالأساس خياراً وقراراً بريطانياً".(4)
وقد حاولت بريطانيا إضفاء صبغة الشرعية على تنصيب فيصل، فأجرت ما سمي بالاستفتاء، وسجلوا له مضابط، ولكن وفق رأي معظم المؤرخين، كان الاستفتاء صورياً، وبهذا الخصوص كتب الدكتور علي الوردي حول مصداقية مضابط الاستفتاء على فيصل ما يلي: تروى في هذا الصدد طريفة لها دلالاتها، هي أن مدير ناحية طاووق من لواء كركوك كان قد تلقى أمراً بتنظيم مضبطة لبيعة فيصل ولكنه سمع بعد قليل أن الإنكليز عدلوا عن ترشيح فيصل، فاحتار المدير في أمره، ولم تكن وسائل المخابرات البرقية والتلفون يومئذ ميسورة، فلجأ إلى تنظيم مضبطتين إحداهما بقبول فيصل، والثانية برفضه. وقد وقع الأهالي على المضبطتين معاً، وذهب بهما المدير إلى مستشار اللواء الكابتن ملر. وحين سأله المستشار، "أين المضبطة؟" أجابه: "أيهما تريد؟" وعرض عليه المضبطتين، فأخذهما المستشار كلتيهما".(5)
ويعلق الوردي على هذه الطريفة قائلاً: الواقع أن هذه القصة ليست غريبة في عرف تلك الأيام بالنظر إلى ما اعتاد عليه الوجهاء والرؤساء في العراق من فعل أي شيء يريده الحكام منهم. ومن الطريف أن ننقل هنا ما ذكره غريفز (مؤرخ بريطاني) عن جماعة من شيوخ العمارة أنهم حين سألهم كوكس عقب مؤتمر القاهرة عن نوع الحكم الذي يطلبونه أجابوا قائلين: " الله والينا، ومحمد نبينا، وكوكس حاكمنا".(6)
على كل حال، ومهما قيل عن تنصيب فيصل ملكاً على العراق، أني أتفق مع ما استنتجه الكتاب الأفاضل فيما توصلوا إليه من نتائج، كما وأتفق مع الدكتور عقيل الناصري في قله: أن "تنصيب فيصل كان (استيراد) بكل معنى الكلمة، إلا إنه لم يكن (استيراده بضاعة متهرئة)، ربما كانت جيدة إلى حدٍ ما، ولكن تبقى صيرورة تنصيبه بمثابة فعل استيراد وتعيين بالإجبار وليس انتخاب." وإنصافاً للحق أضيف: أن اختيار فيصل كان موفقاً إذ أثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، خاصة وقد أخلص في خدمة العراق وشعبه. فالطريقة التي تم فيها اختياره كانت مقبولة بعرف ذلك الزمن، بغض النظر عن عدم شرعيته وفق مفاهيم زماننا الحاضر.
إذ أين الخطأ؟
الخطأ الرئيسي الذي ساهم في عدم استقرار الدولة الحديثة هو استمرار الحكام الجدد الذين كان معظمهم من خريجي المدرسة العثمانية، حيث واصلوا نهج الحكم العثماني في العزل الطائفي، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار النظام الملكي وبالتالي إلى انهياره في 14 تموز/يوليو 1958. وقد حذر المخلصون من أمثال الزعيم الوطني جعفر أبو التمن والوزير عبدالكريم الأزري وغيرهما، من مغبة هذه السياسية ولكن دون جدوى.
وكما ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب، أن العديد من المثقفين ينكرون وجود الطائفية في العهد الملكي، وقد فندنا ذلك بالأحداث التاريخية التي مر بها العراق، وبمذكرة الملك فيصل الأول التي اعترف بها بوجود الطائفية، وعزل الشيعة والكرد، وتأكيد شهادة خليل كنه وغيره على ذلك... الخ. كما وهناك كتاب آخرون، يعترفون بوجود التمييز الطائفي في جميع العهود، إلا إنهم يطالبوننا بالسكوت عنه لأنهم، وكما يعتقدون، أن التطرق إلى مشكلة الطائفية يعرض الوحدة الوطنية إلى الخطر، الأمر الذي نختلف فيه. وفي هذا الفصل نذكر أدلة إضافية تؤكد ممارسة التمييز الطائفي ضد الشيعة في العهد الملكي.
خرافة الأغلبية الشيعية الجاهلة
لتبرير حرمان الشيعة من حقوق المواطنة على قدم المساواة مع إخوانهم العرب السنة وبقية المكونات خلال العهد الملكي، بذلت النخبة الحاكمة الكثير من الجهد لإقناع الناس أن سبب عدم مشاركة الشيعة في المناصب الحكومية والإدارية هو عدم وجود مثقفين بينهم. وأشاعت فكرة (الأغلبية الشيعية الجاهلة)، إذ جاء في مذكرة الملك فيصل الأول المار ذكرها، الفقرة التالية: "العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على أنقاض الحكم العثماني وهذه الحكومة تحكم قسماً كردياً أكثريته جاهلة، وأكثرية شيعية جاهلة تنتسب عنصرياً إلى نفس الحكومة".(7)
والمؤسف أنه بسبب ممارسة الطائفية في العراق عبر قرون طويلة، صارت الطائفية والعزل الطائفي ضد الشيعة مسألة طبيعية وقاعدة عامة لا يحق لأحد الاعتراض عليها، إلى حد أنه حتى
الراحل كامل الجادرجي، (زعيم الحزب الوطني الديمقراطي) وهو الديمقراطي الليبرالي، كان يعتبر أي اعتراض ضد هذا التمييز الطائفي خطأ، إذ برر عدم قبول الشيعة في الوظائف إلى جهلهم قائلاً: " إن الإنكليز لم يجدوا عند احتلالهم العراق بين الشيعة من المتعلمين من يصلح لإدارة الشؤون المحلية وتمشية الإدارة ومعاونة الحكام السياسيين".(8)
في الحقيقة لم يكن الجهل هو السبب في عدم توظيف الشيعة أو قبولهم في الكليات في العهد الملكي، إذ رفضت الكلية العسكرية قبول أي طالب شيعي فيها من خريجي المدارس الثانوية، كذلك الكليات الأخرى كالطب وغيرها لم تقبل إلا القليل جداً منهم. ولم يتم قبول الطلبة الشيعة في كلية الحقوق إلا 12 منهم وتحت ضغوط أهاليهم. فلو تأملنا وضع الشيعة في العهدين العثماني والملكي، لعرفنا أن تهمة الأغلبية الجاهلة الموجهة ضد الشيعة غير صحيحة لأسباب تاريخية معروفة سنأتي على ذكرها لاحقاً. ويشهد بذلك ناجي شوكت (رئيس وزراء في العهد الملكي) في جوابه على مذكرة الملك تلك فيقول: " وأخال أن ما تقوله الأكثرية الجاهلة من الشيعة حول عدم مشاركتها في الحكم هو غير صحيح"(9)
ففي الوقت الذي كان مجموع طلبة المدارس المتوسطة في العراق لا يتجاوز 360 طالباً عام 1932، كان في المدارس الدينية في النجف الأشرف وحدها أكثر من عشرة آلاف طالب كلهم من الشيعة، يدرسون اللغة العربية وآدابها والفقه الإسلامي، والتفسير، والتاريخ، والاقتصاد والفلسفة، والرياضيات وغيرها. كذلك كانت هناك مدارس دينية في كربلاء، والكاظمية، وسامراء. وهذا عدد كاف لتفنيد بدعة "الأغلبية الشيعية الجاهلة"!.
وفي البرلمان في دورته الثالثة، كانت نسبة النواب الشيعة واطئة لا تمثل نسبتهم السكانية. مثلاً في بغداد تسعة نواب مسلمين جميعهم من السنة، وإثنان من اليهود، ونائب مسيحي دون وجود أي مسلم شيعي.(10)
وقد حصل تغيير طفيف في الدورة الحادية عشر للبرلمان عام 1947، فقد سمح أن ترتفع نسبة النواب الشيعة للمجلس إلى 40%، بعد أن كانت تتراوح بين 27% و35%، ومثل بغداد سبعة نواب شيعة من أصل عشرين نائباً مسلماً. وأصبح عدد نواب الشيعة في البصرة مساوياً لعدد نواب السنة علماً بأن نسبة السكان الشيعة كانت 90%، بينما بقيت المناطق الأخرى كما هي.
وأثار هذا التطور استياء الأستاذ كامل الجادرجي، زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، فخصص المرحوم عبدالكريم الأزري له فصلاً كاملاً في كتابه الموسوم بـ(مشكلة الحكم في العراق)، فقال أن الانطباع الذي حصل لديه مدة اختلاطه بالجادرجي أنه رجل متحرر من العقد والرواسب والخلفيات الطائفية... ولكن أصيب بدهشة بالغة، بل وخيبة أمل عندما قرأ المذكرة "السرية للغاية" في كتاب مذكرات كامل الجادرجي، فيما يخص ما اعتبره عملاً مقصوداً لترضية الشيعة بأن جيء بصالح جبر الشيعي لرئاسة الوزراء وبأن صار المجلس النيابي يضم 40% من الشيعة (الذين تبلغ نسبتهم أكثر من 50% من العراقيين في وقتها!) قائلاً: "فتزول هذه الترضيات المصطنعة التي منحت في هذا العهد لطائفة معينة من طوائفهم، وأن الخطة الشاذة من شأنها أن تحدث، بطبيعة الحال، رد فعل لدى الطوائف الأخرى، مما يزيد الشعب استياءً ويزيد الوضع إرتباكاً، فضلاً عن أن هذه الترضيات لا يمكن أن تشمل جميع المثقفين من أفراد الطائفة موضوعة البحث"(11)
ومع الأسف الشديد بقي المرحوم الجادرجي على موقفه هذا من الطائفية حتى أواخر حياته. ففي 28 تشرين الثاني 1965- أيام حكم عبد السلام محمد عارف- رفع المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي مذكرة إلى رئيس الوزراء، تعرض فيها لغياب المؤسسات الدستورية وانتقد أسلوب تمذهب الدولة وسياسة التمييز بين العراقيين، وطالب بالحل الديمقراطي وبالحكم الذاتي للأكراد. وعرض المذكرة على الجادرجي الذي رفضها معتقداً بعدم وجود مثل هذه المشكلة، وكان يعتقد أن الطائفية هي محاولات الشيعة للوصول إلى احتلال مواقع لهم في أجهزة الدولة. فمطالبة الشيعة بالمساواة وحصولهم على الوظائف في الدولة أسوة بغيرهم كان عملاً طائفياً في رأي الجادرجي.(12)
أما تهمة الأمية وعدم وجود مثقفين في الوسط الشيعي لمشاركتهم في الوزارة فهي الأخرى لم تصمد أمام أي بحث منصف، لأن الذين احتلوا المقاعد الوزارية من السنّة لم يكن جميعهم يعرفون القراءة والكتابة. وحتى أولئك الذين يعرفون القراءة والكتابة، كانت ثقافتهم باللغة التركية، وكانوا عاجزين عن كتابة التقارير الحكومية باللغة العربية، وفي هذه الحالات، كان الوزراء يلجؤون إلى الوزير الشيعي الوحيد بينهم أو موظف من خريج مدارس النجف لكتابة تلك التقارير. إذن، فتهمة الأغلبية الشيعية الجاهلة باطلة من الأساس.
ومن المفيد هنا أن نذكر جدولاً نشره الراحل ناجي شوكت في مذكراته، بيَّن فيه نسبة الوزراء الأميين وأشباههم حتى نهاية عهد الملك فيصل الأول:
المجلس الذي تم انتخابه أيام الوزارة الوزراء الأميون وأشباههم %
وزارة نوري السعيد عام 1930 73%
وزارة يسين الهاشمي عام 1935 60%
وزارة ناجي شوكت عام 1932 50%
التمييز الطائفي في المناصب الحكومية
ففي عام 1921 على سبيل المثال، لم يكن شيعي واحد على قائمة المرشحين لخمسة مناصب متصرفي الألوية، وكان هناك شيعي واحد فقط بين تسعة مرشحين لمدراء الأقضية. وعلى امتداد عقد العشرينات لم يكن لدى الشيعة إلا نصيب صغير من المناصب الحكومية العامة. وفي عام 1930 قُدِر انه في الوقت الذي كان للأكراد الذين يشكلون 17 بالمئة من السكان، يشغلون 22% من المناصب الحكومية العليا فإن الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان كانوا يحتلون 15% فقط من هذه المناصب.
أدناه جدول يبيِّن نسبة الوزراء الشيعة في ذلك العهد الذين يشكلون نحو 60% من السكان، و80% من العرب، كان نصيبهم في الحكومة دون استحقاقهم العددي بكثير كما هو واضح في الجدول التالي:
المناصب الوزارية الشيعية في العهد الملكي (1921 – 1958) باستثناء منصب رئاسة الوزراء*
الوزراء السنة مجموع عدد المناصب مجموع عدد مناصب الشيعة النسبة المئوية
1921 – 1932 (مرحلة الانتداب)
1932-1936
1931 – 1941 (مرحلة الانقلابات العسكرية)
1941 – 1946(مرحلة الاحتلال البريطاني الثاني)
1947 - 1958 113
57
65
89
251 20
9
18
25
87 17,7
15,8
27,7
28,1
34,7 (أ)
المجموع 575 159 27,7
النسبة المئوية المقدرة للشيعة العرب من أصل مجموع السكان عام 1947: 51,4
* نقلاً عن كتاب حنا بطاطو، العراق، تاريخ الطبقات الاجتماعية...، ص69ـ ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، ط1، بيروت، 1990.
وإذا كانت حجة عدم وجود مثقفين شيعة لإشغال مناصب في الدولة في العشرينات والثلاثينات، فما هي الحجة في عهد الحكومات القومية التي حكمت العراق منذ شباط 1963 ولحد سقوط حكم البعث عام 2003؟ فكم شيعي احتل منصب رئيس أركان الجيش، أو وزير داخلية، أو قائد فرقة عسكرية، أو عميد كلية، ورئيس جامعة، ومحافظ وغيره من المناصب؟
فبين أعوام 1921 إلى عام 1947 تعاقبت عشرون حكومة عراقية، خلت من أي رئيس وزراء شيعي، ولم يتسلم خلال العهد الملكي أو الجمهوري أي شيعي رئاسة أركان القوات المسلحة العراقية.(13)
وطيلة العهد الملكي منذ عام 1921-1958 تشكلت 59 وزارة، ترأس الشيعة 4 وزارات فقط، والسنة 55 وزارة. استمر العهد الملكي 38 عاما، وبذلك كانت حصة الشيعة سنتين وثلاثة اشهر فقط. كذلك الأمر في تعيين الإداريين في الألوية (المحافظات) والأقضية ومدراء النواحي، كان نادراً ما يتم تعيين مسؤول شيعي في مناطقهم.
ورغم أن القانون الأساسي (الدستور) لعام 1925 قد نص في مادته السادسة: على أن "لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة"، كما منع القانون الترويج للتفرقة الطائفية والعنصرية، إلا إن النخبة الحاكمة كانت تمارس التمييز بشكل شبه مقنن، وإذا ما اعترض المواطن على هضم حقوقه بسبب التمييز الطائفي والعرقي، أشهروا في وجهه سيف تهمة الترويج للطائفية والعنصرية، وبذلك تحول الدستور نفسه إلى أداة لممارسة التمييز الطائفي وضد معالجته، وقمع كل من يتظلم من شروره.
وفي هذا الصدد ينقل لنا الراحل عبدالكريم الأزري، شهادة مؤثرة، فيقول في مقدمة كتابه الموسوم (مشكلة الحكم في العراق): "لقد حاولتُ جاهداً في هذا الكتاب، أن أصارح القراء الكرام بما يجول في خاطري وما اعتقده في قرارة نفسي ووجداني، وما توصلت إليه من دراستي وتتبعاتي أن العلة الأساسية التي يعاني منها المجتمع العراقي والدولة العراقية، هي علة الفرقة الطائفية التي أعتبرها علة العلل وأم الكبائر. هذه العلة التي فرقت وحدة المجتمع العراقي بين عربه وأكراده وفتت وحدة الأكثرية العربية في العراق، ودمرت الدولة العراقية، وكانت السبب الرئيسي في تعثر التجربة الديمقراطية الليبرالية التي جاء بها القانون الأساسي العراقي (الدستور) لسنة 1925، ومن ثم في إلغائها على أيدي الضباط الذين فجروا ثورة 14 تموز 1958، وما تلاها من دكتاتوريات، كانت كل واحدة منها أسوأ من التي سبقتها، وكانت آخرها هذه الديكتاتورية الفردية الغاشمة الباغية المجنونة الجاثمة الآن على صدر العراق (يقصد الدكتاتورية البعثية)، والتي اقترفت من الجرائم والمآثم والمظالم والمنكرات بحق الشعب العراقي بصورة عامة، وبحق الأكثرية الشيعية العربية والأقلية الكردية بصورة خاصة ما يعجز القلم عن وصفه".(14)
وفي رسالة وجهها علي محمود الشيخ علي المحامي، وعضو محكمة التمييز، ووزير المالية بعدها إلى صديقه ناجي شوكت (رئيس الوزراء فيما بعد) والتي لم يدر بخلده أنها ستنشر يوماً ما، جاء فيها: "ولكن الوزارة لأسباب لا نعرفها قد أخذت بالسياسة الشيعية إلى حد بعيد، فهي تخلي المناصب الكبرى من رجالها لتستبدلهم برجال من الشيعة ليسوا في العير ولا في النفير.." (عبدالكريم الأزري، مشكلة الحكم في العراق، ص 299).
ردود أفعال على مذكرة الملك(15)
وبالعودة إلى مذكرة الملك فيصل الأول في محاولة منه لإنصاف الشيعة ودمجهم في مؤسسات الدولة، كانت ردود أفعال النخبة الحاكمة على تلك المذكرة سلبية للغاية، حيث جاء في كتاب توفيق السويدي بعنوان: (وجوه عراقية عبر التاريخ) في الرد على مذكرة الملك فيصل الأول، ما يلي:
" ومن أسباب ضعفه (أي ضعف الملك فيصل الأول) اعتقاده بصحة بعض الأقوال بأن الجعفريين مغموطو الحقوق، وإذا فرض أن هذا الغمط موجود، فإنه لم يوفق لمعالجته بالطريق المعقول، إذ كان يريد الطفرة ليدخل العناصر الجعفرية (أي الشيعة) في الحكم بدون اشتراط كفاءة وتحقيق مقدرة، باعتبار أن هؤلاء قد فاتهم السهم في الماضي فوجب الاستعجال بشأنهم للتعويض. وقد كان عمله هذا مناقضاً لمبادئه التي بشر بها في احترام القانون والمعاملة بالعدل المتكافئ ما بين الرعية. وقد أقدم بالفعل على تنفيذ نظريته هذه فلم تزد من شأنه، بل زادت في النقمة عليه" ويضيف السويدي: ".. وأعتقد لا بد من حساب الأغلبية، ولكنه تسرع في إعداد العناصر اللازمة لتطبيق هذه السياسة، فأخذ يأتي بشباب من المقاهي والحوانيت، وهم متعلمون تعليماً بسيطاً لإدخالهم في خدمة الدولة".(16)
ويعلق الراحل عبدالكريم الأزري على رد السويدي قائلاً: "كان جواب توفيق السويدي على مذكرة الملك فيصل سلبياً خاصة فيما يخص الاعتبار لشهادة المدرسة الجعفرية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية لإثنين وعشرين طالباً فقط من خريجي المدرسة الجعفرية في العهد العثماني، بغية إفساح المجال لهم للدخول في كلية الحقوق، وقد انخرطوا فيها وتخرجوا منها، ومنهم صالح جبر، وسعد صالح، وجعفر حمندي، ومحمد حسن كبة، وأحمد زكي الخياط، وصادق البصام، وعبدالرزاق الأزري، وعباس مهدي، ومحمد الشماع، وغيرهم. هؤلاء هم الذين سمّاهم توفيق السويدي عديمي الكفاءة والذين جيء بهم من المقاهي والحوانيت، على حد قوله".(17)
كما ونعرف من مذكرات رجال العهد الملكي الآخرين، ومن كتب التاريخ، إنه وإلى وقت متأخر من ذلك العهد، كان نواب المناطق الشيعية (المحافظات) في الوسط والجنوب، معظمهم يتم تعيينهم من المناطق العربية السنية وكأن المناطق الشيعية خلت من أشخاص كفوئين لتمثيل سكان مناطقهم. أما بخصوص تعيين السفراء، فيذكر الأستاذ الأزري أنه تم تعيين أربعين سفيراً في الخارج ليس من بينهم شيعي واحد.
وفي حوزتي شهادات من أشخاص أثق بهم عن تفشي التمييز الطائفي ضد الشيعة في العهد الملكي، وبالأخص فيما يتعلق بقبول الطلبة في الكلية العسكرية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، روى لي الصديق الأستاذ عادل حبه (قيادي سابق في الحزب الشيوعي العراقي، وكاتب سياسي)، حادثة حصلت له شخصياً، سمح لي مشكوراً بنشرها، مفادها أنه عندما أنهى مرحلة الدراسة الثانوية، وكان حائزا على معدل عال يؤهله لأفضل الكليات آنذاك، إلا إنه وبناء على توجهات الحزب الشيوعي في النشاط في القوات المسلحة قدم إلى الكلية العسكرية ليكون ضابطاً في الجيش. فقدم لتلك الكلية وقبلته اللجنة الأولى، ثم كان عليه أن يمر في عدة لجان الاختيار والاختبار، فعبرها جميعاً بسلام، إلى أن وصل إلى المقابلة الأخيرة التي يتم فيها القرار النهائي حيث قابله شخص واحد وهو آمر الكلية وعلى إنفراد. وفي هذه المقابلة، وبعد أن اطلع الآمر على أوراقه ومعدلاته والفحوصات الطبية التي تشهد له بسلامته البدنية والعقلية ومعدلاته الدراسية، قال له أنك مقبول وليس هناك ما يمنع قبولك، ولكن لدي سؤال واحد عليك أن تجيب عليه بصدق، فقبولك يعتمد على جوابك على هذا السؤال وهو: هل أنت سني أم شيعي؟ فقال أنا شيعي. فأجابه الآمر بأن طلبه في هذه الحالة مرفوض، ولا يمكن قبوله في الكلية العسكرية. وهكذا كان القرار في رفضه لأنه شيعي. ولا شك أن هناك الكثير من القصص المماثلة التي تعرَّضَ لها الناس بسبب التمييز الطائفي في ذلك العهد.
إن ما أصاب الشيعة من إجحاف في نسبة تمثيلهم في الدولة العراقية في العهد الملكي يشبه تماماً ما أصاب العرب عموماً من إجحاف في تمثيلهم في الدولة العثمانية.
ففي شهر شباط، من عام 1911 وقف شكري العسلي مبعوث دمشق في مجلس المبعوثين
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :