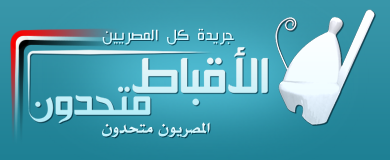خصائص الإنسان الأساسية (1)
بقلم: راندا الحمامصي
عندما نتكلم عن "نفسنا"؛ فإننا نتحدث عن لُبِّ كياننا -أي تلك الحقيقة التي تحدّد مَنْ نكون؟ وماذا نحن عليه؟؟- إن مدى اطّلاعنا وفهمنا لتلك الحقيقة تكون محدودة في بداية حياتنا، وما لم نعقد العزم والنيّة ونحاول فهم نفسنا وتطوّرها بأسلوب منهجي، سنبقى بالطبع على جهل بأهم السجايا والصفات الكامنة فينا وأقْيَمها.
ولما كانت النفس ثمرة تعلُّق الروح بالجسد حالما تبدأ الحياة، فإنها تظهر للوجود في ذلك الحين أيضـًا، من المنطق إذًا أن تكون الحياة والنفس يتوقف كل منهما على الآخر كلّيـًا، فلا "نفس" دون "حياة"، ولا "حياة" بلا "نفس".
القدرات البشرية الرئيسية الثلاث
للنفس البشرية ثلاث قُدُرات رئيسة: "المعرفة، والمحبة، الإرادة"، وهي قدرات روحية في طبيعتها، لأنها تختص بالروح(1)، مع أنها تنمو وتتطوّر وتعبّر عن نفسها في سياق النفس، وفي سبيل إدراكٍ أكبر لكيان "النفس"، من المفيد أن نأخذ تلك القدرات منفصلة كل واحدة على حِدَة. وسأناقش فيما بعد كيف أنها متعلقة ببعضها البعض، وكيف تكون متناسقة متكاملة.
1– المعرفة:
إن إحدى سجايانا نحن البشر قدرتنا على المعرفة في أوسع نطاقها وأشمله، ونقصد بالمعرفة هنا مختلف أنواعها وأشكالها، أجاءت بطريق الوعي أم بدونه، أو كانت بالسليقة، أو تلك التي نكتسبها بظاهرة الإيحاء والتبصُّر، وهي ظاهرة غير مفهومة تمامـًا.
إننا نكتسب المعرفة بفضل تجارب الحياة، والإدراك العقلي، والتفكُّر، والتقييم الذاتي، وبالصلاة والتأمُّل، وبذلك يكون مخزون معرفتنا مكوّنـًا من مصادر متعددة من المنطق والعقلانية والسليقة والخلاّقية والروحانية والإلهيات، فما هو عقلاني ومنطقي، فإن مردّه إلى عالم العلوم الذي يعدّ هامًّا لنا؛ خاصة في فهمنا القوانين التي تحكم عالمنا المادي، إلى جانب أوجه حياتنا الفردية والجماعية من علوم خاصة بالطب والقانون والاقتصاد على سبيل المثال، وأشكال المعرفة التي تأتي بالسليقة والخلاّقية، فإنها مناسبة للتقدّم في الفنون وتهذيب العلاقات الإنسانية وتحسينها، أما المعرفة الإلهية والروحانية بخصائصها وألوانها، فإنها هي التي تضع لنا الهدف والمعنى من حياتنا، وتمنحنا بصيرة نرى فيها الخير والشر.
رغم أن أشكال المعرفة هذه كانت مُتاحة للبشرية منذ فجر الوعي والإدراك، فإن فهمنا لها كان مُبْهَمـًا، غير واضح ولا مترابطٍ ومبعثرَ الأجزاء، ومع ذلك وصلنا الآن لمرحلة جديدة في قدرتنا على اكتساب المعرفة في إطارها العام، ومعرفتنا بذاتنا وأنفسنا بشكل خاص.
لقد كان للتطوّر العلمي المُلفِت للنظر في السنوات المائة والخمسين الماضية، في أهدافه العملية، أن هيمن على باقي أشكال المعرفة الإنسانية، ووضعها في مرتبة ثانوية، أو اعتبرها عديمة الأهمية، ومع ذلك فإن هناك الآن مؤشرات تُنْبِئ بأن هذا الخلل في التوازن آخذ مسارُهُ نحو التصحيح، إذ نجد مثلاً أن هناك الآن جدلاً وآراء طفيفة تدور حول أهمية العلوم الاجتماعية؛ مثل علم النفس "psychology"، وعلم الاجتماع "sociology"، والعلوم الإنسانية "anthropology".
ومع أن هذه العلوم لا تزال في مهدها، إلا أنها ساهمت مساهمة هامة في فهمنا لأنفسنا وحقيقة ذاتنا؛ فحقيقة أن النهج العلمي، ولو بأسلوبه الآلي المحدود، قد استُعين به لأجل فهم أفضل للطبيعة البشرية، إنما يعدّ بحدّ ذاته خطوة هامة وأساسية إلى الأمام.
إن اطّلاع الإنسان ومعرفته في ميادين الأخلاق والسلوكيات والروحانيات متخلّفة، ويا للأسف بشكل خطير؛ فالإنسانية قد فقدت الكثير من إحساسها بالثقة والأمل فيما يتعلق بالأمور الروحانية، فعندما أعلن فلاسفة العصر أن الله قد مات، فإن الوازع الديني في داخل الإنسان هو الذي مات وليس الله، فالله حقـًا قائم ومستمر على علاقته الحبية بالإنسانية جمعاء، ومن الناس مـَن حرموا أنفسهم، ويا للأسف من أشعة هذه المحبة، لأنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون أنهم لا يستحقونه.
ففي العلاج النفسي "psychotherapy"؛ كثيرًا ما نجد أناسـًَا يشعرون بأنهم غير محبوبين، وعندما نبحث في الأسباب نجدهم يشعرون بأنهم ليسوا أهلاً للمحبة، ولذلك لا يفتحون لأنفسهم بابـًا لاستقبال تلك المحبة.
وهذا ما ينطبق حقـًا على علاقة الإنسانية بالله سبحانه وتعالى، فبتنامي التوجُّهات العلمية وتداعي القيم الدينية في القلوب -وهي ظاهرة أخذت تنمو بالتدريج لتبلغ ذروتها في السنوات المائة الماضية- اتّجهت الإنسانية إلى تغيير علاقتها بخالقها؛ ففي السابق كانت عبارة عن علاقة الأب بالإبن في طبيعتها؛ فالأب هو صاحب السلطة والقوة والعالِم المطلق، وهو الذي يُنْزل القصاص في أغلب الأحيان، والطفل هو الضعيف الجاهل المُذعن المستسلم، كان ذلك في عصر الرضاعة والطفولة للبشرية.
إذ كان رد فعل أجدادنا أمام تحدّيات الحياة، التي بدت لهم وكأنها تلك القوة والجبروت، أن كانوا كالأطفال أيضـًا ويمكن أن نسمّي ردّ فعلهم: "رهبة، أمل، خوف، قلق، واضطراب"، وجاء عصر العلم ليحرر الإنسانية من كثير من مخاوفها وتُرّهاتها، ويفتح أمامها باب المرحلة الأخيرة لبلوغ الجنس البشري قاطبة سن الرشد والبلوغ.(2)
بشرية مراهِقة
إن البشرية المزوّدة بقوة مراهقتها الهائلة، باحتفاظها بالخصائص الفريدة لتلك المرحلة، نراها الآن في سلوكها تتخذ منحىً مختلفـًا، أمَا وقد ذاقت طعم النمو العضوي بكل حرية؛ فقد أصبحت أكثر اندفاعـًا وحماسة واعتزازًا بنفسها، ويبدو أنها نفضت عنها غبار الخوف، فالبشرية المراهقة نراها اليوم قد باتت تتفحص وتختبر، وسرعان ما اكتشفت الكثير من قوانين الطبيعة التي لم تعهدها من قبل، وأحسّت بقوةٍ وقدرةٍ لم تكن تتصورها.
وفي خِضمّ ذلك الجوّ الزاخر بالاكتشافات العلمية، والتقنيات المبتكرة المواكِبة لبروز البراعة الفائقة والجرأة الفكرية والمادية لسِنِّ المراهقة، فإن -القلعة الدينية الرئيسة للبشرية في شؤونها الروحانية- قد أُهملت، بل ونُسيت تقريبـًا، ونتيجة لذلك ضعُفت أركان الدين بشكل ملحوظ، وفشلت الأديان السماوية الرئيسة -اليهودية، والمسيحية، والإسلامية، والبوذية، والهندوسية، وغيرها- في إدراك أهمية هذه الحقبة الجديدة من حياة الجنس البشري على أنه وحدة واحدة، وبذلك أصبحت تلك الأديان -عمليـًا- مقطوعة الوصل بالواقع الإنساني، وعديمة التأثير في شؤونه الحياتية.
بهذه الطاقات الجديدة التي برزت، وبزوال الكثير من العوائق والعقبات، أخذت البشرية المراهِقة تشعر بأنها قادرة على كل شيء تقريبـًا، وهذا ما جعل الأمر مُهلِكـًا مميتـًا؛ فبادئ ذي بدء أُخليت القلوب والعقول من ذكر الله وخشيته، وبذلك طفت على السطح تلك الغرائز الحيوانية بكل أشكالها لتسيطر على البشرية بكل قوة ونفوذ، فأُسئ استعمال ثمار التقدم العلمي بتسارع مذهل، وابتُكرت أدوات الدمار الشامل، وفي معمعة الُّلهاث وراء التطور المادي والشراهة الإستهلاكية صُرِعت قوى المحبة والمودّة والرحمة ليأخذ العنف والجبر والإكراه مكان الحب والوئام، وجرف سيل المعلومات أرض الحكمة والتعقّل، وأصبحت الثروة تعني السعادة الحقيقية، وتمزّقت الأرض إلى شذرات بأنياب الأنانية وحب الذات.
ومحَصِّلة ذلك؛ أن أصبحت المعرفة الإنسانية محدودة بحدود المادية، واصطبغت شؤون البشر الصبغة المقيتة وألْبَسوا الروحانية ثوب المادية الخبيث، إنها حالة من الصَّخَب والعبث نجدها أمامنا جلية في عالم مشرذم تجرفه أرياح اليأس، ويئن تحت وطأة الظلم وعدم المساواة وانعدام الثقة، وتعصف به الحروب والصراعات، وتنهشه أنياب الجوع والمرض والإباحية، وتطحنه أضراس الموت من كل جانب، فعالمنا اليوم مصاب بمرض عُضال على شكل وباء أباح لنفسه كل شيء، ذلك هو المادية.
بشرية ناضجة
إن التصدّي لهذا الوضع المحيّر ليس في توجيه اللوم للعلوم ونبذها، بل في إثراء معرفتنا بما نفتقر إليه من الأمور الروحانية والشؤون السماوية، فإذا ما توجّهنا نحو هذا العلاج الشافي وسلكنا هذا الطريق القويم، سنجد أنفسنا بالتدريج نعمل على تغيير مسارنا ومواقفنا التي كانت لنا أيام المراهقة، لنستبدلها بتفكير وإدراك تامّين لطبيعة مرحلة النضج التي ندخلها ككيان جماعي.
ففي هذه المرحلة سنفوز بتوازن خلاّق بين أوجه المعرفة العلمية والفنية والروحانية، وتغدو أهداف حياتنا أكثر توجُّهـًا نحو العالمية بشكل طبيعي، سنترك مدار دَوَراننا المحصور بمحور أنفسنا فقط لنتحرر ونصبح قادرين على تسخير المعرفة الإنسانية في خدمة البشرية عامة دون عوائق وحُجُبات، لنعود بعد ذلك ونؤكِّد على أهداف الحياة النبيلة، أما الوصول إلى النضج فإنه يحتاج منا معرفة كاملة ﺒ"حقيقة أنفسنا".
معرفة النفس
لا شك أن معرفة النفس هي محور المعرفة الإنسانية، وهي في ذروتها وعُمقها ولزومها مساوية لمعرفتنا بالله.(3) ذلك ليس لأننا إله أو جزء منه، بل لأننا خُلقنا على صورة الله ومثاله، فلا يمكننا إذن أن نعرف الله دون أن نعرف أنفسنا، وفي الوقت نفسه لا يمكن معرفة أنفسنا إلا إذا عرفنا الله جل جلاله.([1]) وما البُعد عن أحدهما إلا عين البُعد عن الإثنين معـًا، لقد اعتقد "ماركس" فيما مضى أن عِلل الإنسان الرئيسة كانت في بُعده عن نفسه (ذاته)، وبُعده عن البيئة.(4)
فبينما نجد أن معرفتنا بالبيئة تمنحنا بصيرة بعالم الطبيعة، وعندما نطبّق هذه المعرفة على أنفسنا تمدّنا بمعرفة الناحية الفسيولوجية والبيولوجية والمَرَضية والكيميائة والعضوية لأجسامنا، فإنها في الوقت نفسه لا تُلقي أي ضوء على البُعد الروحاني لوجودنا، وهو الأهم لمعرفة نفسنا.
ذلك لأن إدراك ذلك البُعد يحتّم علينا تواصلاً مع مصدر الروحانية، وبما أننا رفضنا بُعدنا الروحاني أو فهمناه بطريقة ساذجة ومحدودة جدًا، فقد أصبحنا حقاً غرباء عن أنفسنا بعيدين عن ذاتنا.
لا شك أننا نكتسب المعرفة بقوانا العقلية، بإمكاننا أن ندرّب أنفسنا على استعمال عقولنا، وأن نعزّز بكل قوة قدرتنا على التخيُّل، وعلى التفكير وبها نقترب من إدراكنا للحقائق، وكذلك تعزيز قدرتنا على حفظ المعلومات واسترجاعها، وعندما تعمل كل مجهوداتنا وقدراتنا في الحصول على المعرفة بالتناسق والتناغم مع طاقاتنا في المحبة والإرادة، عندها فقط، سيكون الحصاد وفيرًا وعظيمـًا، ويخلق فينا حالة من الوحدة في داخلنا.
2- المحبة:
المحبة هي قوة الجذب الفعّالة نحو الجمال والوحدة والنمو والتطور، إننا معشر البشر دائمـًا ما يجذبنا، عن وعي أو غير وعي، ما نراه ونحسّ به جميلاً، وما يهيّئ أمامنا سبل التقارب، ويعمل على التآلف والصداقة الحميمة والوحدة والاتحاد، وكل ما من شأنه رعاية نموّنا وتطوّرنا، إلا أن رؤيتنا لتلك الأمور ليست دقيقة دائمـًا، إذ كثيرًا ما ننجذب أيضـًا لأفراد أو أوضاع اجتماعية، أو أفكار ليست جميلة، وتسبب لنا الفُرقة والانقسام، أو إعاقة نموّنا وتطورنا؛ لذلك فإن نوع هذه المحبة وخاصّيتها له ارتباط وثيق بمن تشمله محبتنا، ولإيضاح تلك النقاط يمكن للمثال التالي أن يساعدنا.
المحبة والحرب
وكما تخبرنا صفحات التاريخ؛ فإن حروبـًا بمختلف أنواعها قد نشبت بين مجتمعات العالم الإنساني، بعضها كان لازمـًا لمحاربة آفات الشرّ، ولو أنها كانت بحدّ ذاتها شرًا لا بد منه، فالحرب كان يُلجَأ إليها لرفع الظلم والحدّ من أعمال تعتبر أكثر تخريبـًا، وعلى ضوء هذا المفهوم والمنظور اعتُبِرت الحرب واجبـًا اجتماعيـًا، ومن الطبيعي أن يكون هناك دائمـًا مَن اختار الحرب لتحقيق مجد شخصي وإرضاءً للذات، وبذلك جعلوها مرتعـًا لحبّهم، هم يفعلون ذلك لأنهم يروْن في الحرب جزءًا من جمال ذاتهم، وطريقـًا إلى التناغم وتعزيز التقدم والتطوّر.
وعادةً ما كانت هذه المشاعر يُعَبَّر عنها بتمجيد الحرب والتغنّي بها، ووصْف قوة المحارب واتّساق جسمه وجمال لباسه الخاص، والإعجاب بالسلاح والأدوات العسكرية القتّالة، وبالخطط الحربية الناجحة، وكذلك الأمر كان في كثير من الأدب الغابر الذي تغنّى أصحابه بالحرب ومجّدوها، واصفين روعة أحداثها وبطولاتها.
وهناك الكثير من الأقوال المآثورة عن الحرب وقيمتها الثمينة، وكيف أنها حافظت على الثقافات والحضارات وقاربت بين الشعوب، وخلقت مستوى أعلى من التجانس، وصنعت الوحدة الوطنية، كما أن محبّي الحرب يدّعون بأنها سبب في التطور والنموّ، لأنها تربة خصبة لمزيد من العلوم والمعارف، ودافع نحو إنعاش الإقتصاد الراكد، كما أنها تفسح المجال أمام انتصار الخير على الشرّ.
إن الحقيقة الواضحة التي لا يمكن إغفالها، أن الحروب بأشكالها إنما هي بعيدة كل البُعد عن الجمال وعن الوحدة، وعن كل أنواع تعزيز مقوّمات الحياة وإنعاشها، ورغم نشوب حروب كانت ضيّقة ومحدودة وعادلة ضدّ ما يشبه الهتلرية في التاريخ، ومهما كانت ضرورتها، فإنها لم تُظهرْ للإنسانية سوى وجهها القبيح، ولم تجلب معها إلا الانقسام والدمار، وبسبب التمادي في الفهم الخاطئ لطبيعة الحرب، رغم تلك الحقائق الواضحة، هامت الإنسانية حبـًا في الحرب وسلكت هذا الدرب الشائك.
إن الحرب والمحبة عند المفكّر العاقل شيئان متضادّان تمامـًا، مَن ذا الذي يستطيع أن يجادل في أن الحرب بطبيعتها موت ودمار، وأن المحبة حياة وعمار! الحرب عنف وقسوة والمحبة لطف ومودّة، الحرب فُرقة وتباعد والمحبة وحدة وتقارب، في الحرب قُبحٌ وشناعةٌ، وفي المحبة حُسنٌ وجمالن في الحرب ركود وبَوَار، وفي المحبة نمو وازدهار.
فاعلية المحبة
في كل ما عرَّفْنا به المحبة من كلمات، يبقى التعريف التالي في نظري أسطعها وأبهرها: "المحبة هي قوة الجذب الفعّالة"، وقد نتساءل: ما هي فعّالية المحبة؟ ومن أين تأتي قوّتها؟؟
إن فعّاليتها الأساسية تكمن في الخلاّقية والإبداع، فالمحبة صانعة الحياة، وهي التي ترعى النمو والتطوّر وتعزّزه وتخلق الوحدة والإنسجام والوئام، إنها فعّالية مؤثرة نجدها في جميع مناحي الحياة البشرية، فالمحبة هي المحفِّز والدافع على تكوين الأسرة، ورعاية الأطفال، وإطعام الجياع، وخدمة المرضى، وإيواء المشرّدين، وتضميد الجروح، وهي التي تخفف مشاعر الغربة وتمحي نزعة التعصّب، وتؤلّف بين القلوب وتصنع الاتحاد وتخلق المودّة والوئامن تلك هي قوى المحبة وفعّالياتها وكلّها خلاّقة بنّاءة.
يؤمن الكثير من الناس بأن الحب أعمى، ذلك لأنه يحصل دون إرادة، إنها رؤية سليمة إذا حصرنا نظرتنا إلى المحبة في أول بدايتها حينما تحجب قوى الشوق والانجذاب أنوار العقل، وتجعلنا عشّاقـًا نتصرف وكأننا فقدنا عقولنا بنظر أولئك الذين لم تمسَسْهم المحبة، لأنهم وضعوا لها دلالات تتفق ومنطقهم.
ومع كل ذلك تبقى الحقيقة قائمة، في أن المحبة هي الموهبة العظمى المتأصّلة في فطرة كل إنسان، وعلينا أن نرعاها ونعزّز نموّها ونعمل على تطويرها؛ فتعريف المحبة على أنها قوة فعّالة يعني أنها ليست قوة ساكنة جامدة، أو سلبية، ولا هي قوة يصعب توجيهها، فهي التي يجب أن تزخر بالحياة وحيوية الحياة، بل هي نبض الحياة، وهي التي يجب أن توجِّه كل أفعالنا، وتبقى لنا ذلك الضياء الساطع الذي يحمل كل الأهداف النبيلة، وهي بذلك أكثر وأعظم من كونها قوة فعّالة في الجذب والتجاذب، ذلك بأن ما يقرر طبيعتها في النهاية ليس قوتها في الجذب فحسب، بل إبداعها وخلاقيتها في ميدان عملها، ومحطّ فعّاليتها، ونطاق إشعاعها أيضـًا.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :