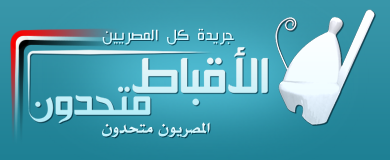- الطبق الجزائري الذي يجب أن تجربه ولو مرة واحدة في حياتك
- تجمعا السلام العالمي والعراق الجديد يدينان حادث كنيسة سيدة النجاة بـ"العراق"
- رسالة من قبطي على تهديد تنظيم القاعدة لأقباط مصر
- عبد الرحيم علي: إيران وراء تلك اللعبة القذرة من التفجيرات بنسبة 99%
- اليوم بالأزبكية: الكنيسة الإنجيلية تفتتح دوري "خليك كسبان"
زيارة "أونكل إيلي" إلى مصر.. التي لم تعد وطنه (1)
بقلم: نبيل شرف الدين
في مقهى الفندق المُطل على قصر "البارون إمبان" بضاحية مصر الجديدة القاهرية، كان مشهدًا مؤثرًا لي إذ أنها المرة الأولى التي ألتقي فيها "أونكل إيلي"، كما أحببت دائمًا أن أخاطب صديقًا من يهود مصر الذين ولدوا فيها لعدة أجيال، وهذا بالمناسبة تاريخ موثَّق، ويبدو من اسمه، إيلي أمين خصر، وشأن آلاف غيره من اليهود المصريين الذين أجبرهم النظام الناصري على ترك وطنهم الأم مصر، ليهاجر بعد هزيمة يونيو 1967، إلى الولايات المتحدة.
عرفت "أونكل إيلي" عبر الإنترنت ـ بارك الله مخترعها وجزاه عن الإنسانية خيرًا ـ وتبادلنا المراسلات طويلاً، وشارك معي في عدة حلقات من برنامج "الحقيقة" الذي يقدمه وائل الإبراشي عبر فضائية "دريم" في مناقشات ساخنة حول يهود مصر، وكان الرجل واضحًا محددًا قاطعًا، بشأن كل الأكاذيب الفارغة التي طالما شوَّهت واحدة من أنبل الطوائف المصرية، هي طائفة اليهود القرائين، وللعلم فهي أقلية داخل المجتمع اليهودي، ولدرجة أن غالبية اليهود الربانيين ما زالوا لا يعترفون بهذه الطائفة تمامًا، بل يعتبرهم المتشددون أو "الحريديم" مجرد "مهرطقين".
سنوات طويلة تمنيت خلالها أن ألتقي "أونكل إيلي"، حدثني فيها كثيرًا عن أسرته الصغيرة، السيدة الفاضلة زوجته، التي بدت لي كأنها قادمة من "زمن الهوانم"، وابنهما الذي يبدو أنه لم يكن متحمسًا لمرافقتهما في هذه الزيارة لمصر، لأنه ـ ببساطة ـ ليس مثلهما مثقلاً بحالة "النوستالوجيا" أو "الحنين المفرط"، لأحياء العباسية والظاهر والسكاكيني وغيرها من الأحياء القاهرية التي اعتاد يهود مصر الإقامة فيها.
رحلة دون رجعة
لم ندع الوقت يسرقنا في الفندق، رغم أن "الكيمياء الإنسانية" كانت رائعة بيننا، ومن جهتي فقد شعرت حينها أن "أونكل إيلي" ليس كائنًا فضائيًّا (يوفو)، بل هو مصري للنخاع، تتجلَّى مظاهر ذلك من خلال أصغر تصرُّفاته.. من عباراته، وروحه الساخرة من كل شيء، حتى من نفسه أحيانًا، لهذا كان العاملون في الفندق الذين يعرفونني بحكم تردُّدي المستمر عليه، كانوا يتعاملون معه كأنه "عوني"، أو "عزت"، أو "أيمن"، ونحن في طريقنا للمغادرة كانوا يتصرَّفون معه ببشاشة المصريين المعروفة.
ساعتها طاف في مخيلتي سؤال: ماذا لو عرف هؤلاء "المبتسمون ببشاشة" أن هذا الرجل اسمه "إيلي" وأنه يهودي، وتعرَّض مع أسرته لأبشع أنواع القمع، وهو أن تُطرد من وطنك، أو تجد نفسك غير مرغوب ببقائك، سواء من السلطة أو المجتمع، مما يضطرُّك إلى الهجرة من بلد عشْت، وقبلك عشرة أجيال على الأقل من جدودك كلهم ولدوا على ثراه، ومثلهم تربيت على "العيش البلدي"، الذي تخبزه "الطابونة"، وتعلَّمت في مدارسه ثم تلتحق بإحدى جامعاته، وذقت طعم الرعشة الأولى للحبّ وكانت شمسه وقمره ونهره "شهود إثبات" على أنك جزء من أصل هذا المجتمع، لا تعرف لك خيارًا بديلاً عنه.
بعد كل هذا وأكثر، تجد نفسك وكل أسرتك في السجن، دون تهمة، فقط لأنك "يهودي"، ثم تُجبر على الرحيل إلى المجهول بعد أن يُدمغ جواز سفرك بعبارة "رحلة دون رجعة"، التي تشبه الإعدام المعنوي لأي إنسان يُحرم من وطنه على هذا النحو!
أيّ ظلم هذا، وأيّ ضمير ميّت يقبل ذلك لمجرد أن الأقدار وحدها شاءت ـ لسبب لا يعرفه سوى الله تعالى ـ أن يولد "أونكل إيلي" لأسرة يهودية قرائية، وأن أولد أنا لأسرة "مسلمة سنّية"، وأن يولد صديقي "عوني رمزي" لأسرة مسيحية قبطية، أي فضل أو ذنب لنا في أمر لم يستشرنا فيه أحد، بل هكذا شاءت إرادة عليا، وعلينا أن نتقبَّل بعضنا بعضًا، ونتعايش معًا في سلام ومودّة.
ما إن ركبنا سيارتي، وبالمناسبة كانت تحت تصرُّف "أونكل إيلي" سيارة فاخرة يقودها سائق محترف، خصَّصها له مضيفوه من رفاق صباه وشبابه وهم رجال صاروا من ذوي الشأن في مصر، مع ذلك لا أدري لماذا كنت مُصرًّا على اصطحاب إيلي وزوجته في سيارتي، ربما لأنني كنت راغبًا في ألا تدع لحظة تفوتني في هذا اللقاء المقرَّر له بضع ساعات يعلم الله تعالى وحده ما إذا كان سيتكرَّر مرة أخرى أم لا!
أهل السماح
وحين بدأنا نتحرَّك أدرت جهاز الكاسيت، وكان بداخله ـ مصادفة ـ تسجيل لمطربي المفضل المرحوم محمد قنديل، وبالصدفة أيضًا كان يغني "سماح.. يا اهل السماح"، وفوجئت حينها بالسيدة منى "زوجة إيلي" تعلِّق قائلة: "ياه.. من زمان مسمعتش قنديل.. الراجل دا كان مصري جدًّا، كل حاجة فيه مصرية.. شكله.. صوته.. أغنياته.. حين أراه في فيلم قديم أتذكَّر أيام مصر".
"انتي بتعرفي قنديل؟".. هذا السؤال الساذج جرى على لساني بشكل عفوي، وربما من فرط دهشتي، فهناك أجيال من شباب مصر يقدّرون بالملايين، لا يعرفون "قنديل ولا منديل"، ولا يعنيهم هذا، لأنهم منغمسون في أمور أخرى كالموبايل مثلاً، أو "السبوبّة" أو "الاشتغالة"، أو "المُزّه"، وحتى حين يسمعون غناء فمطربهم المفضل لن يخرج عن نوعية "تمورة"، و"الهضبة".
كعادتها كانت شوارع القاهر أسيرة لفوضى المرور العارمة، ولعل ما هوّن الأمر علينا أن الرجل وزوجته، كانا في حالة تأمل لكافة ما يجري في شوارع "المحروسة" من بشر وسيارات ولافتات وبنايات وأنفاق وجسور، "كأنها ليست مصر، وكأنني لست إيلي"، لم يقل صديقي هذه العبارة، لكنني قرأتها في عينيه، وأكَّدتها تعليقاته التلقائية، بلغة أبناء البلد في منتصف القرن الماضي، فبدا لي حينها كأنه خارج للتو من أحد أفلام "الأبيض والأسود".
كنّا في الطريق لمحاولة تحقيق "أمنية عزيزة"، كما وصفها "أونكل إيلي" في رسالة قبل أن يبدأ رحلته، وهي ببساطة أن يزور الكنيس اليهودي الذي تربى في كنفه وارتبط به وجدانيًّا طيلة صباه وشبابه، حتى هاجر من مصر، وهو يقع في حي "العباسية" شرق القاهرة، ويعرف باسم كنيس "موسى الدرعي" وكان شاعرًا مشهورًا وسُمِّي المعبد باسمه بمبادرة من الحاخام طوبيا الذي كان رئيسًا للطائفة القرائية في مصر حينذاك.
قبل وصوله سعيت ـ قدر المستطاع ـ للحصول على تصريح بدخول الكنيس، لكن هيهات، فالأمر ليس بهذه البساطة، وهناك فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي تدفع المرء للتخلِّي عن اسمه لو احتكم الأمر، هناك سيدة سمعتها ليست فوق مستوى الشبهات تتربَّع الآن على عرش رئاسة الطائفة اليهودية، ومع أنه لم يعد هناك أثر لهذه الطائفة الآن، اللهم إلا بضعة عجائز، غير أن هذه السيدة أصبحت أمام السلطات الرسمية هي الممثلة الرسمية والوحيدة التي تمنح التصاريح لزيارة أي معبد أو أثر يهودي في شتى ربوع مصر، وتردَّد مؤخرًا أنها هاربة من تنفيذ حكم قضائي.
أفكار وصور لا حصر لها تزاحمت في مخيلتي قبل أن نصل إلى المعبد المذكور لرؤيته من الخارج على الأقل، لكن حتى هذا الأمر على تواضعه لم يكن بسيطًا، إذ أنه وبمجرد وقوفنا أمام المعبد انتفض رجال الشرطة المكلفين بحراسته للسؤال عن سبب وجودنا، وما إن شرحت له الأمر ببساطة.. أن هذا الرجل وزوجته لا يريدان سوى رؤية "مكان عزيز" بالنسبة لهما، حتى طلب منا ضرورة التوجُّه لقسم الشرطة للحصول على موافقة رئيس المباحث والمأمور، وبالطبع لم تكن تلك المناقشات السخيفة ذات جدوى، لكنها استغرقت بعض الوقت لإلقاء نظرة عابرة على المعبد، ولم يكن من الحصافة الدخول في متاهات التوجُّه لأقسام الشرطة من أجل "أمنية عزيزة"، فهذه المؤسسات ليست المكان المناسب لتحقيق الأمنيات، سواء كانت عزيزة أو أمينة أو نفيسة، فآثرنا السلامة ومضينا لحال سبيلنا.
ازدواجية المعايير
ما يجري منذ أكثر من نصف قرن، وتتصاعد الآن نغمة فاشية غبية تصنف كل يهودي صهيونيًّا، وكل مسيحي صليبيًّا، ومع ذلك يستنفر ملايين المسلمين طاقاتهم حين يخرج عليهم أحد شذاذ الآفاق من متطرفي الغرب والشرق فيوصم كل المسلمين بالإرهاب، ونعتبر ذلك عنصرية وتعميمًا غير مقبول، مع أننا نمارس نفس الشيء فنمنح أنفسنا حقّ التمييز ضد الآخرين، ومعاداتهم أحيانًا.
في الطريق إلى البيت الذي وُلد وتربى فيه، بالقرب من قصر سكاكيني باشا، سألته عما يشعر به، فأجاب بمرارة: لماذا تصر الأم العاقلة على تخيير أبنائها بينها وبين أبيهم؟ نحن ولدنا يهودًا لكننا أيضًا مصريون، وإنكارنا يعني محو صفحة من تاريخ مصر.
بعدها أمسك "عم إيلي" عن الكلام، وكأني به يقول لنفسه، من دون أن ينطق بأن نصف قرن كانت كافية ليغير الألمان وجهتهم من النازية إلى الحداثة، والإيطاليون يلقون بالفاشية في "مزبلة التاريخ"، ويتجاوز اليابانيون مأساة هيروشيما وناجازاكي ليصبحوا في صدارة الأمم المتقدمة، أما في مصر وشتى دول الشرق الأتعس فالأمر "مختلف"، وأظن أن إعادة ترتيب حروف الكلمة ربما يكون أكثر دقّة وهي "متخلِّف"، يسكن الماضي، حتى لو زعمنا غير ذلك، فالمشكلة لا يمكن حلها بمجرد "الكلام" كما نفعل الآن.
مرة أخرى أجدني أمام "لحظة ضمير" تقتضي الاعتراف دون أدنى تحفُّظ، بأننا مدينون لإخوتنا اليهود المصريين باعتذار تاريخي عما لحق بهم، حتى اندثرت طائفة أصيلة، ترجع جذورها في مصر لعهد النبي موسى، وأسهم أبناؤها في صناعة نهضة مصر في الاقتصاد والفنون والأدب والقانون وكافة مظاهر الحياة، ولم يشفع لهم كل هذا، بل اختزلهم الفاشيون القوميون، والمهووسون دينيًّا في معتقدهم، واعتبروهم مجرد "طابور خامس" لإسرائيل، وكان بوسعنا أن نستوعبهم، ونهيئ مناخًا مواتيًا لبقائهم، لأن خصومتنا لم تكن ـ ولا ينبغي لها أن تكون ـ مع اليهودية كدين، لأن هذا منطق غير إنساني، لا تستسيغه الضمائر اليقّظة، ولا تُقّره حتى الشريعة الإسلامية الغرّاء، على حدّ علمي.
ونواصل في مقال لاحق، سرد بقية تفاصيل رحلة "أونكل إيلي" إلى مصر، التي لم تعد وطنه.
والله المستعان
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :