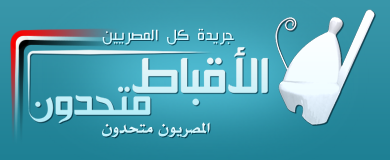العقل بين المادّي و الرّوحي
بقلم: سهيل أحمد بهجت
لا يمكن للواحدية بأي صيغة من صيغها أن تتحكم بالبشرية، و ما يبدو ماديًا في نظر بعض المجتمعات هو عين الروحانية في مجتمعات أخرى، مثلا نجد في اليهودية و المسيحية و عند المسلمين الشيعة، للموسيقى و الرسم و التمثيل دور أساسي في التعبير و الخطاب الدّيني، بينما يعتبر المسيري و السلفيون أنها من ضمن "اللهو" الحرام جدًا، و بالتالي فإن تعريفه لنقيض المادة و الذي أوجزه في "الديانة التوحيدية"!! و مشترطًا انفصالها عن الزمان و المكان، و الأبعاد التاريخية هو وضع لنتائج مسبقة، و نظرية المسيري هنا تذكرني بالانتخابات في ظل الأنظمة الدكتاتورية التي يعرف الشعب نتائجها مسبقا كونها محسومة، و"المسيري" قيد الدين بجرة قلم في عقيدة بعينها لا تقبل تفسيرًا أو تأويلاً غير ذاتها.
حينما بدأت الحضارة الحديثة في الغرب تصدّر إلينا الآلات و مناهج التعليم، و مخترعات الطب، و وسائل النقل، نظر إليها رجال الدين على أنها "أدوات شيطانية" تستهدفنا و أخلاقنا و قيمنا المتوارثة، و إلى الآن يطالبنا رجال الدين أن نتداوى بالقرآن و الأدعية أو تربة الحسين و ما إلى ذلك، كل هذا كان ممكنا أن نستفيد منه لو تم الاستفادة من مخترعات الطب الحديث مثلاً، و لتأتي هذه المآثر الدينية كجزء من العلاج النفسي، فكل دين من الأديان يمتلك وسائل للعلاج الإيماني لتعمل في نفس الإنسان حينما يعجز الطب عن الشفاء، لكن لماذا يصرّ المسلمون دومًا على أن العلم هو نوع من "تحدي الله"!! و إذا أخبرت مسلمًا من المسلمين ـ مع وجود استثناءات ـ عن اختراع علمي أو علاج لمرض عضال تم اكتشافه فهو يردّ غالبا بـ"الله أقدر منهم" أو "علم الإنسان ما لم يعلم" و انتهى، و كأن المصيبة في تخلفنا العقلي و الاجتماعي، لا تكفي لنضيف إليها تخلفًا من نوع آخر هو "التبرير" و العجز عن التغيير، و لماذا نعتبر المادة أكبر الشرور رغم أن لا أحد كالأنبياء اهتم بمسائل الزواج و الحياة رغم اختصاصهم بالروح، فهذه العقلية التبريرية متجسدة في المسيرية و توابعها الكارثية من قرضاوية و قبلها الغزالية (نسبة لأبي حامد الغزالي و محمد الغزالي السقا زعيم الإخوان المعروف)، كلها نظريات تؤكد على أن لا الواقع فقط بل العقل أيضا مادة "عدو = شر" يجب أن نتحاشاه، والواقع هو أن الحل سهل مع هؤلاء، إذ يكفي المسلمين أن يتغنوا بالماضي "الجميل"!! المليء بالعز و الفتوحات، بينما العالم أجمع يتنافس في الرقي الاجتماعي و العلمي و التطور، فإذا استشهدنا بأطروحات ماركس فهل يجوز أن نعمم فنقول "أن الغرب كله ماركسي"؟ أو أنه "هيجلي" أو "كانتي"؟
إن الاتحاد بين المقدس و الزماني حسب"هيجل"لا يمكن أن يكون لصالح المادي الزماني دون المقدس، فالروح مثلا لم يتم اكتشافها كأمر مادي ملموس ـ و لن يكون ذلك قطعًا ـ و بالتالي لا بد من احترامها كأمر مطلق و لكن لا يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الملموسة المادية، إن الروح و سائر المطلقات لا يمكن مقارنتها بالأشياء المادّية و لكن يمكن احترامها عبر احترام وجود الإنسان كملموس، فالإنسان يسعى إلى الخلود و يتمناه بلا شك، لكن لا يمكن أن تستحوذ هذه الرغبة (في بلوغ الخلود) على الإنسان ككل و تعطل حياته المحفوفة بالمخاطر و المشاكل و الكوارث.
مشكلة العالم الإسلامي التي نشهد تدهورها و انهيارها الآن، أنه يهتم ـ شكليًا و طقوسيًا ـ بالآخرة و الخلود و يضع ذلك كغاية و في تحقير صريح لهذه الحياة، لذلك نجد أن هذه المجتمعات تهيمن عليها ثقافة احتقار الدّنيا (و هي مشتقة من الدّونية و السفالة) و أن هذه الحياة ليست إلا "محطة" عابرة للوصول إلى عالم الخلود، و في الوقت نفسه يهيمن الأكليروس الديني و أرباب اللاهوت في هيمنة شبه مطلقة و سرية في آن واحد على كافة مجالات الحياة و الفكر و النشاط العقلي، بل إن الحياة نفسها هي نشاط محرم و مرفوض، فمن جهة تريد الأيديولوجيا الدّينية أن تفرض منطقها لا على المسلمين فقط بل العالم، و في الوقت نفسه يعتبرون أن متع و لذات الحياة هي من شأن "الكفار" الذين سيدخلون "جهنم" حتما لتمتعهم بالحياة.
إنها فعلاً أفكار عبثية منحطة فكريًا و عقليًا، و في الوقت نفسه هناك استثناءات في العالم الإسلامي و هناك إصلاحيون يحاولون بإخلاص فك هذه العلاقة المتناقضة بين المادة و القداسة ـ كما يراها"المسيري"ويعتبرها نقيضين ـ و محاولة تقديس المادة نفسها باعتبارها "هدية إلهية"، إن وضع المقدس كنقيض للمادي "المدنّـس"، هو أساس المشكلة التي يعانيها العالم الإسلامي الآن، فالنجاسة المادية لا معنى لها إلا بمقدار تأثيرها على الجانب المادي من الإنسان، و تبدل الحلال إلى حرام و العكس أيضا يدل على أن لا نجاسة مطلقة و لا طهارة مطلقة، بل الأمر يقتصر على انتفاع الإنسان و ضرره، و الشيطان نفسه ـ و هو سيد الأشرار ـ لم يستحق هذا اللقب و الطرد إلا لتمسكه بالعنصرية و الغرور الذاتي، من هنا ننطلق إلى صحة أطروحة"هيجل"القائلة بأن الخلاف العقائدي و خصوصًا بين المطلق المقدس و المحدود المدنس لا يعدو كونه خلافا لفظيًا، و قد أدرك المتصوفة و القدماء ـ و هم الذين يكرههم"المسيري"جدًا ـ هذه العلاقة الحقيقية في كون العالم يحوي حقيقة واحدة و لكنها ذات تجليات مختلفة، وسعي الإنسان إلى إيجاد منجز أرضي من التطور و القضاء على معاناة الإنسان على هذه الأرض و "استعمار" هذا الكوكب { هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} هود ـ 61 هو بحد ذاته شرط من شروط تحقق الذات الإنسانية في عالم الآخرة، و الفشل في هذا الاختبار، تحقيق منافع و مصالح الإنسان المقدس بذاته، يعني الفشل في الجانب الروحي و الديني المطلق.
يقول"المسيري":
"و بالتالي فما نواجهه الآن، هو صراع بين "مقدس" و آخر، أي بين قبول الرؤية المادية كمقدس، أو إعادة إفعال ـ ربما يقصد"المسيري"إعادة تفعيل ـ مقدساتنا، التي تنتمي إلى الضمير و الدين و الأخلاق، فالاختيار [المطروح أمامنا هو اختيار] بين تقديس المادة، و تقديس المعنى." ـ العلمانية تحت المجهر ص 89
إن هذه العبارات تصف لنا أمرًا يبدو و كأنه بالغ السهولة، و أن بالإمكان تحويل الناس إلى عالم مثالي بضغطة زر أو بالتعبير القديم "بقدرة قادر"، و الحقيقة هي أن مواقف الإنسان و حكمه على الأشياء يتوقف على مدى اطلاعه و نوعية البيئة التي يعيشها، و إذا تحولت قناعات الناس من دين إلى آخر أو في الاعتقاد بتفسير ديني ما ـ دون آخر ـ داخل الدين الواحد، هذا التحول لا يتم بالرغبة أو الإرادة، بل بمدى سعة الاطلاع و رؤية القيم من جانبها التطبيقي، فكل قيمة أخلاقية لها انعكاس على أرض الواقع، و بدون الواقع و قابلية هذه القيمة على التكيف و الاستمرار، فإن هذه القيم تنحسر و تضعف إلى أن تموت في النهاية، و لا يعود لها وجود إلا في باطن الكتب و التراث، و لا معنى هنا إذا لـ"اعادة إفعال" القيم الخلقية، و أظن أن"المسيري"قد خانه التعبير و كان ينبغي عليه القول "إعادة تفعيل"، فهذه القيم كانت مفيدة حينما كان العالم واسعا و مترامي الأطراف و كانت رحلة بسيطة بين مدينة و أخرى تستغرق أشهرًا، أما في عصر السرعة و التخاطب عبر القارات و عولمة المعلومة و الفكرة و الوصول بسرعة إلى أبعد بقاع الأرض، هذه التحولات العضوية في المجتمعات و ظهور الديمقراطيات الشاملة ـ التي يشارك فيها كل المواطنين البالغين ـ يحتم على هذه المجتمعات تطوير فكرها الديني بحث يستفيد منها الناس بشكل طبيعي و سلس، و لكن"المسيري"حينما استخدم تعبير "إعادة إفعال" المقدس انطلق من تردده في استخدام تعبير "إعادة تفعيل" الذي يوحي بإعادة "تصنيع" أو "تعمير" آلة تالفة أو عفى عليها الزمن أصلاً، بمعنى أنها تعطلت ذاتيا لأن الزمن قد تجاوزها، لكنه اختار كلمة "إفعال" و كأنه يشير إلى أن "مقدساتنا" ليست معطلة و أنها صالحة و مفيدة و لكن تم "تعطيلها"، و نحن لا ندري ماهية "مقدساتنا" هذه، رغم أنه قد حصرها مسبقًا في عقيدة معينة و لكن مرة أخرى لم يخبرنا أين تنتهي حدود المقدس في جريانها الزمني العمودي، فإعادة تفعيل المقدس محكوم عليها بالفشل مسبقًا لأن المقدس لا معنى له إذا تم فرضه بالقوة الغاشمة و القهر و بدون حرية اختيار، و انتماء المقدس إلى الضمير و الدين و الأخلاق هو انتماء غير واضح المعالم، و هو أشبه بالدائرة المفرغة التي لا معنى لها، فهل هذا الانتماء فعلي؟ أم أن العكس، أي انتماء الضمير و الدين و الأخلاق إلى فكرة المقدس، هو الصحيح؟ الأكيد هو أن كلها ذات ارتباط، و لكنه تعدد الأديان و المقدسات و حتى وقوف الدين نفسه مواقف متعددة أمام القضية الواحدة يحيلنا إلى أن نشك و نطرح السؤال الكبير: ما هي حقيقة هذه المصطلحات و ما هي "مرجعيتها" التي تستند إليها؟
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :