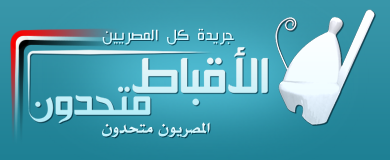كـلام عن العدالــة والمسـاواة
بقلم: د. محمد كمال مصطفى
الوعي الكلامي أو الخطابي هو إدراك المشكلة وأهميتها دون أن تحدث أفعال حقيقية وصادقة في اتجاه الحل، إدراكًا لأهمية وخطورة ترك المشكلة دون حل.. والوعي المهاري هو إدراك المشكلة وأهميتها، ومعرفة درجة خطورتها وتأثيرها، والعمل الجاد والصادق على البحث عن المهارات الصحيحة والمناسبة، واكتسابها وصولًا إلى الحل.
من هنا كان التساؤل عن مضمون وجوهر معظم الحوارات الدائرة بين مختلف الأفراد، في مختلف فئات ومستويات المجتمع عن العدالة والمساواة والمواطنة وعدم التمييز، وهو ما يعنى الوعي والإدراك الصحيح لأهمية مشكلة افتقاد وخلل وقصور العدالة والمساواة، فكل الثورات عبر تاريخ البشرية ما هي إلا تراكمات كمية لافتقاد العدالة والمساواة واتساع لهوة التمييز بين فئات المجتمع، أدت إلى تحولات نوعية تمثلت في انفجار أو ثورة الأغلبية التي تشعر بافتقاد العدالة والمساواة، واتساع هوة التمييز بين أبناء الوطن الواحد دون أسباب ومبررات يقبلها العقل والمنطق.
ولهذا يمكن القول عن اعتقاد صحيح أن ثورة 25 يناير كانت في جوهرها تحول نوعي ضد تراكمات افتقاد العدالة والمساواة، واتساع فجوة التمييز بين أفراد الوطن الواحد. لذلك كان الوعي بهذه المشكلة قبل الثورة هو أحد أسباب قيامها، والوعي بها بعد الثورة هو أهم المطالب بتحقيقها.
ولكن إذا كان الوعى قبل الثورة بافتقاد العدالة والمساواة واتساع هوة التمييز، قد تحول من وعي كلامي وخطابي إلى وعي مهاري، قد أدى إلى حدوث الثورة بأساليب غير تقليدية اتسمت بالإبداع، الذي استطاع أن يواجه وينتصر على نظام كان شعاره لا واردة ولا شاردة ولا حركة ولا تحرك دون رصد دقيق ومواجهة حاسمة.
فإن المشكلة بعد الثورة أن الوعي بأهمية وضرورة تطبيق العدل والمساواة وسد فجوة التمييز التي قامت الثورة من أجل تحقيقها، تقف عند حدود الوعي الكلامي والخطابي دون الانتقال إلى مرحلة الوعي المهاري، بل وحتى دون التحديد الدقيق لكيفية إقامة النظم التي تؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة، بل وما هو أكثر خطورة أن تشتد حركة التيارات الدينية التي يحمل محتوى أفكارها ومناهجها وبرامجها أشكال مختلفة للتمييز والتمايز، حتى ولو كان كلامها وحوارها يحاول تأكيد غير ذلك، على الأقل لسبب واحد وبسيط هو أن أصدق وأقوى المؤشرات والدلائل على المساواة في أي مجتمع هو المواطنة، والمواطنة تعنى ببساطة أن لكل مواطن الحق الكامل في أن يقرر بالتساوي مع جميع المواطنين الآخرين، وضع وتشكيل القواعد المنظمة لمجتمعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون على قدم المساواة مع غيره عند المساهمة في عمليات اتخاذ القرارات السياسية في مجتمعه، وأن يكون له الحق الكامل في الحصول على كل الضمانات التي تكفل له المساواة الكاملة مع غيره من كافة أفراد المجتمع، استنادًا إلى مبدأ وحيد هو الاحتكام المطلق لمعيار الكفاءة، وبتطبيق أوحد هو تطبيق نموذج واضح لتكافؤ الفرص، وفقًا لنظام محدد للجدارة "التكامل المهاري".
وهنا وفقًا لهذا المفهوم تثار التساؤلات التالية :
هل تقبل التيارات الدينية بمختلف تنوعاتها ودرجة تشددها، وحتى مدى وسطيتها بهذا المفهوم الذي يعني بالمساواة المطلقة، استنادًا إلى نموذج الجدارة ومبدأ تكافؤ الفرص ؟
وهل تقبل هذه التيارات بأن يخرج الدين من معادلات السياسة وتوازنات القوة، وتحديد أسس وقواعد الاحتكام المطلق لمعيار الكفاءة وتحديد نموذج الجدارة ؟
وهل تقبل التيارات الدينية التنازل عن اعتقادهم الجازم بأنهم أصحاب الحق الوحيدون بأن يكونوا هم القادة والموجهون والمرشدون للآخرين، وأنهم الأعلى لأنهم يتمسكون بشرع الله، وأن شرع الله هو الأحق بأن يطبق على كل الناس فى كل الدنيا؟
وهل تقبل التيارات الدينية بالتطبيق الصحيح للمساواة والعدل، والذي يقضي بأنه لا عدل ولا مساواة دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية دون مشاركة، ولا مشاركة دون حوار، ولا جدوى من الحوار مع طرف يضع ثوابت مسبقة غير قابلة للنقاش قبل الحوار؟
وهل تقبل التيارات الدينية مبدأ أن المواطنة هى جوهر المصلحة العامة، وأن المصلحة العامة هي القانون الذي ينبغي أن يسود الجميع أيًا كانت مبادئهم وديانتهم وأفكارهم، وأن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يشارك الجميع على قدم المساواة.
هل تقبل التيارات الدينية بقواعد ومبادىء الحداثة، التي تقوم على المواطنة والديمقراطية والعدل والمساواة والحرية الفردية المسئولة؟
كل هذا وعي كلامي وخطابي حول أهمية العدل والمساواة، وحول مشكلة افتقادهم، وعن ضرورة تطبيقهم.. أما كيف يتحول هذا الوعي الكلامي والخطابي الذي لا يملأ الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع فقط بل ولا يخلو حديث الناس، على اختلاف مستوياتهم منه، إلى وعي مهاري وإلى نظم فاعلة تحققه على أرض الواقع؟ هذه هي المشكلة وبداية الحل لهذه المشكلة هي الإحساس بها... والإحساس بها قائم.. لتأتي الخطوة التالية وهي التحديد الدقيق لما هو مطلوب لحل هذه المشكلة، ليكون التطبيق استنادًا إلى هذا التحديد... والأهم أن يكون هناك اتفاق عام على ما سيتم تحديده وصولًا إلى دولة ومجتمع العدالة والمساواة وعدم التمييز، وأن يستند هذا التحديد إلى عدة افتراضات أساسية هي :
أن كل أفراد المجتمع أصحاب مصلحة حقيقية فى تحقيق العدالة، وأن جوهر العدالة هو صيانة كرامة وحماية حقوق كافة الأفراد على قدم المساواة، عن طريق القانون التى تطبقه الدولة وحدها ودون غيرها.
إن كل الأفراد على استعداد للانتماء إلى مجتمعهم عن طريق أداء فاعل وجاد ومخلص.. إذا ما شعروا بالمواطنة الحقيقية، وأن جوهر المواطنة الحقيقية هو التطبيق الفعلى للمساواة وعدم التمييز بينهم، في الواقع الفعلي، وأن القانون هو المرجعية الأساسية والوحيدة للجميع.
إن الخرق المتزايد لمعايير العدالة الاجتماعية، والذى غالبًا ما يتمثل في إحساس المواطنين أن القانون لا يطبق وأن العدالة لا تأخذ مجراها، هو الذي يؤدي إلى فقدان الحيوية والفعالية، ليس فقط في المجتمع المدني بل في المجتمع ككل، حيث ينحسر الانتماء وتسود اللامبالاة وتشيع السلبية.
هذه بعض المحددات التي يجب أن نعيد صياغة الحاضر والمستقبل بعد 25 يناير عليها، استنادًا إلى حقيقة واحدة لابد وأن يؤمن بها الجميع وهي؛ "أن المجتمع الذي لا يستطيع التوصل إلى تسوية مصالحة على أساس تقاسم رؤية مشتركة، قائمة على العدالة والمساواة والمواطنة، واحترام وتطبيق القانون سيضع نفسه ومصيره مع الوقت فى مهب الريح.
أم لك رأي آخــر؟!...
* استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :