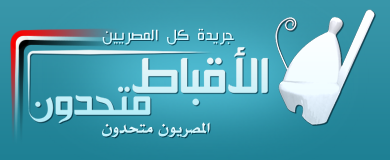نفي التطابق بين ثنائية الإسلام "دين ودولة"
بقلم: أحمد صبح
يبدو الربيع العربي وكأنه أحيا التيار الديني في السياسة العربية، وخصوصًا في النموذج المصري، حيث حقَّقت جماعة "الإخوان المسلمون" مكاسب عديدة صارت معها في قلب العملية السياسية، يطلب الجميع ودها بحسبانها القوة الأكثر تنظيمًا في الشارع السياسي، والمرشَّح الأكثر تأهيلًا للفوز في الانتخابات القادمة. وقد أنشأت الجماعة حزبًا رئيسيًا يُتوقع أن ينشأ بجواره أحزاب أخرى؛ نتيجة الانقسامات التي بدأت تدب بين أجيال الجماعة المختلفة. كما أن التيار السلفي الذي طالما وقف على مسافة بعيدة من مفهوم السياسة نفسه، رافضًا التعاطي معه من حيث المبدأ، متواطئًا في التحالف مع النظام السابق لحقبة طويلة من الزمن، قد بدأ تجاوزه عن مبادئه الأولى هو الآخر، ودخل إلى الحلبة من باب حزبين أساسيين حتى الآن، مع احتمالات نشوء أحزاب أخرى، بل حتى الجماعة الإسلامية الأكثر جهادية ورفضًا للسياسة وتكفيرًا لنظام الحكم ونهجًا للعنف، تبدو هي الأخرى على وشك الدخول في الحلبة بعد أن أسَّست حزبًا جديدًا بالفعل، مع احتمالات نشوء أحزاب أخرى تنتمي إليه كنتيجة لحدوث بعض الانشقاقات!!.
ولعل التحدي الكبير الذي يفرضه هذا التيار بأطيافه المختلفة، يتعلق بمدى احترامه مدنية الدولة وطابعها الديمقراطي الأصيل القائم على مبدأ المواطنة وإرادة الأمة وليس على العقيدة الدينية والحاكمية الإلهية، فبينما تبدو جماعة الإخوان هي الأقرب لطرح الدولة المدنية، وإن كان ثمة رتوش على تصورها له تجعلها تطالب بمرجعية إسلامية لهذه الدولة المدنية يتباين الاجتهاد حولها، فإن السلفيين والجهاديين يبدوان أكثر بعدًا عن طرح الدولة المدنية! وأكثر حرصًا وصراحة في المطالبة بـ"دولة إسلامية" تقوم ولو بعد وقت يتم فيه إعادة تربية الشعب على تطبيق الحدود الأساسية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، وفي المقابل تتكاتف جهود القوى التقدمية "الليبرالية" واليسارية القومية في الدعوة إلى مدنية الدولة، وفي السعي إلى التوافق حول مباديء حاكمة للدستور تؤكد على مدنيتها، وتحمي مبدأ المواطنة فيها، وتمنع أي انقلاب محتمل على مبدأ تداول السلطة في المستقبل، ولا يتنكر هذا التيار لمبدأ أو حقيقة "شمولية الإسلام" لكل مناحي الحياة، والتي نتفق عليها جميعًا كمسلمين، غير أن ثمة خلافًا عميقًا حول فهم شمولية الإسلام بين التيارين الديني والليبرالي:
- الأول منها يذهب إلى التأكيد على بعدها السياسي، وإلى القول بحاكمية الشريعة وصولًا إلى الإدعاء بأن الدولة أصل من أصولها تفرضه شمولية الدين، وهو الفهم الذي يفتح الباب واسعًا على الدولة الدينية، ويستعيد مقولات الحق الإلهي المقدَّس في حكم الشعوب.
- والثاني يذهب إلى معنى آخر لشمولية الإسلام يجمع بين تكامله وإيجابيته، فتكامله بمعنى قدرته على إنشاء صورة للحياة لا تنغرس أبدًا في الأرض مُترعة بالدنيوية، ولا تنزع دومًا إلى السماء هائمة في المثالية، بل تنهض بمهمة التوفيق بينهما، وإيجابيته بمعنى واقعيته في فهم الوجود البشري، ونزوعه إلى التأثير في حركة التاريخ، بدلًا من الانسحاب منه أو الشعور بالعجز في مواجهته، على منوال الأديان المجردة، فمن هذا التكامل وتلك الإيجابية يصير الإسلام بحق دينًا شاملًا، حيث الشمول هنا ضرورة وجودية وليس غاية سياسية. ومن ثم يمكن الإدعاء بأن شمولية الإسلام تعني المرجعية للمنظومة القيمية الإلهية لوجودنا البشري كله، ولكنها لا تفرض شكلًا معينًا للسلطة السياسية، إذ لا يفترض وجود مجتمع مسلم قيام سلطة سياسية مائزة، ذات سمات قدسية متعالية على التاريخ، كما يدَّعي التيار السلفي، وهو ما نعارضه هنا بدليلين:
1- نظري: إذ يبقى الإنسان متدينًا ولو عاش منفردًا؛ لأن الإيمان اعتقاد فردي، وطالما خلا الدين من الكهنوت يصبح قادرًا على البقاء دون سلطة وتلك فضيلة إسلامية، ولو أننا تصوَّرنا مجتمعًا مثاليًا يحكم الناس فيه ضمائرهم فقط، لن نكون بحاجة إلى سلطة، فالسلطة مطلوبة لتنظيم حركة المجتمع، وفرض القانون حتى لا تثور الفوضى، وليست مطلوبة للرقابة على ضمير المؤمن أو فرض الإيمان على المنكرين، وقد عاشت أقليات دينية كثيرة محافظة على إيمانها تحت سيطرة سلطات مغايرة لها في العقيدة، بل أكثر من ذلك نجد أن أصحاب العقيدة غالبًا ما يصبحون أكثر تمسكًا بها إذا تعرضوا للاضطهاد، والمسلمون أنفسهم في المرحلة المكية قبل تكوين مجتمع "دولة مدنية" لا يخرجون عن هذه القاعدة.
2- تاريخي: يتمثل في عدد التطبيقات التي جسدت معنى الدولة في التجربة الإسلامية الباكرة، والتي لا يمكن اعتبار إحداها هو الصحيح وتخطئة ما سواها، فقد جسَّدت دولة المدينة المنورة سياقًا تاريخيًا جمع بين النبوة والحكم، فقد كان على رأسها رسول يستلهم الوحي من الله يوجِّهه ويعاتبه وكان يوجب على المؤمنين طاعته، وهذا بالطبع لا يتأتى لأي دولة أخرى، حيث انتهت هذه الدولة الفريدة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن حاكمًا بقدر ماكان مبلغًا وقاضيًا مرشدًا، وبعد وفاته لم تكن هناك تقاليد لنظم الحكم واختيار من يأتي بعده، فتولى الخلفاء الراشدون قيادة الدولة في ظل ملابسات متغايرة، كل واحد له ظرف يختلف عن سابقه، فقد جاء "أبو بكر" بالبيعة في السقيفة، وجاء "عمر" بالاستخلاف، وجاء "عثمان" بالشورى، وكذلك "علي"، إلى أن تحوَّلت إلى مُلك عضوض على يد "معاوية"، ومع "يزيد" أصبح التحول كاملًا وعاصفًا نحو المُلك الوراثي.
لقد فقد المسلمون المثل الأعلى للحكم الإسلامي الذي تجسَّد في عهد "أبو بكر" و"عمر"، الأمر الذي التبس على البعض فيما يعتبرونه الدولة الإسلامية، فقد تدهورت قدرة الحكام في إيجاد المثل الأعلى في الحكم الذي ظل قائمًا عبر العصور في انتظار من يجسده، فالمهم في الإسلام ليس شكل الدولة فهو أمر تاريخي، بل المثل الأعلى المتجاوز للتاريخ، والقادر دومًا على إلهامه.
إذن، فالفارق الجوهري بين السلطة كنتاج تاريخي للاجتماع البشري لدى الليبراليين، وبين الدولة الإسلامية كنموذج لدى التيار السلفي، يكمن في مصدر الشرعية، هل هو الأمة (الناس– الشعب) كوجود إنساني ناضج بما يكفي لأن يقرِّر مصيره في التاريخ؟ أم أنه الشريعة نفسها؟ إذا صارت الأمة مصدرًا شرعيًا للاجتماع الإسلامي كأى اجتماع إنساني، وظلت الشريعة كأصل قيمي مرجعي تنحل الإشكالية؛ إذ يستطيع المسلمون إقامة دولتهم بمرحلتها التاريخية شرط أن تقوم الدولة على مقاصد الشريعة العامة، وهنا يبقى الإسلام محققًا شموله الديني والدنيوي دون دولة دينية، أما القول بأن الشريعة هي مصدر الشرعية فهو يفتح الباب تلقائيًا على بعد خطوة أو خطوتين على الدولة الدينية؛ لأن الشريعة لا تُمارس إلا من خلال بشر، وهنا ينمو الكهنوت السياسي عبر تأويلات اختزالية، الأمر الذي يهدر مصالح الدولة على مذابح الشريعة، وإذا تم إهدار المصالح تم إهدار الإسلام؛ لأن الإسلام ليس إلا المسلمين في النهاية.
لذلك، لابد من نفي الثنائية التطابقية بين الإسلام "دين ودولة"؛ فواو العطف لا تقيم اتحادًا بين طرفيها، إنما تفصل معطوفيها بما يؤكد تمايزهما، فالإسلام تدين يتميز بقدسيته عن الدولة التي نحن أدرى بشؤونها كما قال النبي الأكرم، لذلك بقى الفارق هنا لصالح الأمة التي تؤثر في التاريخ، وبما لا يسييء إلى الشريعة فيما لو أساء الناس اختيار حكامهم، حيث يبقى الإسلام مقدسًا بريئًا من غفلتنا، ومشيئة الله متسامية على فسادنا، فلا تستحيل شرعية المقدس غطاءً لخطايا التاريخ.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :