
في ذكرى رحيل إسرائيل عن سيناء
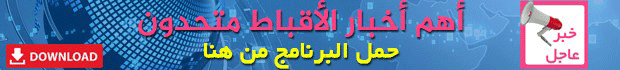

احتجاجات حاشدة دعا إليها معارضون لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير، سرعان ما تحولت إلى دعوات لإسقاط النظام في ذكرى تحرير سيناء.
ولم تنبع حالة الاستنفار، التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه، وما تلاها من نزول القوات المسلحة لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية وتحذيرات وزارة الداخلية للمتظاهرين، من رغبة في إسكات الرافضين لقرار أصدره وأحيل برمته إلى مجلس النواب وفقا لصلاحيات منحها له الدستور بإقرار الاتفاقية الموقعة أو اعتبارها لاغية، بل في مواجهة دعوات لاستغلال ذكرى استعادة سيناء ورحيل آخر جندي إسرائيلي في 25 إبريل/نيسان 1982، قياسا على دعوات التظاهر التي سبقت الاحتفالات بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير لتصبح شرارة اندلاع الثورة الأولى.
فبالمقابل، حاولت بقايا "جماعة الإخوان"، المصنفة جماعة إرهابية في مصر، أنتنقض على مطالب مشروعة بعدم التفريط في الأرض المصرية، والتي جسدت مظهرا حضاريا للتظاهر السلمي في جمعة "الأرض - العرض"، لتتحرر من حظر الأمن المصري لتظاهراتهاومسيراتها، وتحولت هتافات الأرض والعرض في تمرير أجندتها السياسية إلى هتافات "الشعبيريد إسقاط النظام". وهو ما لا تقبله غالبية الشعب المصري، وفق رؤية محللين كثر؛ وهو الذي عانى على مدار خمسسنوات من الانتهازية السياسية وتردي أوضاعه المعيشية الاقتصادية والاجتماعية؛ فبات الأمر كمصادرة شعبية قوية لرأي فصيل سياسي ضيق أزيح عن حكم البلاد.
والمتابع لتطورات الوضع الداخلي في مصر قد تصرفه تعقيدات وتداخلات المشهد السياسي عما أفرزه حصاد ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013، وما صحبهما من موجات ثورية أعادت إحياء أجندات سياسية وتوجهات أيديولوجية لم تصمد أمام ثلاثين عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعاشت حالة من الانكماش التنظيمي والجمود الفكري على غرار الحركات اليسارية والاشتراكية والناصرية، وأخرى مثل "جماعة الإخوان"، التي وجدت في العمل السري ملاذا آمنا للتمدد والتمكين على مدار 80 عاما في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى في "الخلافة الإسلامية"، وثالثة كانت ظلا للنظام الحاكم ولا تزال تكتفي بالتواد في مساحات رمادية تحقق مصالح ضيقة لمؤسسيها، وكانت سببا في الفشل الذريع لتجربة المنابر السياسية التي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات في أغسطس/آب 1974، ثم قانون تنظيم الأحزاب الذي صدر في يونيو 1977، وسمح بالتعددية الحزبية التي حولتها ممارسات النظام السياسي إلى هيمنة "الحزب الوطني" – الأوحد -، الذي حُل بحكم قضائي بعد ثورة ٢٥ يناير، وتكررت التجربة نفسها مع "حزب الحرية والعدالة" "الإخواني" الذي حُل في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو .
ولا يخفى أن الاقتراب من الحالة المصرية يجعلنا أكثر قدرة على تحليل البعد الثالث لقضية تحكمها أعراف وقوانين دولية، ويحسمها ما يمتلكه طرفا القضية من وثائق تعزز حجة كل منهما، ولا تتوقف عند قرار من الرئيس بالتنازل عن أرض.
وبعيدا عن حالة التحشيد والاستعداء التي خلقها المناخ غير الصحي في الإعلام المصري بين الرافضين والمؤيدين، يجب أن يبقى الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفولا ما لم تحركه أيادٍ خفية أو أجندات خارجية سعيا للحصول على حق يراد به باطل، وهو الأمر نفسه الذي لا يعطي تفويضا للأمن في اتخاذ إجراءات من شأنها مضاعفة حالة الاحتقان لدى الشباب الغاضب.
وبعيدا عن تعقيدات العلاقات الدولية التي لا تضع مطالبة السعودية مصر بما تراه حقا لشعبها طرفا فيما يجري، ولا يضعها المحتجون موضع الغاصب أو المعتدي على الأرض.
لكننا لا نستطيع أن نقرأ هذا المشهد بمعزل عن آلة الشائعات" الإخوانية" التي ساهمت في تصدير صورة سيــئة عن موقف الملك سلمان بن عبد العزيز باعتباره حليفا لها ومعاديا للرئيس السيسي وثورته؛ تلك الشائعات التي أجهضتها زيارة الملك الأخيرة إلى القاهرة ، والتي جاءت مثل صدمة للجماعة المحظورة التي تعول على تضييق الخناق الاقتصادي والدولي على النظام الحاكم .
هذه الحالة المتشابكة لقوى سياسية طفت على السطح بفعل الحالة الثورية، وأخرى توارت ولا يزال من تبقى منها يحاول جمع شتاتها أملا في العودة إلى دائرة السلطة أو مربع الأضواء، ولا يجد حرجا في استخدام ما هو متاح من أساليب مشروعة أو غير مشروعة مستندا إلى قاعدة "الميكيافلية" في الوصول إلى غايته، ولو خلَّف ذلك عشرات القتلى أو أدى إلى اعتقال مئات الشباب أو هدد استقرار شعب بأكمله.