.jpg)
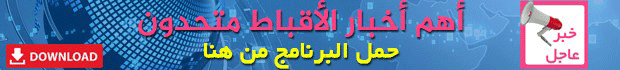
.jpg)
بقلم: د. جهاد عوده
هذه هى الورقة السابعه فى شأن تفصيل وتطوير معالم المرجعية المدنية للدولة المدنية الدستورية . هذه الورقة سبقتها ست اورق تأسيسية، وهم:
1- فى شأن مفهوم المرجعية المدنية ( عرضت فى المؤتمر التأسيسى للتحالف المدنى الديمقراطى 16 مارس 2011)
2- لورقة التأسيسية الثانية: المرجعيه المدنية وبنية النقد المدنى
3- الورقة التأسيسية الثالثه : المرجعية المدنية وبناء قيم الليبرالية العملية
4- الورقة التأسيسية الرابعة : نحو معالم المرجعية المدنية كمضاد للاستبدا- مع بداية العام الثانى للتحالف المدنى الديمقراطى مارس 2012 - حالة عياض بن عاشور
5- الورقه التأسيسية الخامسة: والازمة السياسية الليبرالية فى مصر بعد تسليم السلطه لحزب الحرية والعدالة
6- الورقة التأسيسة السادسة: مدخل لانشاء الدولة المدنية الديمقراطية مصرية: اسس جوهرية لتطوير القانون المدنى المصرى
![]()
![]()
لعبت الثورة المدنية التى انطلقت فى الخامس والعشرين من يناير 2011 بتحولاتها وتغيراتها دورا كبيرا تغير اشكالية المواطنه من اعتبارها ماده دستورية مقره وفقا لتعديلات 2007 تناضل القوى المدنية من اجل خلق قانون لها ، الى ماده تمثل ازمه عميقة وتهدد بشكل حقيقى تكامل الجماعة السياسية المصرية وتؤسس للنظام المدنى الديمقراطى المأمول. هذه الورقة التأسيسيه تسيهدف اعاده توجية الخطاب حول مسأله المواطنه ناحية خلق مجال ثقافى سياسى من المعرفة بتوليد عملية نضالية طويله تقف عقبه كود امام تغول وهيمنه القوى الفاشية الدنية التى صرنا نشاهدها يوميا فى الحياه العامه او امام الاستسلام لمنطق الطائفية الذى يغوص ببطء وكفاءه من اجل تغيير مفاهيم النظام العام المصرى وتحويل الاقباط وغيرهم من العقائد الايمانية الى الانحصار فى نطاق مفهوم الملة. بعبارة موجزه، اطلقت ثورة 25 يناير قوى عديده متصارعة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ادى تفاعلها فى الواقع السياسى المؤسسى الى تقدم القوى المرتبطه بالفاشيه الدينية والقومية وتراجع القوى المدنية الديمقراطية. وظهر ملامحها للاسف فى تسريبات اللجنه التأسيسية التستورية المناط بها صياغة دوستور جديد لمصر. انتقل خطاب المواطنه من اللمجال المطالبى والتفاعل السياسى من داخل النظام القديم الى مجال الازمه الاجتماعية الشامله وبالتالى النضال النظرى والعملى للموطنه كدخل ضرورى للحداثة والمدنية لمصر المستقبل.
اكسر زخم وتوالى مضاعفات الثورة المدنية مع الاستفتاء على تغدير بعض مواده دستور 1971 فى 30 مارس 2011. خسرت القوى المدنية والديمقراطية الصويت ، حيث راهنت على التصويت بلا، هذا لان التصويت بلا سيمنع القوى الدينية والقومية من الهيمنه على صياغة التفاعل السياسى بعد الثورة. فى هذا الاستفتاء تم وضع الاساس الاولى لمتوليات بزوغ نظام الهيمنه الدينه القومية. حتى ان احد شيوخ السلفية اطلق على انتصار القوى الدينية القومية فى الاستفتاء بغزوه الصناديق متبركا بغزوه منهاتن الى هاجمت فيها القاعده برجى التجاره العالمى بمنهاتن ودمرتهما.
ونقصد بالثورة المدنية ، ثلاث معان تكمل بعضها البعض ، اولا، ان من قام بها هو عموم المواطنين، وليس طبقة اجتماعية محددة او قوة سياسية معينة، هى ثورة استهدفت توسيع مشاركة المواطنين فى الحكم والثروة الوطنيين بدون تفرقة اجتماعية ، ثانيا، انها ثورة حاملة لقيم الطبقة الوسطى ، سواء الطبقة الوسطى التجارية او للاعمال او للدولة او المهنية اوالعمالية. فانحباس الصعود الاجتماعى للطبقات المحرومة او الدنيا اوالشبابية وخاصة فى المناطق الداخلية للدولة، بالاضافة الى الضيق المتزايد من تضيق الخناق على عناصر الطبقة العليا لصالح عائلات الحكم خلق عملية مجتمعية شاملة من السخط العام. بعبارة اخرى، ان السخط العام والمتكاثر من الافقار والنهب المنظم لصالح العائلات والافراد المتحالفة مع عائلة الرئيس فى السلطة ساهمت بشكل فعال فى بناء وعى راسمالى بضرورة الثورة للحفاظ على منجزات التراكم الراسمالى، فى قول مختلف، انها ثورة من اجل الحفاظ على منجزات النمو الاقتصادى والاجتماعى وعدم تسريبها الى العائلات فى الحكم من خلال الاغتصاب، ثالثا، انها ثورة دستورية علمانية ، تستهدف بشكل واضح ومحدد هيكل للعلاقات المدنية يتشكل فى نظام سياسى للحكم واداره شؤون الدوله والمجتمع ، بعبارة مختصرة ، الثورة الدستورية العلمانية تقيم وتؤسس مرجعية مدنية تشكل كل تجليات الدولة والمجتمع. ولكن الان كل هذا اكسر ودخل النظام السياسى المدنى وتجلياته فى عتمه النظام السياسى الدينى ومضاعفاته.
السؤال الان كيف مدخل ثورى مدنى اليبرالى قادر على كسر هذه الهجمه المضاده لمنطق المواطنه ؟. مقولتى التى احتج بها امام الجمهور العام هى ضروره الاستعانه بافكار كل من صبحى وحيده وانطونيو جرامشى لفتح ضريق النضال المدنى ضد العتمه الدينية التى تعيشها مصر الان. هذا البحث يعمل على خلق طريق الى منطق ثورى لليبرالية بشكل يكون منطق لصناعه القياده الثورية الليبرالية الضرورية كمدخل للنضال المدنى اليبرالى غير القانونى بشكل خاص.
1- المدخل الاول: تصور صبحى وحيده
لانجد لصبحى وحيده الا كتابه المعنون : "فى أصول المسألة المصرية" ، وبعض المقالات القليلة جدا عنه . يكفى أن نذكر أن المكتبة المركزية بجامعةالقاهرة تخلو من أى ورقة أو قصاصة تخصه ، كذلك بباقى مكتبات مصر المشهورة . هذا عين ما عبر عنه أنور عبد الملك فى مقالته بجريدة الاهرام بتاريخ 11\7\2000. فصبحى وحيدة كان يعمل سكرتير عام اتحاد الصناعات المصرية فى حكومة صدقى باشا ، وللاتحاد فى ذلك الوقت سلطانه ونفوذه باعتباره محورا من محاور الراسمالية الصناعية فى مصر . وقد كان من المتاثرين بالثقافة الايطالية ولعل هذا سهل له الكثير فى النفوذ الى القصر الملكى حيث كان الناطقون باللغة الايطالية يمتلكن زمام الامور فى القصر. تميز فكر وحيدة بانه لم يعتمد فى كتاباته اصول المسالة المصرية على الجانب الاقتصادى فحسب بل اهتم بالعنصر الروحى ايضا فقد دمج بين الجانبين فى تحليله التاريخى للكتاب ، وهى حالة نادرة فالماديون يهملون الجانب الروحى والمتدينون لا يفسرون التاريخ الا فى ضوء الجانب الروحى فقط. عند وحيده تم خلق جدلية جديده بين المادى والروحى تولد عملية علمانية نقديه يسمح بدمج كل المواطنين ناحية االحداثة .
يؤرخ صبحى وحيده لنشأته القومية الليبرالية وتطور ازمتها فيقول انه في أعقاب وفاة عبده عام 1905، أحرز الإصلاح الإسلامي كما تصوره الامام عبده تقدما قليلا في المجتمع أوبين الزعماء التقليديين. فرشيد رضا على سبيل المثال، لم يحرز إلا قدرا يسيرا من النجاح في صياغة أيديولوجية لعبده ووضعها في برنامج سياسي إسلامي قابل للتطبيق. ويعتقد هشام شرابي انها جاءت نتيجة عجز الحركة عن ترجمة الأيديولوجية إلى حركة سياسية. فبالمقارنة، نجد ان المسلمين الليبراليين أمثال مصطفى كامل (1871-1908) وسعد زغلول (توفي عام 1927) ووكانا من إتباع محمد عبده ، وكذلك العلمانيين العرب المسيحيين أمثال شبلي شمّيل(1860-1916) وفرح انطون (1871-1922) ويعقوب صروف (1852-1927) وسلامة موسى(1887-1958) استطاعوا أن يؤثروا تأثيرا كبيرا على الصحافة والأحزاب السياسية والمدارس والمحاكم الحديثة. وهكذا فقد حلوا محل الطبقة الدينية-العلماء الذين لم يستطيعوا أن يستجيبوا لتحدي الفكر المعاصر أويقدموا حلولا موثوقا بها لمشاكل العصر. بالإضافة إلى ذلك، وتحت القيادة القومية الليبرالية لمصطفى كامل، وتحت شعار الإخلاص للسلطان العثماني،فقد نجح القوميون في أعقاب أحداث العقبة والدنشواي عام 1906 في بناء حركة جماهيرية ضد كل من الاحتلال البريطاني والحكم الفردي والديكتاتوري للقنصل البريطاني العام ايفالين بارينغ Evalyn Baring (اللورد كرومر Lord Cromer) ومهما يكن من أمر، فان رد الفعل المصري ضد الاحتلال البريطاني في هذه الفترة كما يراه فاتيكيوس استاذ العلوم السياسية البريطانى (Vatikiotis) "لم يعد حركة إصلاحية داخلية وإنما ظهر كحركة تسعى للاستقلال عن حكم أجنبي".
عبر مصطفى كامل عن أفكار حركة الاستقلال هذه تعبيرا واسعا في صحيفة اللواء وفي برنامج الحزب الوطني. إلا انه ونتيجة لموت مصطفى كامل المبكر في فبراير (شباط) 1908، وعدم قدرة الحزب على ملء الفراغ الناتج بوفاة زعيمه ، فقد اعتبر الحزب بحلول عام 1914 قوة سياسية غير قادرة على الاستمرار، وأصبح أفولها حقيقة واضحة تماما بقيام الانتفاضة الوطنية في عام 1919 التي تزعمها قادة على رأسهم سعد زغلول كانوا إلى حد بعيد متماثلين مع حزب الأمة الليبرالي الذي تأسس عام 1907. ونبذ حزب الأمة الذي يتألف في معظمه من إتباع محمد عبده العلمانيين فكرتي الوحدة الإسلامية والوحدة العثمانية، وحث على إن الأولوية يجب أن تكون العمل الاصلاحى وفقا للمصالح السياسية المصرية، هنا تم الفصل النسبى بين الفكر والعمل فى الحركة الوطنية، ورؤيى ضرورة الحاجة الملحة للعمل على تحقيق الاهداف والغارات من خلال عمل سياسي منظم، ومن خلال المفاوضات مع بريطانيا. ويرى عبد العظيم رمضان، ان الفرق الجوهري بين الحزب الوطني لمطفى كامل وحزب الأمة المكون من كبار ملاك الارض هوفي الأسلوب الذي وضعه كل حزب لبناء مجتمع مصري حيوي. فقد أيد الحزب الوطني تحرر مصر من بريطانيا شرطا أساسيا لبناء الأمة، إذ بمجرد شفاء الأمة من علتها المتمثلة في الاحتلال البريطاني يمكن التغلب على العقبة الرئيسة في سبيل تقدمها. حزب الأمة من ناحية اخرى كان يؤمن بأن العلة ليست في الاحتلال،وإنما في المجتمع ذاته، إذ بمجرد تغلب المجتمع على علله الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية،فان أعراض هذه الحالة،أي الاحتلال الأجنبي ستتلاشى. وقد عبر احمد لطفي السيد احد أتباع عبده والزعيم الأيديولوجي لحزب الأمة عن أراء الحزب في صحيفة الجريدة، ومثلها مثل الجماعات الأخرى والمفكرين المصريين في ذلك الوقت، فقد كانت جماعة حزب الأمة مشغولة بإيجاد حلول للأوضاع المتدهورة في المجتمع الإسلامي. وقد بحث عن هذه الحلول في الحضارة الأوروبية ومعتقداتها الإنسانية والعلمية، وفي حلم قيام استقلال وطني تسود فيه الحرية الفردية وحكومة تمثيلية محدودة، وفصل بين الدين والدولة، وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. إن هذه الأفكار الليبرالية كانت تناصرها صفوة من أبناء مصر من المهنيين وملاكي الأراضي والذين كانوا يسيطرون على المجلس التشريعي عامي 1913-1914 بزعامة سعد زغلول الوزير السابق لوزارتي التربية والعدل (1906-1913) وكان على العموم متفقا في الآراء مع أتباع عبده من العلمانيين . ايتفق وحيدة والليبراليين فى العمل ضد الاستعمار لكنه لم يتفق معهم من حيث تحليلهم للواقع المصرى وسبل النهضة الحديثة له. فوحيدة يريد اعاده ربط الافكار بالسياسة والعمل الحزبى لابعد من كون مصر تخلصت من الاستعمار . فمشروع وحيده من ناحية ليبرالى ثورى الاعتراف بان هناك ازمه فى القياده الليبرالية الثورية وعتبر وحيده هذا مؤشرا لعدم ارتفاع الوعى الوطنى الليبرالى. فمثلا نجده يقول " ولم يكن قد ارتفع بوعيه لوطنى" فى حين قد يرى اخرون ان الوعى الوطنى هو تدنى وليس ارتفاع امثال رشيد رضا واتباعه من انصار المشروع الاسلامى .
وفى استعراض سريع من وحيدة لحالة مصر الاقتصادية ابان ظهور التيار الليبرالى وذلك لربطه بين المسألة الاقتصادية وعملية الاصلاح كحتمية لاى فكر يسعى لان يسود وكيف ربط الاستعمار الاقتصاد المصرى باقتصاده يقول وحيدة : " وتوجه بذلك اقتصاد البلاد نحو التوسع فى الاستثمار الزراعى والاعتماد على الاستيراد فيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة . وهذا النشاط الاقتصادى يتركز فى يد العناصر الأجنبية التى تموله وتشرف عليه وتنهض بشئونه جميعا فيما عدا الأعمال البسيطة التى لا يمكن جلب من يقوم بها من الخارج جلبا اقتصاديا . وغالب هذه العناصر من أنشط من نشأ فى الغرب من تجرا وصناع وفنيين زاولوا مهنهم فى أشد من ظروف مصر , أى هى العناصر التى كانت تنقص المجتمع المصرى بعد أربعة قرون من الحياة الزراعية المغلقة .
وهذه العناصر تحتفظ بعد هبوطها البلاد بدينها ولغتها وعاداتها فتقوم بذلك بينها وبين المجتمع المصرى طبقة عازلة تفصل بينهما . ويزيد من صفاقة هذه الطبقة استئثار هؤلاء الأغراب مع قلة عددهم بالثروة المنقولة وقنوع أهل البلاد بالثروة الزراعية , اذ يتأثر وضع كل من المجتمعين بطبيعة الاقتصاد الذى يزاوله , فيكون المجتمع الأجنبى مجتمعا مدنيا رخى الحال خفيف الحركة رائق الاشكال , يكون المجتمع الوطنى مجتمعا زراعيا محدود الربح بطئ الحركة متواضعا , ويبلغ هذا الاختلاف حد أن تتأثر به النظم العامة أيضا فتكون للأجانب قوانين ومحاكم وادراة خاصة تكتسب من شدة الظاهرة التى لفظتها واستنادها إلى النفوذ السياسى الأوروبى حيوية بارزة وتصير بذلك لسانا أوروبيا ممتدا فى صميم المجتمع المصرى وقد كان المجتمع المصرى يتكون فى سنة 1882 من 6.804.021 شخص لا يكادون يعرفون غير الزراعة , فصار 2.258.005 منهم يعملون فى سنة 1907 فى الزراعة و 356.425 يعملون فى المرافق العامة و 135.645 يعملون فى التجارة و 101.026 يعملون فى النقل . وكان غالبه يعمل أجيرا لدى الدولة أول حم اسماعيل , فتكونت له طبقة من أثرياء الملاك لا يقل عددها فى سنة 1913 عن 40 ألف شخص , وظهرت على سطحه طبقة من مزاولى الأعمال الحرة بلغت عدتها فى سنة 1913 135.733 شخص . وكان ينتشر فى الريف ولا تكاد تقوم له فيما عدا القاهرة والاسكندرية مدن حقيقية , فأخذ يتجمع عند عقد المواصلات ومراكز التصدير والاستيراد فى القاهرة والاسكنديرية والمدن الأخرى , وينشئ بها حياة حضرية تحمل ميسم طبيعته الزراعية هذه وأثر التيار الجديد الذى يعمل فيه . ففى هذه المدن يلتقى أبناء البلاد من ريفيين وحضر قريبى العهد بالريف من مستخدمى المنشآت التجارية الجديدة وموظفى الادارة الحكومية ومزاولى الأعمال الحرة بأولئك الأجانب الذين قدموا البلاد ليعموا فيها , وكانوا يعيشون إلى جانبهم ويعملون معهم فى ميدان الانتاج" .
وعن التأثر بالمجتمع الغربى بعد السيطرة الاقتصادية يقول : " ويتجه المصريون إلى الأخذ بأساليب الحياة الغربية عن رغبة فيما لهذه الحياة من رونق يروقهم ويبعدون فى ذلك قبل أن يكمل تحول حياتهم إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تبعث هذه الأساليب , فيسقطون فى الالتفرنج وهذا الاختلاف العنيف بين الحياة فى المنازل والحياة خارجها , ثم يلحظ الآن على الجيل الجديد من تكالب على الربح العاجل لمواجهة مقتضيات الحياة العصرية ومخلفات الحياة القديمة وبخاصة قلة الدخل الزراعى وكثرة نسل العائلة الزراعية وثقل التزاماتها . وهذا التفاعل بين المجتمع المصرى والمجتمع الغربى سريع بين غير المسلمين من أبناء البلاد الشرقيين النازلين عليهم , بطئ بين المسلمين , وهو بين الفريقين أنشط فى محيط المتعلمين والمشتغلين بالحياة الصناعية والتجارية منه بين من عداهم . والأمر فى الحالة الأولى أمر التجاوب الدينى , فالمصرى والشرقى المسيحى عموما لذلك العهد أقرب إلى الأجنبى المسيحى منه إلى المصرى أو الشرقى المسلم , وفى الحالة الثانية أمر الاستجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تصحب الحياة الصناعية الحديثة حيثما وجدت . وهو فى الحالتين مصدر هذه الحياة المهلهلة التى نجدها لعهدنا هذا خصوصا فى المدن الكبرى".
ويفصح وحيدة عن نية الاستعمار فى ذلك فيقول : " وهى تقصد بصفة عامة إلى تثبيت أهل البلاد فى وضعهم وقتئذ من المجتمع الغربى بتضييق آفاقهم وابعادهم عن مقومات الحياة الحديثة وتشويه ماضيهم التشويه الذى يلقى فى روعهم أنهم لم يكونوا قط غير ما كانوا أو خير مما كانوا . وهكذا كان القطن المصرى يزرع ويصدر إلى حد كبير بأموال انجليزية , وكانت معاهدنا الحديثة تقوم الواحد بعد الآخر بالرغم من معارضة الحكام , وكان تاريخنا القديم والقريب ومازال يدرس فى مدارسنا تدريسا بادى التشويه واضح الأغراض . وليس يعنينا هنا أن نستوضح هل كانت هذه السياسة تصدر عن ارادة مبيتة لابقاء مصر فى الوضع الذى كانت تشغله من النظام الاقتصادى ـ السياسى الانجليزى أو تنبعث عن خطأ فى تقدير الحكام أو ترجع للظروف المالية التى كانت عليها مصر فى القرن التاسع عشر)..........................( هذا الاقتصاد مازال يتركز فى أيد أجنبية تقوم بينها وبين المجتمع الوطنى حدود من الفوارق الجنسية والدينية والفكرية . وهو بحكم وضعه هذا يؤثر فى المجتمع الوطنى من حيث المشاركة فىتنمية ثروته واعداده عناصره الصناعية وتجديد حياته ولكنه لا يؤثر مباشرة فى الحكم ولا يشترك بالتالى فى وضع التشريع الخاص به لأنه لا يتمتع بالحقوق السياسية ولا يعقل أن يتمتع بها فى دولة حديثة تقوم على التفريق القومى".
ويعلق وحيدة بعد هذا العرض محللا وضع الليبراليين التقليديين ونظرتهم للاصلاح والتغيير ويبيين مدى قصور نظرتهم ومحدوديتها فيقول: " وكما قام الحزب الوطنى مستندا أول أمره إلى العرش نشأ حزب الأمة على صلة بوجود الانجليز . وقد ورث حزب الأمة من الحركة الوطنية التى سبقت الاحتلال مجافاتها الخديو ونزعتها الاصلاحية . وكان يتكون فعلا من أبناء الملاك الزراعيين الذين اشتركوا فى الحركة العرابية وبعض المفكرين المجددين ويتجه إلى معالجة مشاكل البلاد الاجتماعية بحكم صلة رجاله بمصالح البلاد المادية وهى مصالح كان تنظيمها لا يتعارض وقتئذ وسياسة الانجليز بينما كان نشاط الحزب الوطنى يتجه فى الغالب إلأى الدعاية الوطنية واستمالة الرأى العام الدولى بحكم صلته بسياسة الخديو وفرنسا وقرب عهد البلاد بالاحتلال . وقد حرم انقلاب السياسة الانجليزية , بعد عزل كرومر , من مناوأته السلطة الشرعية إلى مصافاتها ـ حرم الحزب الوطنى وحزب الأمة من الدعاية الخارجية التى كانا يعتمدان عليها وتركهما لقوامها الخاصة , فمال الحزب الوطنى إلى انتقال الخديو واتجه حزب الأمة إلى مهاجمة السلطة المحتلة واشترك الاثنان فى المطالبة بالحياة النيابية حتى خفت صوت الحزب الوطنى بعد وفاة الرجلين اللذين قام على أكتافهما وتحول حزب المة إلى حزب الوفد , عقب الحرب العالمية الأولى , وسلم قيادة لسعد زغلول . وسعد زغلول ينفرد دون عامة كبار ساسة مصر فى القرن العشرين بنشأته المصرية الفاقعة ومروره بجميع أطوار الحياة المصرية بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين . فهو قد نشأ فى البيئة الريفية الوطنية واختلف إلأى الأزهر أيام الأفغانى ومحمد عبده واشترك فى الحركة العرابية ثم درس الحقوق الفرنسية وصاهر مصطفى فهمى صديق الانجليز , أى جمع إلى التربية المصرية والثقافة الأزهرية المجددة شيئا من الثقافة الغربية ووفد من التيار الدستورى العرابى على بيئة المتصلين بالانجليز .
ومن ثم كان اختلاف معنى الوطنية عنده عنه عند مصطفى كامل وعند معاصريه فهى لم تكن لديه الحس المرهف والجرح الدامى والتفزز المتصل الذى كونته لدى مصطفى كامل بنيته العلية وقرب عهده بالعدوان الانجليزى واتصاله المباشر بالغرب . ولم يكن الشعور بما بين مصر والغرب من فروق تؤدى التربية الغربية , وما يصحبها فى العادة من ابتعاد عن القوى الشعبية , إلى التهويل من قدرها والرغبة فى تخطيها كما كانت لدى ثروت وعدلى ومحمد محمود . وانما كانت عزة نفس قوية ونفرة مهضوم وأباء ؤيفيا عريضا , كانت مجموعة صفات أخلاقية , ان صح تعبيرنا هذا , صقلتها الجبلة الريفية والتربية الاسلامية والثقة بالنفس , وهى ثقة عززتها بعد ذلك الانتصارات الشعبية الساحقة , فهو بلا شك أقوى من استطاع هز ضمير المصريين والشرقيين على وجه العموم فى الصدر الأول من القرن العشرين . ومن ثم كان أيضا قبوله الحكم والتعامل مع الانجليز المسيطرين عيله ومحاولته حل القضية المصرية بمراودتهم بعد أن تأصلت جذور الاحتلال وألف المصريون مظاهرة ويئسوا من معاونة تركيا وفرنسا لهم فى مناهضته مناهضة جدية . وبسعد زغلول اصبحت الحركة الوطنية حركة مستقلة تستمد قواها من ذات نفسها , وتقتعد مكان الصدارة من الحياة السياسية المصرية .
وقد انصرفت هذه الحركة أول الأمر إلى منازلة المحتلين وبخاصة فى المؤتمرات الدولية . ثم أعلن تصريح فبراير سنة 1922 وصدر الدستور , فجمعت إلى ذلك السعى إلى الحكم كحق من حقوقها الأصلية والوسيلة المباشرة لمعالجة علاقاتها الخارجية والعناية بمصالح البلاد عناية مصرية صميمة . وأبرمت المعاهد المصرية الانجليزية فى سنة 1936 فمالت إلى محاولة تعهد هذه المصالح . وكانت هذه الحركة تنمو أثناء ذلك وتتشعب فى جداول صغيرة تتخذ مكانا خاصا من المجرى العام وتقوم أحزابا يفترق بعضها عن العض ولكنها تشترك جميعا فى نسيجها وتفكيرها ووسائلها : فهى على كل حال لفيف من الملاك الزراعيين وخريجى المدارس الجديدة ولا سيما المحامين والأدباء وطلبة العلم . وهى على كل حال تعد القضية المصرية مسألة اقناع يحاوله أصحاب حق يريدون استعادته كما يحملوا غاصبى هذا الحق على رده فى سبيل المحافظة على مصالحهم الخاصة. وهى على كل حال تتخذ شكل الدعاية الصحفية والمساعى الشخصية , وتلجأ إلى هذه وتلك فى الحكم وخارج الحكم على السواء . ووضع المسألة هذا الوضع يهبط بها من مستوى النضال بين أمة تريد أن تستقل ودولة تريد أن تستعمر إلى مستوى التحايل على الفوز بالحكم بين بضعة أفراد يطمحون اليه وممثلى الدولة المحتلة التى تتصرف فى أمره . ...................يتبع